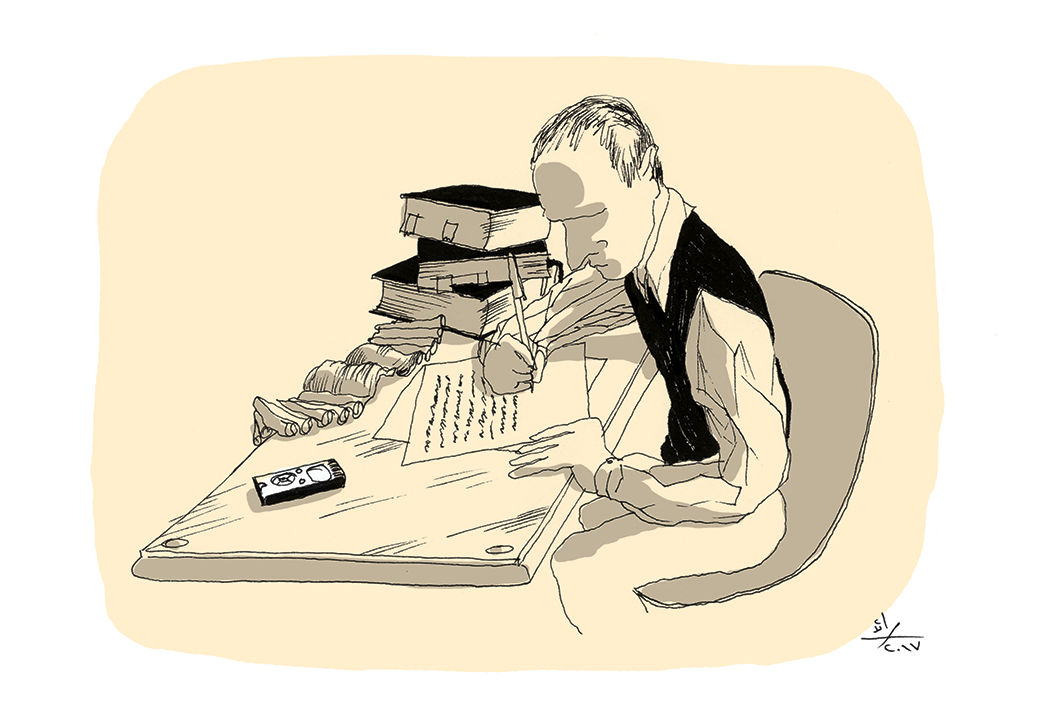اقتراح قانون الإعلام بحلّة جديدة: نحو إنهاء المقاربة العقابية وتعزيز حماية الصحافيين؟
08/08/2025
بعد مسارٍ طويل شمل 53 جلسة ضمن اللجان منذ حزيران 2010 و19 جلسة عقدتها لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عقيص في 2024-2025، باشرت لجنة الإدارة والعدل بدراسة اقتراح قانون الإعلام في تاريخ 29 تموز 2025.
وعليه، نسجل بعض الملاحظات انطلاقًا من الأهداف التي نراها مهمة لتحقيق التوازن بين حرية التعبير والنشر، باعتبارها حقا أساسيا وإحدى ركائز الديمقراطية من جهة، ووظيفة الإعلام الاجتماعية من جهة أخرى، والتي تتمثّل بفرض قيود مشروعة ومبررة ومتناسبة مع حجم الخطر، حتى لا يكون تقييد الحرية أوسع مما تفرضه الضرورات الاجتماعية.
ضمان التعدّدية الإعلامية
يسعى الاقتراح لضمان قدر أكبر من التعددية الإعلامية من خلال عدة مواد، أهمها: النص في أهدافه إلى منع الاحتكارات في تملّك وسائل الإعلام وتعزيز المنافسة الحرّة العادلة بما يتناسب مع حجم السوق وحاجاته، لا سيما في تأسيس وسائل الإعلام الخاضعة للترخيص. كذلك التأكيد على حرية الإعلام الإلكتروني، وعدم إخضاع إنشاء المنصات والمواقع الإلكترونية الاعلامية لأي موافقة أو ترخيص مسبق، وإدراج المواقع الإلكترونية ضمن أحكام قانون الإعلام، وإلغاء عدد المطبوعات الدورية السياسية، وإلغاء رقابة الأمن العام المسبقة على طباعة وإصدار ونشر المنشورات غير الدورية، وجواز إنشاء المؤسسات التي تعتمد البث والنشر عبر وسائط الإنترنت والأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات اللامحدودة وفق أصول العلم والخبر.
في المقابل، يُخشى على التعددية إذا كان القانون يسمح لكل شركة إعلام بامتلاك مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة إذاعية واحدة عن كل فئة من الفئات المحددة في هذا القانون، بخاصة أن عدد المؤسسات التي تعتمد على شبكة البث التلفزيوني والإذاعي الترددي الأرضي من قنوات وموجات تملكها الدولة اللبنانية محدود ولا يمكن تجاوزه حتى تاريخه. فضلا عن ذلك، يسمح القانون للأجانب تملك كامل المؤسسات الإعلامية غير السياسية، بينما يسمح لهم بامتلاك 20% من رأس المال في المؤسسات الإعلامية السياسية، دون تحديد عدد للمؤسسات الإعلامية التي يمكن أن يتملك فيها الأجانب. كما أنه لا يتضمن تحديدا قانونيا لمن يعتبر شخصا واحدا، وهو ما يترك مجالا للتلاعب.
استقلالية الرقابة على الإعلام وفعاليتها
يسعى الاقتراح لضمان استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام من خلال النص على انتخاب 7 من أصل 10 أعضاء من قبل جهات مختلفة، منها القضاء ومجالس نقابتي المحامين ونقابتي المهندسين... كما تسمّي هذه الجهات عددا من المرشحين ليعيّن مجلس الوزراء 3 منهم إلى عضوية الهيئة وفقا للأصول المحددة. كذلك يمنح الاقتراح الهيئة عددًا من الحصانات لا سيّما لجهة عدم جواز إنهاء عضوية إلا ضمن آلية وحالات محددة، وعدم جواز اتخاذ قرار بتعليق أو وقف عمل الهيئة في أيّ ظرف من الظروف من قبل السلطة التنفيذية. كذلك يخوّل الاقتراح الهيئة صلاحيات مهمة في الرقابة على الإعلام بمعرض ممارستها لمهامّها المحددة في القانون وبالتدرّج بالنسبة للمخالفات القانونية ومخالفات دفاتر الشروط ومخالفات قواعد السلوك المهني، ووجوب العمل على ضمان حرية التعبير والإعلام والنشر وفق المبادئ العامة التي ينص عليها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
في المقابل، لا يتضمن الاقتراح أيّة آلية لضمان منع التعطيل في تشكيل الهيئة أو ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية داخل تلك الهيئات. نسجّل أيضا إقصاء الصحافيين عن عضوية الهيئة والاكتفاء بانتخاب خبير إعلاميّ من قبل عميد ومدراء كليات الإعلام في الجامعة اللبنانية ونقيب الصحافة ونقيب محرّري الصحافة اللبنانية ونقيب العاملين في المرئي والمسموع ونقيب المصورين وسائر نقباء النقابات المرتبطة بالإعلام. فضلا عن الغموض في المعايير المعتمدة مثل تحديد الحد الأقصى لعمر الأعضاء بـ 69 سنة، والتمييز في آلية الانتخاب من هيئة إلى أخرى مثل انتخاب قاض متقاعد من قبل مجموع الجسم القضائي فيما حصر انتخاب المحامي ومهندس الاتصالات بمجالس النقابات وانتخاب الخبير الإعلامي بعدد من العمداء والنقباء فقط.
فضلا عن ذلك، قد يكون مناسبا التفكير بآليات تعزز فعالية عمل الهيئة. مثال على ذلك إحالة المخالفات الجسيمة المتعلّقة بالتحريض على الكراهية والتمييز، في حالات معينة مثل الحروب، إلى القضاء المستعجل لاتخاذ تدابير تحدّ من تفاقم الضرر لحين صدور قرار قضائي في الأساس. كذلك النصّ على جواز سحب الترخيص في حال عدم التزام المؤسسة الإعلامية بدفتر الشروط. كما نقترح التأكيد على موجب النشر للشكاوى التي ترد الهيئة والقرارات المتصلة بها والمراجعات التي تحصل على أساسها، وإخضاع النزاعات التي تنشأ بين الهيئة وموظّفيها والمتعاقدين معها إلى القضاء الإداري وليس العدلي.
حماية الصحافيين
يقدم الاقتراح موادّ هامّة فيما يخص حماية الصحافيين، لاسيما لجهة حماية المصادر الصحافية والحرية النقابية واستقلالية التحرير والحماية من الاعتداءات واحترام مبدأ الضمير المهني وحقّ الوصول إلى المعلومات. وهذا أمر بالغ الأهمية، بخاصّة أن العلاقة بين حرية الإعلام وضمان سلامة الصحافيين هي علاقة عضوية وثابتة، فلا مجال للحديث عن حرية الإعلام في ظل غياب الحد الأدنى من الحماية القانونية للعاملين في هذا القطاع.
في المقابل، لم ينصّ الاقتراح صراحة على حظر التحقيق في القضايا الجزائية أمام جهات أمنية أو قضائية غير مختصة. كذلك لم يتطرق إلى الباب الرابع من القانون الحالي الخاص باتحاد الصحافة اللبنانية رغم قصور هذا الباب عن مراعاة التعددية المهنية والإعلامية وتطور الإعلام الرقمي والمستقل. من المفيد أيضا حصر التفتيش أو غيره من الإجراءات القضائية المتخذة بشأن مصادر الصحافيين بالحد الأدنى والهدف الذي من أجله صدر قرار بالتفتيش.
إلغاء المقاربة الجزائية
يحيل الاقتراح الجزء الأكبر من جرائم المطبوعات إلى المحاكم المدنية، ويحصر المقاربة الجزائية بالأفعال الأكثر مساسا بالمصلحة العامة وهي جرائم التحريض على الكراهية والتمييز، مع ربطها بمعايير جدّية لتفادي التعسّف في استخدام المادة. يبقى أن يتم توضيح آلية الادّعاء في حالة التحريض، وما إذا كان يحقّ لأيّ شخص أو للنيابة العامة التحرّك تلقائيا أمام الهيئة أو مباشرةً أمام المحكمة دفاعًا عن المصلحة العامة، بخاصّة أنّ التحريض يطال فئات واسعة من المجتمع ويهدد السلم الاجتماعي. كذلك يلغي الجرائم الفضفاضة فيما يتصل بإثارة النعرات وتعريض البلاد للمخاطر.
فضلا عن ذلك، يلغي الاقتراح المواد المتصلة بالذم والقدح والتحقير من قانون العقوبات، ما ينعكس إيجابا على جميع قضايا التعبير وليس فقط تلك التي تخضع لأحكام هذا الاقتراح.
من اللافت في هذا الصدد إدخال جريمة جديدة على قانون الإعلام وهو جرم التزوير، رغم أن التزوير، بحدّ ذاته، لا يشكّل جريمة متصلة مباشرة بحرية النشر، ولا يمكن حصره ضمن إطار قانون الإعلام أو تعديل نصه في قانون العقوبات من خلال هذا القانون. فالتزوير يشكل جريمة قائمة بذاتها، لا ترتبط بالنشر إلا إذا استعمل المزور ضمن مضمون إعلامي منشور. أكثر من ذلك، تستعيد هذه المادة مفهوم الخبر الكاذب الذي تمّ تجاوزه أو حصره في حالات ضيقة في أنظمة قانونية عدة، نظرا لتداعياته على حرية التعبير، من دون أن يربط الضرر الناتج عن النشر بأي معيار متصل بالسلامة العامة أو الأمن القومي، بل يكتفي بالإشارة إلى أي ضرر، حتى لو كان ضررا خاصا وشخصيا، مما يوسع دائرة التجريم بشكل مبالغ فيه، خلافا لروحية هذا الاقتراح وأهدافه.
كذلك يلغي الاقتراح عددا من المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات، تحديدا المواد 318 و319 و320، التي رغم ارتباطها أحيانا بحرية النشر، لا تقتصر حصرا عليها، بل تشمل جرائم أخرى ذات طابع خطير يمس النظام العام والسلم العام. ومن المواد التي يستوجب إعادة النظر أو التريث في إلغائها هي الجنح التي تمس الدين. فعلى الرغم من تقديرنا للقرارات القضائية الآيلة إلى حماية حرية المعتقد والرأي، وعلى الرغم من توجه القانون الدولي نحو إلغاء تلك الجرائم، فإن الخشية تبقى من أن يؤدي الإلغاء الكامل إلى تصوّر أن المسّ بالدين أصبح مباحا، في زمن يعاني فيه المجتمع من هشاشة شديدة وحساسيات قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة.
التوسع في حدود النقد المباح
يلغي الاقتراح الامتيازات الخاصة بالرؤساء والموظفين العامين. كذلك يوسع من حدود النقد المباح، ليس فقط من خلال إزالة الصفة الجزائيّة عن الذم والقدح، وإنما أيضا من خلال تمكين المدعى عليه من إثبات صحة الخبر المتعلق بالشخصيات العامة وليس فقط الموظفين العامين، والاكتفاء بموجب تقديم بيّنة أو قرائن على صحة المعلومات المنسوبة، على أن تستكمل المحكمة هذه البينات والقرائن بما يثبتها إذا أمكن، عبر إلزام الإدارات او الجهات المختصة والمدعي بتقديم ما لديهم من معلومات أو مستندات.
كذلك يخفّف من عدد الأمور المحظور نشرها على ضوء التوسع في حرية النشر والنقد المباح، لاسيما الرسائل والاوراق والملفات او شيئا من الملفات العائدة لإحدى الإدارات العامة والموسومة بطابع عبارة "سري"، والتقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء المنافية للأخلاق والآداب العامة. كذلك يسعى لحماية القاصرين الذين أقدموا على الانتحار وضحايا جرائم الاغتصاب، إلا في حال الحصول على موافقة مسبقة من الضحية أو قاضي الأحداث.
في المقابل، يبقى تعريف حدود الوظيفة قابلًا لتأويلات عدّة، مثلا قيام موظف عام باختلاس أو تحريض خارج إطار وظيفته. وما هو مفهوم الأعمال التي يصح إثبات الخبر فيها بالنسبة إلى الشخصيات العامة التي لا تقوم بأي وظيفة عامة بمفهومها الضيق؟ لذلك من الأفضل أن يكون المعيار الأكثر ملاءمة لتحديد مسؤولية النشر هو مدى انتهاك الخبر المنشور بحق الفرد في الخصوصية ومدى أهمية الخبر في الشأن العام، أي الفصل بين المسائل الخاضعة للخصوصيّة، والتي لا يجوز المسّ بها، والمسائل غير الخاضعة لهذا الحقّ، التي تبقى قابلة للنشر والمساءلة، بمعزل عن وظيفة الشخص وصفته.
من اللافت أيضا حصر الاقتراح للحقّ في الخصوصية بالحقّ في حماية الصورة، وهو ما يعدّ اختزالا هائلا للموضوع طالما أن الحقّ في الخصوصية أوسع من ذلك ويستحقّ حماية شاملة تتعدى مجرد صورة الشخص.
هذا فضلا عن أن الاقتراح لا يزال يعاقب على نشر "وقائع جلسات مجلس الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي أو لجانه". كما يحظر نشر معلومات عن مداولات مجلس القضاء الأعلى باستثناء ما يسمح به رئيس المجلس، أي أن الاقتراح يمنح رئيس المجلس حق رفع السرية من دون نص قانوني واضح يجيز ذلك، وهو أمر يتضارب مع التوجه الآيل إلى تعزيز الشفافية في التنظيم القضائي منعاً لثقافة التدخل في أعمال القضاة.
كذلك، أدخل الاقتراح حق أي متضرر من النشر في طلب إزالة المادة الإعلامية المشكو منها، دون أن يلحظ أي تدرج في الإجراءات (رفض التصحيح مثلا قد يفتح الباب أمام طلب الإزالة) أو أسباب تسمح للمؤسسة الإعلامية برفض طلب الإزالة، على غرار ما هو معمول به في حالات رفض نشر الرد أو التصحيح.
تعديل أصول الاستدعاء والتحقيق والمحاكمة على نحو يراعي حرية التعبير
من تلك التدابير إنشاء غرفة مدنية ابتدائية في مراكز المحافظات والتقاضي على 3 درجات وتطبيق أصول المحاكمة الموجزة في كل مراحل المحاكمة وإلغاء صلاحية المحكمة العسكرية وتعزيز مبدأ عدم جواز التوقيف الاحتياطي في القضايا الخاضعة لهذا القانون.
في المقابل، يبقى معيار الحماية، لاسيما المتصل بعدم جواز التوقيف الاحتياطي، متوقفا على المنصة المستخدمة وما إذا كانت خاضعة لأحكام هذا القانون أم لا.
تطوير الإعلام العامّ
ينص الاقتراح على أهداف مهمة للإعلام العام والتي تميّزه فعليا عن الإعلام الخاص، أهمها ضمان حق الناس بالحصول على المعلومات الصحيحة والتصدي للتضليل الإعلامي وبخاصة أثناء الأزمات والإضاءة على قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة واحترام تعددية المعلومات والمساواة في الظهور..
إلا أن الاقتراح ينص على خصخصة "شركة الإعلام العامة" من خلال منح الدولة جواز التفرغ عن 49% من أسهمها، بموجب مراسيم في مجلس الوزراء، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين اللبنانيين، على ألا يجوز لأي شخص أن يتملك أكثر من 2% من رأسمال الشركة، وعلى أن يكون لكل 10% من الأسهم عضو إضافي في مجلس الإدارة. إلا أن هذه الآلية، بمعزل عن الملاحظات المتصلة بالخصخصة والقوانين الخاصة بها، قد تؤدي عمليا إلى تمركز تلك الأسهم بيد قلة من المتنفذين، مما يهدد التعددية أو ينذر بشلل عمله أو تعطيله. كما قد تؤدي عمليا إلى إلغاء الأهداف المقررة للإعلام العام في الاقتراح نفسه.
النزاهة الإعلامية والالتزام بالوظيفة الاجتماعية للإعلام:
يتضمن الاقتراح عددا من المواد التي قد تسهم في تعزيز النزاهة الإعلامية والتزام المؤسسات الإعلامية بالمسؤولية الاجتماعية المترتبة عليها. أبرز تلك البنود:
- تكليف الهيئة الوطنية للإعلام بصياغة مدونات السلوك وإقرارها وفق آلية تشارك بين الفئات المعنية ومنها المؤسسات الإعلامية والصحافيين والنقابات والجمعيات المعنية بحرية الإعلام: في هذا الصدد، نسجّل ملاحظتين: الأولى، التنبه إلى عدم تحويل مدوّنات السلوك لمجرد تكرار للقوانين الوضعية أو دفتر الشروط أو مراعاة الحساسيات، بل النظر إليها على أنها قواعد توازن بين حرية التعبير ووظيفة الإعلام الاجتماعية. لذلك يجب أن تتضمن تلك المدونات، ليس فقط الواجبات، إنما أيضا موادّ تشدّد على أهمية البحث عن الحقيقة، والدفاع عن استقلالية الإعلام، وإرساء مبدأ التضامن في مواجهة أي اعتداء على الصحافيين، بالإضافة إلى قواعد خاصة لفترات الأزمات والتدريب عليها. الملاحظة الثانية، التنبه إلى عدم تحويل آلية التشاور إلى نصوص من شأنها تجميد تلك الآلية و/أو فتح الباب واسعا أمام الطعن بها من قبل أي طرف يعتبر أنه لم يكن ممثلا فيها أو لم يستلم نسخة عنها أو لم يشارك في الاستبيان بشأنها. لذلك نقترح الإبقاء على مبدأ التشاور والنشر على الموقع الإلكتروني، مع فتح المجال أمام الأطراف المعنية للمشاركة في النقاشات، دون فرض التزام شامل قد يصعب تحقيقه أو يردي إلى شلل الآلية.
- منع وسائل الإعلام ومالكيها من الاستحصال على أية منفعة بطريقة غير مشروعة. رغم أن هذه المادة تسعى ظاهريا للحد من التدخل في الإعلام والحفاظ على نزاهته، إلا أنه يجب تحديد المنفعة غير المشروعة وآلية الرقابة والمساءلة والجهة المخولة بذلك تفاديا للتعسف في استخدام هذه المادة.
- تكريس موجب التمييز بين الإعلام والإعلان ضمن أهداف الاقتراح، وإلزام جميع وسائل الإعلام أن تفصل بشكل كامل وواضح بين المحتوى الإعلامي والمحتوى الإعلاني بما يضمن نزاهة الإعلام واستقلالية التحرير عن الإعلانات وحق الجمهور في المعرفة وعدم استغلال ثقة الجمهور بالمحتوى الإعلامي لتمرير رسائل تجارية أو سياسية مبطّنة.
احترام مبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة:
يُلاحظ أن الاقتراح لم يُحدّد معظم العقوبات، ما يترك السؤال معلّقا بشأن مدى احترامه لمبدأي الوضوح والتناسب بين الفعل والعقوبة. وعليه، نشير إلى ضرورة التنبه إلى أن أي عقوبة جزائية غير متناسبة مع حجم الضرر قد تترتب عليها تبعات جسيمة على حرية التعبير. من الجائز أيضا النظر في تدرّج العقوبات بحسب الظروف (يمكن تشديد العقوبة في حالات الحروب) أو بحسب طبيعة المؤسسة الإعلامية، كأن تشدد العقوبة على المؤسسات التي تستخدم موارد الدولة مثل التلفزيونات