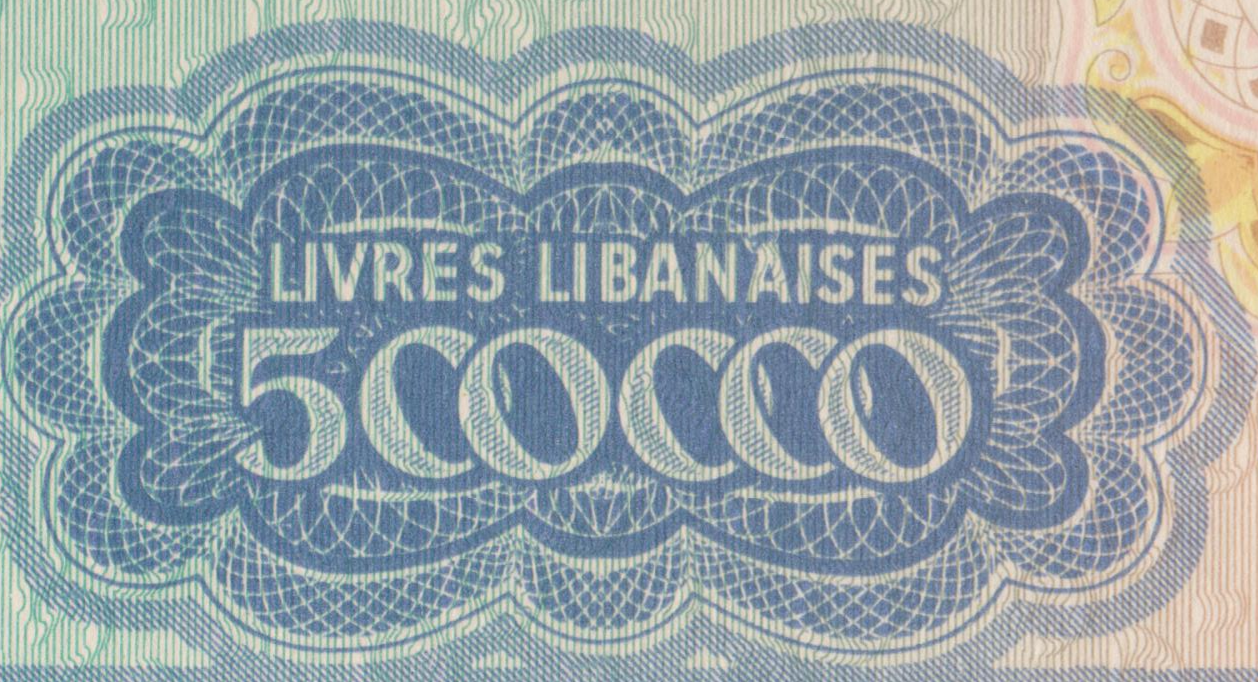اقتراح لتعديل الشروط الخاصة بالأهلية للنيابة: التمثيل السياسي لا يقتصر على النخبوية الثقافية
06/11/2025
تقدم النائب إيهاب مطر في تاريخ 30 تشرين الأول 2025 باقتراح قانون من أجل تعديل المادة السابعة من قانون الانتخابات بحيث تصبح حيازة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها من الشروط المؤهلة للترشيح إلى عضوية مجلس النواب.
وقد جاء في أسبابه الموجبة أنّ التشريع الذي يعتبر من أهم مهامّ مجلس النواب يحتاج إلى أشخاص لديهم مستوى تعليمي جيّد، وأن "التعليم الجامعي يوفر المعرفة المتخصصة في مجالات متعددة مثل القانون، والاقتصاد، والعلوم السياسية، وغيرها، مما يمكن النواب من فهم القضايا المعقدة واتخاذ القرارات السليمة". وتضيف الأسباب الموجبة أن "التعليم يعزز الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل مسؤول"، كما أن "النواب المتعلمين يمثلون ناخبيهم بشكل أفضل، حيث يمكنهم فهم احتياجاتهم وتطلعاتهم بشكل أفضل وتقديم حلول فعالة".
إن هذا الاقتراح يستوجب الملاحظات التالية:
اقتراح يعيد ما تخلى عنه القانون الحالي
من اللافت أن جميع قوانين الانتخابات في لبنان كانت تشترط لأهلية الترشيح أن يكون المرشح متعلما (منذ القانون الصادر في 24 نيسان 1957) أو "ملما بالقراءة والكتابة" وفقا للنص الذي كان معتمدا في قوانين الانتخابات القديمة. لكن قانون الانتخابات الحالي الصادر سنة 2017 تخلى عن هذا الشرط كليا إذ نص في المادة السابعة منه على التالي: "لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية".
وهكذا يتبين أن الاقتراح الحالي لا يكتفي بإعادة شرط التعلم لكنه يتبنى مقاربة أكثر تشددا لأنه يحدد نوع التعلم المطلوب ويقرنه بحيازة شهادة جامعية أو ما يعادلها وفقا للقوانين اللبنانية. فأن يكون المرشح متعلما هو شرط عام يمكن تفسيره بمعرفة القراءة والكتابة التي قد يحصل عليها الإنسان بمجهوده الشخصي خارج أيّ إطار مؤسساتي أو من خلال انخراطه في المدرسة. بينما حيازة الشهادة الجامعية تعني حكما أن التعليم الضروري لتمكين المواطن من الترشّح للانتخابات يجب أن يحصل ضمن مؤسسة جامعية تعترف بها الدولة أي أن هذا التعليم لم يعد يقتصر على معرفة القراءة والكتابة لكنه يحتاج إلى التخصص في أحد مجالات التعليم العالي.
ولا شكّ أنّ اشتراط الإجازة الجامعية هو أكثر وضوحا من اكتفاء النص بكون المرشح متعلما. وقد عالج مجلس شورى الدولة هذه الإشكالية في أكثر من قرار له بخصوص الانتخابات البلدية كون المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر سنة 1977 (قانون البلديات) تنص على أن من لا يعرف القراءة والكتابة لا يكون أهلا لعضوية المجالس البلدية. فقد اضطرّ المستشار المقرر في العديد من الحالات إلى إجراء اختبار للأعضاء الفائزين في الانتخابات البلدية والمطعون بعضويتهم من أجل التأكد من قدراتهم في هذا المجال وذلك مثلا عبر قراءة نص قانوني في عدة أسطر وكتابة نص آخر بطريقة الإملاء قد يكون مادة أو أكثر من قانون البلديات. ولم يتردد مجلس شورى الدولة في إبطال عضوية من ثبت لديه بعد الاختبار أنه لا يجيد القراءة والكتابة.
وهكذا يتبيّن أن تحديد أهلية المرشح تتوقف على نتيجة اختبار لا توجد معايير واضحة بشأنه إذ أن مجلس شورى الدولة اعتبر أن الصعوبة في القراءة والكتابة وارتكاب أخطاء إملائية عديدة لا تكفي من أجل إسقاط عضوية المرشح الفائز في الانتخابات البلدية ( قرار رقم 545 تاريخ 20/5/1998). كذلك اعتبر المجلس أن عدم تمكن الفرد من القراءة لعلة ما كضعف النظر "تساوي في الواقع عدم معرفتها" لأن المشرع اشترط المقدرة على القراءة "لحسن سير المرفق العام البلدي الذي يتطلب بفعل هذه المعرفة مشاركة فعالة في المجلس البلدي لرعاية شؤون البلدة" (قرار رقم 543 تاريخ 14/5/1998). من هنا يتبين، وبغض النظر عن تاريخ هذا القرار القديم الذي صدر قبل وضع قانون 220/2000 وإبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 6 شباط 2023، أن مفهوم الكتابة والقراءة قد يفتح الباب على تفسيرات متشعبة تضعف من الضمانات القانونية التي من شأنها حماية حقوق المرشحين.
لذلك يمكن القول أن حيازة الشهادة الجامعية تؤدي إلى تبني معيار أكثر موضوعية وتحرر السلطة المختصة من مشقة إجراء اختبارات غير واضحة المعالم كي تتمكن من تحديد أهلية المرشح. ولا بدّ من الإشارة أن التحقق من حيازة المرشح للانتخابات النيابية على الشروط المؤهلة للترشيح هي من اختصاص ليس فقط مجلس شورى الدولة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 46 من قانون الانتخابات لكن أيضا المجلس الدستوري الذي يعتبر أن النظر في توفر شروط الترشيح التي تؤهل النائب المنتخب للنيابة تدخل من ضمن صلاحياته كقاضي انتخاب علمًا أن تدخل مجلس شورى الدولة يحصل قبل إجراء الانتخابات خلال فتح باب الترشيح بينما لا يلعب المجلس الدستوري دوره إلا بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج.
وعليه، فإن إقرار الاقتراح الحالي يجعل من التحقق من أهلية المرشح عملية أقل استنسابية بالنسبة لوزارة الداخلية وكل من مجلسي الشورى والدستوري لكن ذلك لا ينفي احتمال حيازة المرشح على شهادة جامعية مزورة وهو ما يوجب في هذه الحالة على السلطات المختصة إجراء التحقيقات الضرورية للتثبت من حصول التزوير وهو ما يطرح إشكاليات جديدة لا يمكن التوسع في شرحها في هذا المقال.
اقتراح ناقص
يكتفي الاقتراح بتعديل المادة السابعة من القانون عبر إضافة الإجازة الجامعية للشروط المؤهلة للترشيح لكنه يغفل تعديل المادة 45 التي تحدد المستندات الضرورية المطلوب تقديمها إلى وزارة الداخلية للحصول على تصريح الترشيح. لذلك كان على الاقتراح أن يضيف إلى المستندات المطلوبة صورة عن الشهادة الجامعية مصدقة وفقا للأصول وذلك عبر تعديل المادة 45 وتحديد الشروط التي تسمح للمرشح من إثبات حيازته الشهادة الجامعية المطلوبة.
اقتراح لديه تداعيات على رئاسة الجمهورية
الظاهر أن الاقتراح لا ينتبه أن تبنيه له تداعيات مهمة على انتخابات رئاسة الجمهورية كون المادة 49 من الدستور تنص على منع انتخاب من لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة. فمن خلال اشتراطه حيازة شهادة جامعية أو ما يعادلها للترشح للنيابة، يؤدي تبني الاقتراح إلى تعديل أيضا الشروط المؤهلة لرئاسة الجمهورية بحيث يصبح مجلس النواب ملزما بانتخاب مرشح أتم تعليمه الجامعي وهذا ما قد تكون لديه تداعيات سياسية تختلف كثيرا عن تلك الناتجة عن الانتخابات النيابية.
اقتراح إشكالي لجهة مدى ديمقراطيته
يطرح الاقتراح إشكالية تقليدية تتعلق بطبيعة الانتخابات في النظام الديمقراطي لأن الحد من قدرة المواطنين على الترشح يجب أن يقتصر على الشروط الضرورية فقط التي لا تعيق حرية الشعب على ممارسة سيادته. وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن القانون هو الذي يحدد كيفية انتخاب النواب (المادة 24) وأن "الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون" (المادة 29) لكن ذلك لا يعني أن القانون يمكن أن يتضمن أحكاما تؤدي إلى تقييد الحق بالترشح بشكل اعتباطي لأن ذلك من شأنه المس بالطبيعة الديمقراطية للنظام المكرسة في الفقرة "ج" من مقدمة الدستور وبكون الشعب مصدر السلطات عملا بالفقرة "د" من هذه المقدمة.
ولا شك أن المبدأ العام الذي يحكم الانتخابات هو الارتباط الوثيق بين الحق بالاقتراع والحق بالترشح إذ من المفترض أن يتم انتخاب فقط من تتوفر فيه الشروط التي تسمح له بالاقتراع. وعلى الرغم من أن الترشح يخضع في غالب الأحيان إلى شروط إضافية من غير الضروري أن تتوفر في المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع، لكن هذه الشروط يجب أن تكون متناسبة مع ديمقراطية الانتخابات، ما يعني أن تقتصر على الحد الأدنى من الشروط الإضافية التي لا تؤدي إلى منع المواطنين من ممارسة حقهم بالترشح كاشتراط مثلا أن يكون المرشح قد بلغ عمرا معينا وإن اختلف عن سن الاقتراع. ففي لبنان يصبح المواطن ناخبا عند بلوغه سن ال21 لكنه لا يحق له الترشح إلا في حال أتم الخامسة والعشرين من العمر. فهذا شرط مناسب لا يؤدي فعليا إلى الإخلال بطبيعة الانتخابات الديمقراطية علما أن لا شيء يمنع من تعديل قانون الانتخابات لتخفيض سن الترشح.
وقد كرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذه المبادئ إذ نص في المادة 25 منه على حق المواطن في "أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين" وأن تتاح له فرصة التمتع بهذه الحقوق "دون قيود غير معقولة".
لذلك قد يكون اشتراط حيازة المرشح على إجازة جامعية من الأمور التي تضع قيدا غير معقول على المواطنين بحيث تفقد الانتخابات طابعها الديمقراطي ما يعزز من النزعة النخبوية على البرلمان ويجعله حكرا على الأفراد الذين تمكنوا من استكمال تحصيلهم الجامعي.
وإذا كان من المسلم أن التشريع يحتاج إلى إلمام النائب بحد أدنى من المعرفة لا سيما القراءة والكتابة كي يتمكن من قراءة القوانين وفهم النصوص التي يقوم بالتصويت عليها، لكن الحياة النيابية لا تقتصر على التشريع بمعناه التقني كونها تحيط بكل جوانب الحياة السياسية لجهة الدفاع عن الصالح العام وحماية حقوق المواطنين. لذلك، لا يمكن أن تقتصر الحياة السياسية على المواطنين الذي يملكون شهادة جامعية لأن العمل السياسي يخص الجميع وقد يقوم به من لا يملك مؤهلات علمية خاصة لكن نضاله الطويل وانخراطه الحثيث في الحياة العامة يجعلان منه شخصية مؤهلة لتمثيل المواطنين.
وهكذا يتبين أن الاقتراح لا يتنبه إلى أن الشرعية السياسية تأتي من مصداقية النائب المنتخب، وأن الشعب صاحب السيادة يحق له أن يمنح هذه الشرعية لأيّ مواطن يتمكن من أن يحوز على ثقته بغض النظر عن درجة تحصيله العلمي. كذلك ينطلق الاقتراح في أسبابه الموجبة من اعتبارات لا يمكن التسليم بها إذ يعتبر أن الأخلاق ترتبط بالمستوى التعليمي وأن النائب الذي يحوز شهادة جامعية يمكن له أن "يفهم احتياجات" الناخبين بشكل أفضل. ومن دون الدخول في النقاش الفلسفي حول الربط بين الثقافة والأخلاق لكن ازدياد ثقافة الفرد لا تضمن تلقائيا رفعته الأخلاقية، كما أن الأخلاق بحد ذاتها مفهوم إشكالي مرتبط بالسلطة المجتمعية ما يعني أن النائب قد يجد أن مواجهة هذه الأخلاق قد تكون في ظروف معينة وفي زمن محدد ضرورية من أجل تأدية واجبه السياسي. وليس أدل على ذلك من دفاع العديد من النواب الذين يملكون إجازات جامعية على مصالح النخبة المالية المتحكمة في البلاد وتخليهم عن دورهم بحماية المواطنين العاديين الذين يشكلون الجهة الأضعف والأكثر تهميشا في المجتمع.
في الخلاصة، يصبح جليا أن الاقتراح ينطلق من نظرة نخبوية للحياة السياسية وهو يماهي بين الأخلاق والتحصيل الجامعي. ولا شك أن المؤهلات العلمية هي بالغة الضرورة لكنها يجب أن توجد في الوظائف الأكاديمية والإدارية والمهنية التي تتطلب معرفة خاصة، لكن التمثيل السياسي لا يحتاج في الحقيقة إلى مثل تلك المؤهلات الجامعية في النظام الديمقراطي القائم على الاقتراع العام والمساواة بين المواطنين. فالحد من حق المواطنين في الاقتراع والترشح عبر فرض حيازتهم على مستوى تعليمي معين أو دفعهم لحد أدنى من الضرائب كان ظاهرة تاريخية تم التخلي عنها تدريجيا مع تطور الحياة الديمقراطية. لذلك، وعلى الرغم من الأهداف النبيلة التي يعلنها الاقتراح، لكنه في الحقيقة يخالف التقاليد التي سادت النظام الانتخابي في لبنان خلال عشرات السنوات ويؤدي إلى التعرض لسيادة الشعب والحد من حريته باختيار ممثليه بشكل غير معقول ولا يمكن تبريره.