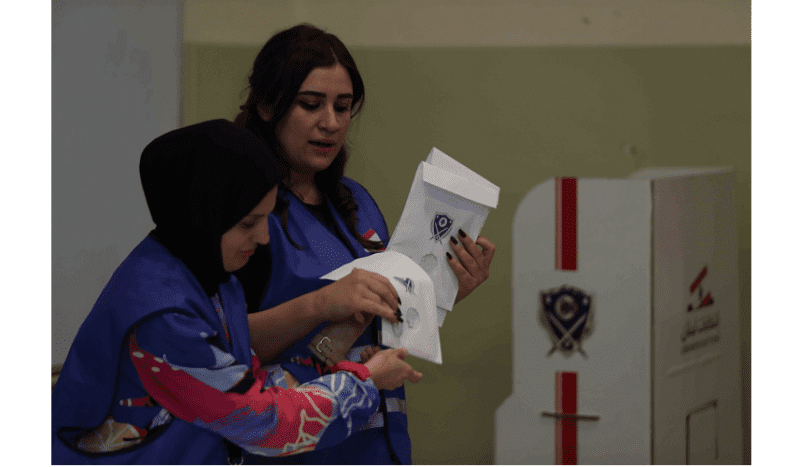اقتراح لتعديل قانون الانتخابات: إصلاح شامل ضمن النظام الانتخابيّ القائم
11/09/2025
تقدّم النائبان حليمة القعقور وأسامة سعد في تاريخ 21 آب 2025 باقتراح يرمي إلى تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 الصادر سنة 2017. ويشتمل الاقتراح على تعديل عدد كبير من المواد التي تمسّ عمل هيئة الإشراف على الانتخابات والنظام الانتخابي، فيقوم بمنح الهيئة استقلاليّة ماليّة وإداريّة وشخصيّة معنويّة ويخرجها من دائرة رقابة وزير الداخليّة، كما يعدّل كيفيّة تشكيلها فيجعل جزءًا من أعضائها منتخبين، ويقوم بإدخال كوتا نسائيّة على أعضائها ويعدّل تعويضاتهم، كما يمنح الهيئة صلاحيّة تنظيم الانتخابات بشكل كامل لا سيما في مسألة قبول طلبات المرشحين وتنظيم اللوائح وأقلام الاقتراع وغيرها من الأمور التي كانت من مسؤوليّة وزارة الداخليّة.
بالإضافة إلى بعض التعديلات على موجبات الهيئة في مراقبة الحملة الانتخابيّة وتشديد بعض المواد المتعلّقة بالإنفاق الانتخابي ومعاقبة المخالفين التي يصبح للهيئة سلطة في اتخاذ بعضها منفردة، يقوم الاقتراح بتعديل نظام الانتخاب النسبي بحيث يجعل عتبة الاستبعاد للوائح المتنافسة 5% من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابيّة الكبرى من أجل فوزها بالمقاعد النيابية. كما يلغي احتساب الأوراق البيضاء من حساب الحاصل الانتخابي. والأهمّ أنّه يضيف كوتا نسائيّة في عمليّة الترشّح وعمليّة توزيع المقاعد بحيث يعدّل الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الذي يبيّن كيفيّة توزيع المقاعد على الدوائر وعلى الطوائف، فيقوم بحفظ بعض هذه المقاعد للنساء، بمجموع 26 مقعدًا من أصل 128.
يقوم الاقتراح أيضًا بإلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين ويفتح المجال للمغتربين بانتخاب النوّاب على أساس محلّ قيدهم في لبنان.
تعتبر الأسباب الموجبة للاقتراح أن القانون بصيغته الحاليّة، بالرغم من تضمّنه "إصلاحات جزئيّة في النظام الانتخابي"، إلّا أنّه "لم يحقق الغاية المرجوّة منه في تعزيز العدالة التمثيليّة والمساواة بين المواطنين، ولا سيّما بين النساء والرجال في الحقوق السياسيّة وممارسة المشاركة الديمقراطيّة"، ما يحتّم، "في ظلّ غياب آليّات رقابيّة فعّالة واستمرار تأثير النفوذ المالي والإعلامي، وغياب تكافؤ الفرص بين المرشحين، وخصوصًا النساء والمستقلين" أن يكون هنالك "مراجعة شاملة لبعض أحكام القانون المذكور".
وتذكّر الأسباب الموجبة بأنّ لبنان بموجب دستوره قد التزم بعدد من الشرعات الدوليّة "ومنها اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)، والتوصية العامة رقم 40 الصادرة عن لجنة سيداو، والتي تحضّ على اتخاذ تدابير تشريعيّة تضمن التّمثيل المتساوي للنساء"، وبالتالي، "فإنّ غياب الكوتا النسائيّة في القانون الحالي يعدّ إخلالًا جوهريًّا بمبدأ المساواة الفعليّة". وقد اعتبرت الأسباب المُوجبة أنّ ضعف تمثيل النساء يمتدّ إلى هيئة الإشراف على الانتخابات ما يبرّر "تضمين الكوتا النسائيّة في تأليف هيئة الإشراف".
بالإضافة إلى ما تقدّم، تتطرّق الأسباب الموجبة إلى مسائل متعددة هي على سبيل المثال مشكلة ردعيّة الإجراءات التي من شأنها معاقبة مخالفي قانون الانتخابات ومسؤوليّة محكمة المطبوعات في هذا الأمر، فتبرر تعديل صلاحيات الهيئة "ومنحها طابعًا قضائيًّا وإداريًّا مستقلًّا، يعزز الرقابة الفعليّة على العمليّة الانتخابيّة"، بالإضافة إلى التطرّق إلى مسألة التسجيل المسبق للناخبين الذي من شأنه تخفيف الضغط عليهم وتمكينهم من التصويت بحريّة أكثر لاسيما النساء اللواتي يعتبرهن الاقتراح الحلقة الأضعف، بالإضافة إلى ضمّ نفقات التنقّل التي تصرف على الناخبين إلى حساب المصاريف الانتخابيّة ضمن السقف المسموح به وإلغاء الاستثناءات على منع التقديمات إلى الناخبين.
أخيرًا، لا بدّ من ذكر مسألة العتبة الانتخابيّة التي تتطرّق إليها الأسباب الموجبة والتي تشكّل تغييرًا كبيرًا في النظام الانتخابي حيث تعتبر أنّ "العتبة المعتمدة حاليًّا تشكّل عائقًا أساسيًّا أمام تمثيل فئات واسعة من الناخبين، إذ تؤدّي إلى استبعاد لوائح نالت نسبًا معتبرة من الأصوات لمجرّد عدم بلوغها الحاصل الانتخابي". وبالتالي فإنّ ذلك يعزّز "احتكار التمثيل" ويؤدّي إلى "هدر فعلي للأصوات وإضعاف مبدأ النسبيّة" وبالتالي فإنّ تعديل العتبة يكون ضروريًّا لضمان "عدالة أكبر في توزيع المقاعد" ومنح "فرص متكافئة للوائح مستقلّة" وتعزيز "ثقة المواطنين بالعمليّة الانتخابيّة".
جراء ما تقدّم، لا بدّ من إبداء عدد من الملاحظات على اقتراح القانون إذ سيتمّ التطرّق أوّلًا إلى التعديلات التي طالت هيئة الإشراف على الانتخابات وثانيا تلك التي طالت النظام الانتخابي ومن ثم الإصلاحات المتعلقة بتعزيز المحاسبة والشفافية المالية للحملة الانتخابية.
أوّلًا: التعديلات على هيئة الإشراف على الانتخابات
تطال التعديلات المقترحة سبع موادّ تتعلّق بهيئة الإشراف على الانتخابات هي التالية:
- تعزيز استقلالية الهيئة (المادة 9)
يعدّل الاقتراح طبيعة الهيئة كما هو منصوص عليها في المادة التاسعة من القانون، بحيث تصبح متمتّعة "بالشخصيّة المعنويّة والاستقلاليْن الإداري والمالي، وتعتبر هيئة إداريّة ذات صفة قضائيّة". بالتالي، تصبح هيئة الإشراف مستقلّة تمامًا عن وزير الداخليّة التي كانت تمارس مهامّها "بالتنسيق" معه بحسب القانون النافذ حاليّا والذي ينصّ على أنّ الوزير يواكب عملها و"يحدّد مقرّها ويؤمّن بها مقرًّا خاصًا مستقلًّا ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون أن يشارك في التصويت". بالإضافة إلى ذلك، فإنّ التعديل يمنح الهيئة مسؤوليّة تنظيم الانتخابات بكاملها والإشراف عليها وتنظيمها، أي أنّها ستحلّ محلّ وزارة الداخليّة في هذه المهام، ما يعني تحوّلًا جذريًّا في طريقة تحضير الانتخابات التي كانت تعهد تاريخيًّا إلى وزارة الداخليّة المرتبطة بالسلطة السياسيّة. كما يعطي التعديل الهيئة دورًا تثقيفيًّا وتوعويًّا في الشؤون الانتخابيّة.
أخيرًا، ينص التعديل أنّه يكون للهيئة "مقرّ مستقلّ خاصً بها"، و"يمنح رئيسها وأعضاؤها الحصانات والصلاحيات اللازمة لممارسة مهامهم بكل استقلال وفعاليّة".
لا بدّ من الملاحظة أنّ الهيئة كما تصورها الاقتراح تصبح بذلك شبيهة بالهيئات المستقلّة التي أنشأها المشرّع اللبناني على مثال هيئة المفقودين والمخفيين قسرًا والهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان. إلّا أنّها تتميّز عن غيرها بأنّ نصّ الاقتراح على منحها "صفة قضائيّة" بشكل صريح، خلافًا للهيئات المستقلّة الأخرى التي يجب استنتاج صفتها القضائيّة انطلاقًا من مجموعة من المعايير الشكليّة والماديّة الموجودة في نصّ إنشائها. وتأكيدًا على ما تقدّم، فإنّ المادة 21 من قانون الانتخابات تنص على أنّ قرارات هيئة الإشراف تخضع "للاستئناف" أمام مجلس شورى الدولة، ما يعزّز اكتساب هذه الهيئة الصفة القضائيّة لأن بإمكان مجلس شورى الدولة أن يعطي الوصف القانونيّ الصحيح للمراجعات التي تُرفع أمامه إذ يميز بين مراجعة الإبطال لتجاوز حدّ السلطة التي تختصّ فقط بالأعمال الإدارية، ومراجعة الاستئناف والنقض التي توجه ضد القرارات التي لها طابع قضائي.
وفي معرض الحديث عن الصفة القضائيّة للهيئة، لا بدّ من العودة إلى الأسباب الموجبة التي ذكّرت أنّ التجارب السابقة في انتخابات 2018 و2022 بيّنت مدى تقاعس محكمة المطبوعات عن أداء دورها في ملاحقة المرتكبين بشكل سريع وفعّال ورادع، ما أدّى بالتالي إلى تعاظم المخالفات في الحملات الانتخابيّة وانتشار الفلتان بين الوسائل الإعلاميّة والمنصّات الإخباريّة. واعتبرت الأسباب الموجبة أنّ هذا الوضع يبرّر إعطاء الهيئة الصفة القضائيّة ما "سيعزّز الرقابة الفعليّة على العمليّة الانتخابيّة". إلّا أنّ الاقتراح اكتفى بإعلان النوايا هذا ولم يقم بتعديل مواد القانون التي تنظم إحالة المخالفات من قبل الهيئة إلى محكمة المطبوعات لكي تصبح الهيئة هي المسؤولة عن فرض العقوبات وبالتالي فإنّ الأمور ما زالت على حالها في هذا الشأن.
من جهة أخرى، لا شك أن توسيع صلاحيات الهيئة ومنحها الاستقلالية المطلوبة هو إصلاح ضروري ومهم جدا لكن المشكلة لا تكمن فقط في منح هذه الأخيرة الأدوات القانونية التي تتيح لها الإشراف بشكل فعال على الانتخابات لكن أيضا في منحها الإمكانات المادية والموارد المالية التي تخولها ممارسة هذا الدور الجديد. وقد عالج الاقتراح هذا الأمر إذ نص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة عن السنة التشغيلية الأولى لها قيمته 1350 مليار ليرة ما يسمح لها بممارسة صلاحياتها من دون انتظار اقرار قانون مستقبلي بمنحها الاعتمادات المطلوبة وهو الأمر الذي عانت منه الهيئة خلال الانتخابات الأخيرة وأدى إلى عرقلة عملها.
ولا يقتصر الاقتراح على تأمين التمويل الضروري للهيئة عن السنة المقبلة لكنه يكرّس استقلاليّتها المالية بشكل دائم. إذ أنّ القانون النافذ حاليا يربط الاعتمادات الماليّة الخاصّة بالهيئة بموازنة وزارة الداخليّة، أمّا الاقتراح فهو ينصّ على أن "يكون للهيئة موازنة سنويّة خاصة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة" على أن تعدّ الهيئة بنفسها مشروع الموازنة وترسله إلى وزير الماليّة الذي يضمه إلى الموازنة العامة المرفوعة إلى مجلس الوزراء ما يفهم منه أن وزارة المالية لا يحق لها التدخل في كيفية إعداد الهيئة لموازنتها.
والأهمّ من ذلك أنّ هذه الاستقلالية الكبيرة للهيئة اقترنتْ مع منحها صلاحية "الإشراف الكامل على العملية الانتخابية وإعدادها وتنظيمها" ما يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة العلاقة بينها وقوى الأمن الداخلي التي تخضع بصفتها ضابطة إدارية إلى سلطة وزارة الداخلية. إذ أن الاقتراح لا يشرح طبيعة هذه العلاقة الناتجة عن الدور الجديد للهيئة وما إذا كان يحقّ لها توجيه الأوامر إلى قوى الأمن الداخلي إذ لا يعقل أن تكون مسؤولة بالكامل عن تنظيم الانتخابات والإشراف عليها من دون تمتعها بحق الإمرة على القوى الأمنية. إذ أيّ حل مخالف يعني أن جميع توجيهات الهيئة يجب أن تمر بوزارة الداخلية وتحصل على موافقتها ما يفقد الهيئة المعنى الحقيقي لاستقلاليتها.
لكن الاقتراح تنبّه إلى أن هذه الاستقلالية تفقد جدواها في حال لم تحصل الهيئة على جهاز إداريّ خاصّ بها كي تمارس جميع صلاحياتها على أكمل وجه. لذلك نصّت المادة 23 المعدلة على إنشاء جهاز إداريّ مستقلّ خاصّ بالهيئة ومتفرّغ، يرأسه أمين عام "يتمّ تعيينه من قبل الهيئة بعد مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية"، على أن يكون للهيئة أن تستعين بمن تشاء من خارج أعضائها وموظفيها. وقد عانت الهيئة خلال الانتخابات النيابية الماضية من نقص الموظفين وضعف قدراتها البشرية ما عرقل عملها وجعلها تواجه صعوبات كان يمكن تداركها لو كانت تتمتع بجهاز إداريّ متفرغ وهو الأمر الذي سعى الاقتراح لمعالجته.
- هيئة منتخبة بالكامل (المواد 10-11-12).
يقوم الاقتراح بتعديل الفقرة الثانية من المادة التي تنصّ حاليًّا على أن "يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضويّة الهيئة" من خلال إدخال "كوتا نسائيّة" على الهيئة "بحيث لا يقلّ عدد النساء عن ثلث أعضائها". كما تضيف بند جديد ينصّ أنّه "على الجهات أو المؤسسات التي تتقدّم بأسماء مرشحين لعضويّة الهيئة أن ترفق اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن الأسماء المقترحة".
ولا شك أن هذا التعديل يساهم في نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في مختلف الشؤون التي تخص الحياة العامة لا سيما الانتخابات النيابية. وهذا الأمر ينسجم مع فلسفة الاقتراح الذي يعمد إلى إدخال كوتا نسائية في الانتخابات النيابية إذ لا يعقل أن تكون الهيئة التي تشرف على احترام الكوتا وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية خالية من أيّ تمثيل نسائي. لذلك يمكن القول أن الاقتراح حاول قدر الإمكان تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين ليس فقط على مستوى العملية الانتخابية لكن أيضا في الجهات المشرفة عليها ما يشكل تطورا إيجابيا في لبنان.
يستعيد الاقتراح أيضا ما نصّ عليه التعديل الحاصل سنة 2021 على المادة 11، لجهة كيفية تشكيل الهيئة بحيث يتمّ تعيين الأعضاء "لمرة واحدة ولهذه الدورة فقط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخليّة والبلديات"، إلّا أنّه اختلف عن نصّ سنة 2021 بتحديد ولاية الهيئة بستّ سنوات غير قابلة للتجديد وليس بسنة واحدة فقط.
ولا شك أن هذا النص الجديد يؤدي إلى الاستقرار في عمل الهيئة نظرا للولاية الطويلة ما يعزز من استقلاليتها ويكسبها خبرة إضافية كون الولاية تمتد على ست سنوات ما يتيح لها الإشراف على أكثر من انتخابات عامة واحدة.
لكن الاقتراح لا يكتفي بجعل ولاية الهيئة تمتد على ستّ سنوات لكنه ينص أن الهيئة الجديدة التي سيتم تعيينها ستتولى قبل انتهاء ولايتها بسنة واحدة، تحضير "انتخاب خلفها تحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات" كما على الهيئة أن "تضع دقائق تطبيق العمليّة الانتخابيّة الخاصّة بها"، ما يفهم منه أن الهيئة ستصبح منتخبة. بالتالي، فإنّ الاقتراح يقوم باستبدال طريقة التعيين بالانتخاب من دون أن يعلن ذلك بشكل واضح. وهو يترك للهيئة تحديد كيفيّة إتمام العمليّة من دون الانتباه إلى النقص الذي سيحصل في النص، ما يفقده وضوحه ويحرم الهيئة من الضمانات التي تصون استقلاليتها. فالمادة العاشرة كما يعدلها الاقتراح تحدد كيفية تشكيل الهيئة لناحية العضوية إذ تنص على مجموعة من الأعضاء يتوجب ترشيحهم ضمن لائحة تضم ثلاثة أسماء من قبل جهات معينة على أن يتم "اختيار" أحد الأسماء. وهو أمر منطقي كون الهيئة يتم تعيينها من قبل مجلس الوزراء الذي ترفع إليه أسماء جميع المرشحين من قبل الجهات المعنية. لكن الانتقال من هيئة معينة إلى هيئة منتخبة يجعل من هذه الآلية فاقدة لمعناها إذ من غير المعلوم من هي الجهة التي ستنتخب الأعضاء الجدد كون القانون يشير فقط إلى الجهات التي تتولى تقديم أسماء المرشحين ما يعني أن هذه الجهات غير مخولة بانتخاب العضو المذكور.
وينسحب هذا الغموض على المادة 12 من الاقتراح التي تميّز بين الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين عند حصول شغور أحد مراكز. ففي حال شغر مركز أحد الأعضاء المعينين، يتم ملء الشغور بحسب الآلية المنصوص عليها في القانون. أمّا في حال شغور مركز أحد الأعضاء المنتخبين، "فيتم إعادة انتخاب العضو البديل في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الشغور". إلّا أنّ المشكلة تكمن مجددا في عدم تحديد الآلية القانونية لانتخاب العضو الاصيل ما يعني أن انتخاب العضو البديل هو أمر غير معلوم.
وفي اتجاه تعزيز استقرار الهيئة، يساوي الاقتراح في المادة 18 بين رئيس الهيئة والأعضاء في مسألة تقاضيهم التعويضات شهريًّا طيلة مدّة ولايتهم بينما كانت هذه التعويضات محصورة فقط في فترة العملية الانتخابيّة للأعضاء. كما أنّ الاقتراح يلزم الأعضاء بالإقلاع عن أي عمل آخر يقومون فيه طيلة مدّة ولايتهم وليس فقط في فترة الانتخابات، وذلك على غرار رئيس الهيئة.
ولا شكّ أن جعل ولاية الهيئة تمتدّ على ستّ سنوات وزيادة مسؤولياتها يفرض تحصين الأعضاء عبر منحهم الاستقرار الوظيفي الذي يسمح لهم بالتفرّغ للقيام بمهامّهم المستجدّة، وهو ما يصبّ في الهدف المعلن للاقتراح ألا وهو تعزيز استقلالية الهيئة ورفدها بالطاقات الدائمة.
- توسيع صلاحيات الهيئة (المادة 19)
أضاف التعديل المقترح عددًا من المهام الموكلة إلى هيئة الإشراف على الانتخابات بالنسبة إلى نصّ المادة الحالي. ويعود هذا التغيير في جزء كبير منه إلى تحميل الاقتراح الهيئة مسؤوليّة تنظيم الانتخابات بأكملها بدلًا من وزارة الداخليّة.
يفسّر ذلك أن يضاف إلى مهام الهيئة موجب "تنظيم وإدارة العمليّة الانتخابيّة في جميع مراحلها الإداريّة، من تسجيل الناخبين، والإشراف على الترشيحات، إلى تنظيم أقلام الاقتراع، وإعداد مستلزمات العمليّة الانتخابيّة بالتنسيق مع الجهات المختصّة". كما إضافة مهمّة "تنظيم عمليّة تسجيل الناخبين، والتسجيل المسبق، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، بالتنسيق مع المديريّة العامة للأحوال الشخصيّة".
يضيف الاقتراح أيضًا مهمّات "تلقي طلبات الترشح وتدقيقها من الناحية الشكليّة والإداريّة، ورفع التقارير بشأنها إلى الوزير، مع اقتراح قبولها أو رفضها وفق أحكام القانون"، و"الإشراف على تجهيز مراكز وأقلام الاقتراع، وتوزيع التجهيزات واللوازم، بالتنسيق مع الجهات الإداريّة والأمنيّة المختصّة".
فضلًا عن هذه الزيادات، تضيف المادة المعدّلة نصًّا صريحًا يوكل الهيئة مهمّة "تنظيم العمليّة الإعلاميّة والإعلانيّة خلال الحملات الانتخابيّة، من خلال منح التصاريح لوسائل الإعلام، ووضع مدونة سلوك ملزمة للتغطية الإعلاميّة" بينما النص الحالي يكتفي بالطلب من الهيئة وضع مدونة سلوك من دون أن يعتبرها إلزاميّة. وينصّ الاقتراح أيضًا على مهمّة الهيئة "برصد المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها"، دون مزيد من التوضيح عن هذه الإجراءات. كما يُبقي الاقتراح على النص الموجود أصلًا في المادة والذي يتحدّث عن دور الهيئة في مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام بالقوانين. وعلى الرغم من أن الهيئة طالبت في تقريرها حول انتخابات 2022 بإعطائها صلاحية مراقبة نشر الإعلانات والدعايات الانتخابية والحقّ “بالوقف الفوري لأي برنامج مخالف له علاقة بالشأن الانتخابي خلال فترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي” لكن الاقتراح لم يستجب لتلك المطالب.
وفي النهاية، يضيف الاقتراح بندًا أخيرًا ينص على مهام الهيئة خارج الفترة الانتخابيّة، التي تأخذ طابعًا رقابيًا واستشاريًا بهدف تعزيز الشفافيّة الديمقراطيّة ورصد التطورات القانونية والسياسيّة المتصلة بالعملية الانتخابية، وإصدار تقارير دوريّة بشأن جاهزيّة الإدارة الانتخابيّة وغيرها من الأمور.
ومن البيّن أن جميع هذه الصلاحيات الجديدة كفيلة بتحويل الهيئة فعليا إلى سلطة مستقلة لكن العبرة تكمن في التنفيذ، أي تكوين الجهاز الإداري للهيئة ورفدها بالموارد المالية قبل الانتخابات النيابية المقبلة منتصف 2026.
ثانيًا: التعديلات على النظام الانتخابي والعملية الانتخابية
ينطلق الاقتراح من مقاربة عملية. إذ هو لا يهدف إلى تعديل النظام الانتخابي بالكامل بل إلى إدخال إصلاحات مهمة من ضمن النظام القائم. ولا شكّ أن هذا التوجه ينطلق من دوافع واقعية تجد أن التوافق بين الكتل السياسية المهنية على البرلمان لا يمكن تأمينه من أجل تبنّي نظام انتخابي جديد يؤدّي إلى تهديد سيطرة هذه الأخيرة على الحياة السياسية في لبنان. لذلك يعمد الاقتراح إلى إدخال أكبر قدر ممكن من الإصلاحات من دون تهديد التوازن السياسي القائم اليوم، علمًا أن هذه الإصلاحات يمكن تطبيقها حتى لو جرى إدخالها قبل أقل من سنة على الانتخابات المقبلة سنة 2026.
- الكوتا النسائية
ومن أهم تلك الإصلاحات اعتماد الكوتا النسائية عبر تعديل المادة 2 من القانون المتعلّقة بتوزيع المقاعد النيابيّة على الدوائر الانتخابيّة والطوائف فيضيف من خلال اشتراط توزيع المقاعد أيضا "على كلا الجنسين". ويعمد الاقتراح إلى تعريف مفهوم الكوتا النسائية فيعتبر أنّه "النظام الذي يحفظ للمرأة حدًّا أدنى من المقاعد في المجلس النيابي وفقًا لأحكام هذا القانون، بهدف تحقيق هذه الكوتا ضمان حق المرأة في التمثيل النيابي بالحدود الدنيا، تخصص، بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، كوتا نسائيّة بعدد 26 مقعدًا على الأقل من إجمالي المقاعد النيابية، تعود للمذاهب التي خصصت لها أكثر المقاعد عددًا في الدوائر الانتخابيّة، وفقًا للجدول المرفق بهذا القانون".
وفي السياق نفسه تعالج المادة 52 من القانون النافذ حاليا مسألة تشكيل اللوائح الانتخابيّة، فتنصّ على أن كل لائحة يجب أن تضمّن "كحدٍ أدنى 40% من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى". أمّا الاقتراح، فيرفع الحدّ الأدنى من المقاعد المطلوبة إلى 60% على أن تكون هذه النسبة مكوّنة "من كلا الجنسين"، ما يعني استحداث كوتا نسائيّة، تحت طائلة أن "تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقًا لنص هذه المادة" بحسب البند الخامس من الصياغة الجديدة للمادة.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح الاقتراح في بند ثالث جديد شكل هذه الكوتا النسائيّة فينصّ على أنّ "يحفظ للمرأة حقها في الترشح على اللوائح الانتخابيّة عن طريق تخصيص نسبة لا تقل عن 40% (أربعون بالمائة) للمرشحات من النساء في اللوائح الانتخابيّة". وتقول المادة الجديدة بأنّه "لا تسجل اللوائح التي تفتقر لهذه النسبة كحدّ أدنى" كما "يعود الخيار لكل مرشحة في أن تدرج ترشيحها ضمن نظام الكوتا على المقاعد المحفوظة للنساء وفي هذه الحالة تدوّن وفق طلب الترشيح عبارة "عن مقعد الكوتا النسائيّة" وإلّا فيكون ترشيحها حكمًا من خارج النظام المذكور".
وهكذا يتبين أن الاقتراح يتبنى مبدأ الكوتا ليس فقط في الترشيح لكن أيضا في النتائج كونه يفرض على اللوائح أن تضم نسبة معينة من المرشحات ومن ثم يفرض مجددا عند توزيع المقاعد فوز على الأقل 26 مرشحة أي ما يقارب 20% من مجموع أعضاء مجلس النواب وهي نسبة متواضعة نسبيا لكنها تشكل تحسنا ملموسا على الواقع الحالي. ومن الملاحظ أن الاقتراح يقوم بتوزيع المقاعدة المخصصة للمرأة على جميع الدوائر لكنه يحصرها بالطوائف الكبرى وهو أمر يمكن فهمه بخصوص الطوائف الصغرى التي يقتصر تمثيلها على مقعد وحيد إذ لا يعقل تخصيصه للمرأة كون ذلك يؤدي إلى حرمان الذكور من الترشح ما يشكل انتهاكا لحقوقهم الدستورية.
ومن اللافت أنّ الاقتراح عمد إلى تعديل المادة 74 من القانون التي تحدد الموجبات التي يجب على الوسائل الإعلاميّة التقيّد بها فأضاف موجبا جديدا هو "الامتناع عن نشر أو ترويج كلّ ما يمكن أن يحطّ من كرامة المرأة ومكانتها أو يحدّ من مشاركتها في الحياة السياسيّة". وهذا تدبير حداثي وإصلاح متقدم يعني أن الدولة تلتزم بتعزيز حقوق المرأة ولا تعتبر أن مشاركتها في الحياة العامة مجرد موقف شخصي يمكن اتخاذه على الصعيد الخاص سواء كان الفردي أو العائلي.
- تكريس الميغاسنتر
يستبدل الاقتراح نصّ المادة 84 الأصلي الذي ينظّم موضوع البطاقة الالكترونيّة بنصّ جديد يهدف إلى إنشاء "مراكز اقتراع كبرى" (الميغاستنتر) في "الأقضية الكبرى" بغية السماح للناخبين "الاقتراع في مراكز مركزية ضمن نطاق سكنهم" ما يؤدّي إلى التخفيف من الضغط على "مراكز القيد التقليديّة". وتولي المادة الجديدة مهمة تحديد المراكز وتوزيعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قبل موعد الانتخابات "بثلاثة أشهر على الأقل".
وهكذا يكون الاقتراح قد جعل من الميغاسنتر حقيقة قانونية قائمة بذاتها بينما النص الحالي لا يشير إلى هذه الأخيرة بل يكتفي بالطلب من الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في الانتخابات من دون تحديد أي سقف زمني لذلك. فالبطاقة الممغنطة تتيح إمكانية التسجيل المسبق للناخبين ما يفهم منه أن اعتماد هذه البطاقة يتيح للناخب إبداء رغبته للاقتراع في مكان سكنه وليس في مكان قيده حتى لو كان لا يحقّ له الاقتراع إلا لمرشحين في مكان قيده. لكن الاقتراح الحالي يعلن هذا الحق صراحة إذ يعمد إلى تعديل المادة 34 من القانون عبر إضافة فقرة تعطي الناخب الحق أن "يطلب من لجنة القيد المختصة تدوين نقل مكان اقتراعه للمرشحين في دائرة قيده الأصلي من مكان هذا القيد إلى مكان سكنه"، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحصل إلا مع إنشاء مراكز اقتراع كبرى.
ولا شك أن لتلك المراكز ايجابيات كثيرة لعل أبرزها تسهيل ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية وتجنيبهم مشقة الانتقال إلى أماكن بعيدة، هذا فضلا عن حمايتهم من الضغوط الحزبية التي قد يتعرضون لها في مكان قيدهم الأصلي خصوصا في المناطق التي تخضع لسطوة زعيم أو جهة سياسية نافذة. ومن إيجابيات الميغاسنتر أيضا تسهيل عملية مراقبة الانتخابات من قبل الجمعيات المتخصصة كما امكانية تزويدها بالبنية التحتية الضرورية لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة ما يعزز من مبدأ المساواة بين المواطنين.
لكن المعضلة لا تكمن في الوجود القانوني لمراكز الاقتراع الكبرى لكن فقط في كيفية استحداثها وهل تمتلك الحكومة الإمكانات المادية والبشرية الضرورية التي تسمح لها بذلك خلال الفترة القصيرة التي باتت تفصلنا عن الانتخابات المقبلة، هذا علما أن ذلك يتطلب مسبقا تسجيل الناخبين واستحداث قاعدة بيانات مركزية تتم إدارتها من قبل جهة محترفة يمكن لها التنسيق مع كل لجان القيد في مختلف الدوائر الانتخابية، علما أن الاقتراح يكتنفه الغموض عندما يعلن ضرورة إنشاء تلك المراكز في "الأقضية الكبرى" كون تحديد هذا المفهوم هو متروك بالكامل لاستنسابية مجلس الوزراء الذي يستطيع أن يستحدث مراكز اقتراع كبرى في بعض المناطق ويمتنع عن ذلك في مناطق أخرى لأسباب سياسية ما يؤدي إلى المس بعدالة الانتخابات وخرق مبدأ المساواة بين الناخبين.
- تعديل النظام الانتخابي
يُحدث الاقتراح في المادة 99 منه تغييرًا جوهريًّا في طريقة تأهّل اللوائح إلى مرحلة توزيع المقاعد الانتخابيّة، إذ إنّ النص الحالي يشترط نيل اللائحة عددا من الأصوات يوازي الحاصل الانتخابي لدخول مرحلة توزيع المقاعد، فيما النص المقترح يشترط لتأهّل أي لائحة للمشاركة في توزيع المقاعد "أن تنال ما لا يقلّ عن 5% (خمسة بالمئة) من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابيّة الكبرى، وتستبعد اللوائح التي لا تبلغ هذه العتبة من عمليّة احتساب المقاعد". كذلك الأمر بالنسبة للمادة 103 حول الأوراق البيضاء إذ يعمد الاقتراح إلى العودة إلى المبدأ العام حول هذا الموضع من خلال اعتباره أن الأوراق البيضاء، أي التي "لم تتضمن أي اقتراع للائحة وللأصوات التفضيليّة"، لا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي بينما المادة الحاليّة تعتبر أن هذه الأوراق تدخل ضمن عدد أصوات المقترعين المحتسبين.
ومن البديهي القول أن هذا التعديل يعدّ الأبرز لناحية تداعياته على نتائج الانتخابات لأن الحاصل الانتخابي يشكل عتبة استبعاد مرتفعة تستفيد منه أحزاب السلطة الكبيرة التي يمكن لها بسهولة تخطيه بينما تجد الأحزاب الجديدة نفسها مستبعدة حتى لو حصلت على عدد مهم من الأصوات. وما كان يفاقم من هذا الخلل هو اعتبار أن الأوراق البيضاء تدخل في عداد احتساب الحاصل الانتخابي ما كان يرفع هذا الأخير بشكل إضافي مقصيا الأحزاب الصغيرة ومانغا إياها من الفوز بأي مقعد. وسرعان ما يظهر الفرق في حال المقارنة مع نتائج انتخابات 2022، ففي دائرة الجنوب الثانية (صور-قرى صيدا) مثلا كانت عتبة الاستبعاد 20053 صوتا بينما تصبح في حال تم إقرار الاقتراح الحالي 8047 صوتا. كذلك الأمر في دائرة الشمال الثانية (طرابلس-المنية-الضنية) إذ كانت عتبة الاستبعاد 12493 سنة 2022 بينما ستصبح 7087 وفقا للاقتراح. والأمر نفسه يتكرر في دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان-جبيل) إذ تنخفض عتبة الاستبعاد من 12935 ِإلى 5886.
وهكذا يتبين من هذه الأرقام أن الاقتراح سيؤدي إلى تعديل كبير ليس فقط في نتائج الانتخابات لكن في السلوك الانتخابي للوائح التي ستجد أن التكتل في لائحة واحدة سيوفر لها فرصا أكبر بكثير للفوز. لذلك يمكن القول أن خفض عتبة الاستبعاد يساهم في كسر احتكار الأحزاب الكبيرة للتمثيل ويسمح النظام النسبي بإعطاء كامل مفاعيله ما يؤمن عدالة أكبر في التمثيل النيابي.
- اقتراع المغتربين (المواد 112 و113 و114 و118 و121 و122)
يستعيد هذا الاقتراح أحكاما مشابهة لاقتراح سابق يخصّ تصويت المغتربين كان النائب أسامة سعد أيضًا أحد الموقعين عليه، حيث يلغي ما ينصّ عليه القانون الحالي لجهة تخصيص ستة نواب ينتخبهم المغتربين، ويكرّس الممارسة التي سادت في انتخابات 2018 و2022 حين قام اللبنانيون في الاغتراب بانتخاب النواب ال128 كافة على أساس محلّ قيد كلّ مقترع في لبنان.
ويستعيد الاقتراح الحالي ما ورد في الاقتراح السابق بخصوص مهلة تسجيل المغتربين في "العشرين من شهر أيار من السنة التي تسبق الانتخابات النيابيّة، على أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج"، أي أنّها أصبحت مهلة ستة أشهر ثابتة، فيما النص الحالي للقانون، المعدّل سنة 2021، ترك تاريخ فتح باب التسجيل لتقدير وزارة الداخلية وأمر بألّا تتجاوز المهلة تاريخ العشرين من شهر تشرين الثاني 2021، أي قبل ستة أشهر من الانتخابات التي حصلت في أيار 2022. وبالتالي، فإنّ ترك تاريخ بداية التسجيل إلى قرار استنسابي من الوزارة يحدّ من الضمانة بأن تكون فترة التسجيل طويلة بما فيه الكفاية لتمكين جميع المغتربين الراغبين من تسجيل أنفسهم، وهذا ما أتى الاقتراح ليعالجه. بالإضافة إلى ذلك، يستعيد الاقتراح الحالي ما نصّ عليه الاقتراح السابق لجهة تقليص عدد المغتربين المسجلين المطلوب لفتح مركز انتخابي وكيفيّة احتسابهم وغيرها من المسائل التي تخصّ انتخاب المغتربين.
ولا شك أن اقتراع المغتربين لنواب في الدوائر الانتخابية داخل لبنان هو مطلب إصلاحي كبير تدور حوله صراعات سياسية بين الأحزاب الحاكمة، وقد عالجته المفكرة القانونية بإسهاب في تعليقها على الاقتراح السابق.
ثالثًا: التعديلات التي تخصّ شفافيّة العمليّة الانتخابيّة
- إلغاء الرشوة القانونية (المادة 58 والمادة 62)
تستعيد المادة 58 معدّلة ما أشارت إليه الأسباب الموجبة لجهة ضرورة إعادة النظر في اعتبار الأموال المنفقة من قبل المرشحين على نقل الناخبين داخل لبنان أو خارجه على أنّها مصاريف انتخابيّة مقبولة. إذ تمّ حذف عبارة " مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج" من عداد المصاريف الانتخابية المقبولة.
ولا شك أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من الزبائنية كون أحزاب السلطة هي أكثر المستفيدين من الشرعنة القانونية لهذه الرشوة الانتخابية عبر نقل الناخبين داخل لبنان أو من الخارج وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المرشحين ويهدد عدالة الانتخابات برمتها إذ هو يضاعف من قوة الأقوياء ويمعن في مفاقمة ضعف الأحزاب الجديدة أو الصغيرة.
لكن الاقتراح لم يتنبّه إلى أنّ تعداد هذه المصاريف في المادة 58 جاء على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي، فإنّ حذف هذه الفقرة لا يكفي وحده من أجل حظر تلك المصاريف إذ قد تعتبر الجهات المعنية في اجتهادا لها أن مصاريف النقل وشراء تذاكر السفر تدخل في خانة المصاريف المقبولة طالما أنّه لا يوجد نصّ واضح يمنعها أو يعتبرها رشوة يعاقب عليها.
من جهة ثانية، يعمد الاقتراح إلى إلغاء الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الانتخابات الحالي والتي تعتبر أن حظر التقديمات والخدمات المقدمة من الأحزاب والمرشحين خلال الحملة الانتخابية لا يطبق في حال كان ذلك يتم بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية منذ ثلاث سنوات على الأقل. ولا شك أن إلغاء هذا الاستثناء بات مطلبا إصلاحيا دائما وهو ينسجم مع مبدأ منع استخدام النفوذ المالي كمصدر للزبائنيّة السياسيّة التي باتت الوسيلة الفضلى التي تستخدمها أحزاب السلطة من أجل السيطرة على الناخبين. وهكذا يكون الاقتراح قد ألغى هذه الرشوة القانونية التي يسهل التحايل عليها والتي تؤدّي عمليّا إلى إعطاء أرجحية واضحة للأحزاب التقليدية على حساب الأحزاب الجديدة.
- الحسابات الخاصة وتدقيق الحسابات (المادة 59)
ينص البند الثاني المعمول به حاليا من المادة 59 المتعلّقة بحساب الحملة الانتخابيّة وتعيين مدقق حسابات، على أنّه "لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح واللائحة متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه". إلّا أنّ التعديل أضاف على الحسابات المرفوعة عنها السريّة المصرفيّة "الحسابات الشخصيّة للمرشح، أو لزوجه، أو لأصوله، أو لفروعه، أو لإخوته وأخواته" كما أضاف أنّه "يعتبر المرشح متنازلًا حكمًا عن السرية المصرفيّة لهذه الحسابات بمجرد تقديم طلب الترشح". بالإضافة إلى ذلك، يرفع الاقتراح المبلغ الذي لا يجوز قبضه أو دفعه إلّا بموجب شيك من مليون إلى سبعة ملايين ليرة.
ويعتبر هذا التعديل خطوة مهمة كونه يستجيب لمطلب هيئة الإشراف على الانتخابات التي أشارت في تقريرها حول انتخابات 2022 إلى ضرورة رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة للمرشح أو حسابات الزوج أو الفروع أو الأصول أو الأخوة والأخوات إذ لا يعقل أن يتم حصر رفع السرية بالحساب الرسمي للحملة الانتخابية.
وإذا كان الاقتراح قد استجاب لمطالب الهيئة في هذا الموضوع لكنه أبقى على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التي تلزم الهيئة بالفصل بالبيان الحاسبي للمرشحين بعد انتهاء الانتخابات خلال مهلة ثلاثين يوما وإلا اعتبر البيان مصدقا حكما. وقد اعتبرت الهيئة في تقريرها المذكور أن هذه المهلة قصيرة جدا وغير كافية إذ لا تتمكن من النظر في بيانات مئات المرشحين ما يؤدي إلى ضياع المحاسبة الفعلية وقد طالبت برفع تلك المهلة إلى خمسة أشهر لكن الاقتراح الحالي لم ينتبه لهذا الأمر.
- عقوبات رادعة وإشكالية منع الترشيح (المادة 66)
يقوم الاقتراح في المادة 66 بتعديل قيمة الغرامات المفروضة حيث أنّ التأخير في تقديم البيان الحسابي الشامل بات يعاقب بغرامة قدرها مئة مليون ليرة لبنانيّة عن كلّ يوم تأخير بدلًا من مليون ليرة في النص الحالي، وتجاوز السقف الانتخابي بات يعاقب بغرامة توازي مائة ضعف قيمة التجاوز لصالح الخزينة بدلًا من ثلاثة أضعاف في النص الحالي. كما يعطي التعديل المقترح صلاحيّة فرض الغرامة على المرشح المتأخر في تقديم البيان الحسابي إلى هيئة الإشراف على الانتخابات علما أن النص الحالي يمنح هذه الصلاحيّة إلى وزارة الداخليّة بناء على طلب الهيئة.
ولا شك أن رفع الغرامات المالية بات أمرا ملحا لأن الغرامة الحالية باتت زهيدة جدا نظرا لانهيار سعر صرف الليرة ما يفقدها طابعها الردعي ويؤدي إلى تعطيل الهدف منها. ويتوافق نقل الغرامة من وزارة الداخلية إلى الهيئة مع استقلاليتها المكتسبة ودورها الجديد الذي يسمح لها بممارسة صلاحياتها الرقابية على أكمل وجه.
ومن أهمّ التعديلات المقترحة مسألة فوز المرشحّ الذي تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي وأحيل ملفّه إلى المجلس الدستوري بحيث "يسقط حقّه في الترشّح لمرة أخرى". إلّا أنّ الاقتراح لم يحدد بصريح العبارة من هي الجهة المخوّلة بإعلان عدم أهليّة الشخص للترشح، فهل المقصود أن الهيئة بمجرد الانتهاء من تدقيق الحسابات تفرض تلك العقوبة على كل من تبين لها أنه تجاوز سقف الإنفاق القانوني. بالحقيقة إن المقارنة مع التجربة الفرنسيّة قد تكون مفيدة لأن هيئة الإشراف على حسابات الحملات والتمويل السياسي الفرنسية، في حال وجدت إشكاليّة في حسابات الحملات، تحيلها إلى القاضي الانتخابي، أي المجلس الدستوري، والذي يعود له الحق في فرض عقوبة التجريد من حق الترشح لمدّة معيّنة على المرشح الذي لم يقدم بيانه الحسابي أو تخطى سقف الإنفاق أو تم رفض بيانه الحسابي.
من جهة أخرى يكتفي الاقتراح بفرض عقوبة منع الترشح "لمرة أخرى" على الفائزين وكأن المرشح الخاسر الذي تجاوز السقف الانتخابي لا يمكن فرض العقوبة نفسها عليه. ولا شك أن هذا الأمر مستغرب كون جميع المرشحين يوجدون في الأوضاع القانونية نفسها وبالتالي لا بد من المساواة بينهم إذ لا يعقل أن يتمكن المرشح الخاسر من الإفلات من العقاب حيث يعمد إلى تكرار المخالفة في الانتخابات اللاحقة.
كذلك بالنسبة للمرشح الفائز الذي في حال تجاوزه سقف الإنفاق يتوجب إبطال نيابته من قبل المجلس الدستوري الذي يعلن أيضا حرمانه من حق الترشح طيلة مدة معينة ما يؤكد مجددا ضرورة تعديل النص المقترح كي يشير إلى تلك التفاصيل بوضوح.
وفي السياق نفسه كان من الأفضل أن يحدد الاقتراح الفترة التي يمنع خلالها الترشح لا القول فقط بأن ذلك يتم "لمرة أخرى" من أجل تجنب غموض النص. فمن هي الجهة التي تفرض عقوبة منع الترشح وما هو مصير قرارات الهيئة بخصوص البيانات الحسابية المحالة إلى المجلس الدستوري والمتعلقة بمرشحين لم يتم الطعن بانتخابهم وهل كان من الأفضل منح الهيئة صراحة الحق بمراجعة المجلس الدستوري مباشرة والطعن بجميع المرشحين الذين خالفوا واجباتهم القانونية؟ كل هذه الأسئلة لا يجيب عليها الاقتراح.
في الخلاصة، يمكن القول إّن هذا الاقتراح يُدخل إصلاحات هامّة على قانون الانتخابات من دون تعديل جوهره، سواء لجهة تقسيم الدوائر أو لجهة النظام الانتخابي القائم على النسبية والصوت التفضيلي. وهو قد يكون في ظلّ هيمنة أحزاب السلطة على العمل التشريعي، من أفضل ما يمكن تحقيقه انطلاقًا من مقاربة واقعية للأمور.