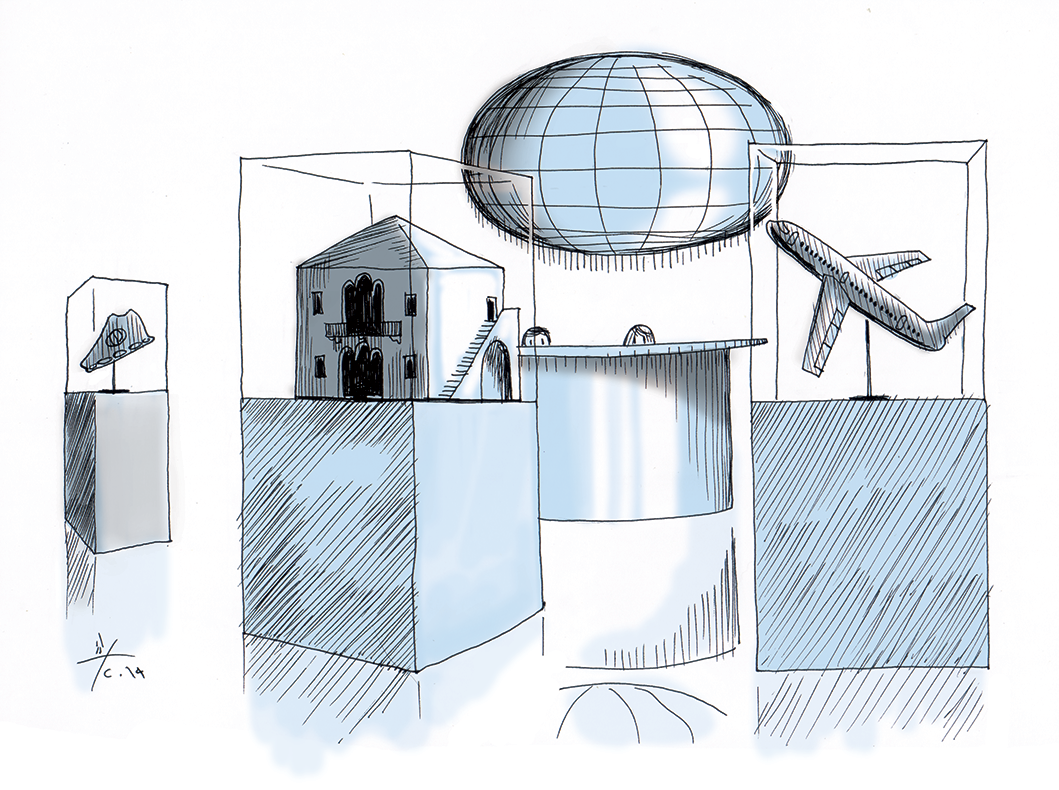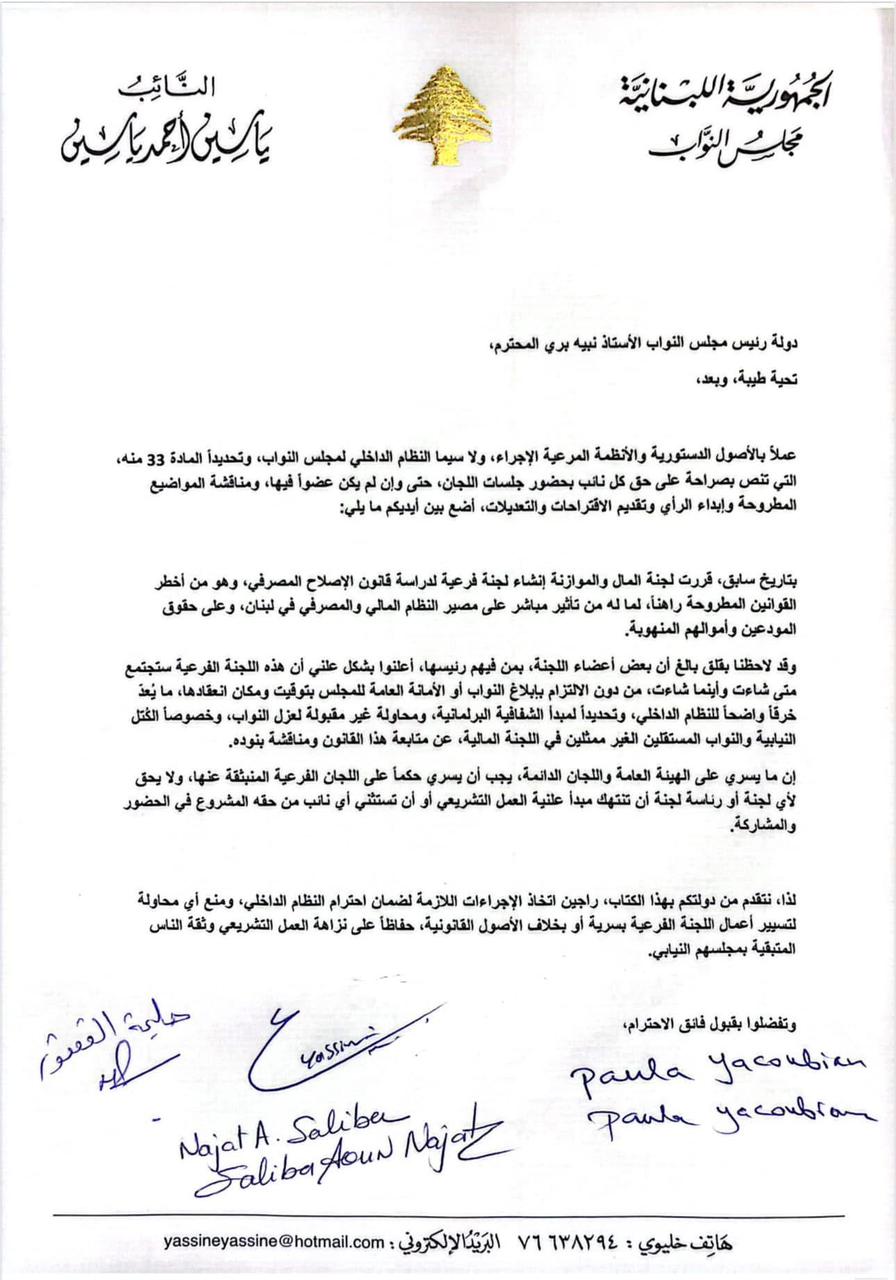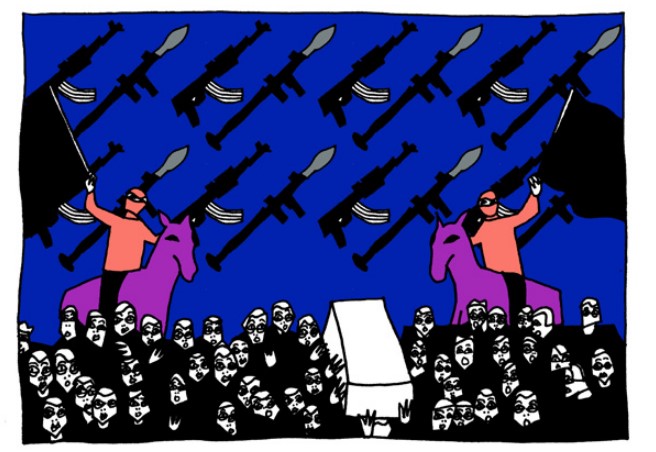اقتراح قانون إنشاء مناطق اقتصادية تكنولوجية: تكنولوجيا للبيع في جزر نيوليبرالية
23/04/2025
تهدف هذه المسوّدة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، غير أنّ تصميمها يصبّ في مصلحة قلّة من المستثمرين العاملين ضمن جيوب مغلقة، يستفيدون من إعفاءات ضريبية وكلفة أجور ومنافع أدنى للعاملين. وبالنتيجة، تُنشئ هذه الصيغة مساراً ريعيّاً فاسداً يُلحق ضرراً بإيرادات الدولة وبحقوق الموظفين وبالتخطيط الإقليمي (تجزئة المناطق). والأسوأ أنّ واضعي السياسات لا يُبدون أيّ اهتمام بتقييم أداء هذه الشركات أو مراقبته للتحقّق من تحقيق الغاية المرجوّة من المنطقة الاقتصاديّة.
منطقة اقتصادية تكنولوجية أم منطقة للتجارة والتصدير؟
المشكلة الجوهرية في المسودة هي التناقض بين الأهداف المعلَنة والأنشطة المشجَّعة. وفي ما يلي ثلاث ملاحظات أساسية
- تنصّ المادة 1، الفقرة 1 على أنّ القانون يرمي إلى «تحقيق النموّ الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات»، إلّا أنّ الحوافز تنحصر في إعفاءات ضريبية وحرمان العاملين من بعض حقوقهم مقابل أنشطة تؤدّي إلى التصدير حصرًا (المادة 32). وفي حين أنّ المناطق الاقتصادية عادةً ما تسعى إلى أهداف اقتصادية عامة كهذه، فإنّ توجّهها السوقي يكون عادةً مزدوجاً؛ داخلياً وخارجياً على حدّ سواء. يمعنى أن إنشاء هذه المنطقة يهدف إلى تحقيق غايات تجارية خارحيّة فقط من دون أن تؤدي إلى إحداث تحوّل في استخدام التكنولوجيا.
- رغم تركيز المسودة على قطاع التكنولوجيا، فهي لا تقدّم أيّ حوافز للبحث والتطوير أو الابتكار أو تطوير البرمجيات، وهي النشاطات التي يفترض أن تكون محور عمل مثل هذه المناطق. كما أنّ المسودة تشجّع على تجزئة المناطق في جيوب منعزلة، متجاهِلةً دمجها في المنظومة الأوسع للاقتصاد الوطني.
- لا تُحدث المنطقة أيّ أثر ارتدادي (Spillover) في الاقتصاد الكلّي، ما يحصر الفوائد بمصالح خاصة على حساب الخزينة العامّة. بينما نجحت مناطق اقتصادية كثيرة عالمياً في تشجيع التجمعات الصناعية والتكامل مع الاقتصاد المحلي ونقل التكنولوجيا، فإنّ النصّ المقترح يكتفي بمتطلّب المحتوى المحلّي في مادة واحدة، وهو غير كافٍ؛ إذ ينبغي لحوافز تنمية المورّدين أن تكون أوضح كما في تجربة متنزّه Penang Science Park في ماليزيا.
المنطقة الاقتصادية جيوب منعزلة
ورد في المادة العاشرة من الاقتراح كما عدلته اللجان المشتركة أنّه يحقّ لأيّ شخص طبيعي أو معنوي يملك أو يستثمر عقاراً أو أكثر ينوي إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بالصناعات التكنولوجية أن يتقدم بطلب الى الهيئة ترفعه الى المجلس الأعلى للبت به وفق الأصول، وعلى أن يحدد بمرسوم موقع وحدود ومساحة المنطقة أو يعدّل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
وعليه، يفتح الاقتراح الباب أمام إنشاء مناطق اقتصادية بالجملة، تكون بمثابة جيوب منتشرة على طول لبنان، من دون أن تترافق مع إنشاء بنية تحتية معينة مشتركة لكل العاملين فيها، الأمر الذي يضعف حظوظ التطوير التكنولوجي ويحدّ منه ويزيد احتمالات استغلال القانون من أجل خلق هذه الجيوب المعفاة من الضرائب وقانون العمل.
واللافت أن اللجان المشتركة كانت عدّلت النصّ الأساسي للاقتراح الذي كان ينص على خلاف ذلك على أن تنشأ المنطقة على أرض عامّة أو خاصّة، عليها مساحات مبنية مجهزة للأنشطة المطلوبة تفوق مساحتها المبنية عشرة آلاف متر مربع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المستند الى توصية الهيئة.
تأبيد الحوافز الضريبية
تُمنح الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية عادةً حوافز ضريبية محدودة الأمد (5–15 سنة) وبصيغ متدرّجة. فمثلاً
- في الهند: إعفاء كامل من ضريبة الدخل لخمسة أعوام، ثم 50% لخمسة أعوام أخرى، فإعفاءات مخفَّضة لاحقا.
- في فيتنام: إعفاء كامل لمدة 4–6 أعوام، يتبعه خفض تدريجي للضريبة.
أمّا المادة 32 من هذه المسودة فتعطي إعفاءات واسعة وغير محدّدة الأجل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وضرائب الاستيراد والتصدير. وهذه الإعفاءات المفتوحة تؤدّي إلى:
- خسائر إيرادات طويلة الأمد للدولة؛
- اعتماد الشركات على الامتياز الضريبي بدلاً من رفع الإنتاجية والتنافسية؛
- غياب المرونة الحكومية في تعديل السياسات وفق المتغيّرات الاقتصادية.
يُضاف إلى ذلك أنّ شروط الأهلية للإعفاءات إشكالية: فالاستثمار الأدنى المطلوب (200 ألف دولار) متدنٍّ جداً، والمادة المتعلقة بنسبة 75% من اليد العاملة اللبنانية لا تُحدّد عدداً أدنى للموظفين، ما يتيح لشركة توظيف أربعة عمال فقط (ثلاثة لبنانيين) وانتفاعها بالإعفاء.
حرمان العمال من أبسط حقوقهم
أبرز ما تميز به قانون انشاء المنطقة الاقتصادية بالنسبة الى أنظمة المناطق الحرة المعمول بها في دول أخرى، هو أنه ذهب إلى منح المؤسسات العاملة في المناطق الاقتصادية إعفاءات من النظام العام الآيل إلى حماية الأجراء (أي إعفاءات من كيس الأجراء)، على نحو يؤدي إلى تعزيز ارتهانهم للقمة العيش، وذلك على غرار ما كان فعله المشرع بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية في طرابلس.
فمن جهة أولى، تمّ إخضاع علاقات العمل بين الأجراء والشركات والمتعلقة بشروط الأجر والصرف من العمل للاتفاقات التعاقدية الناشئة بين الفريقين وتاليا وفقا لقدراتهم التفاوضية ولحاجات العرض والطلب وبكلمة أخرى لحاجات السوق. وهذا يفتح بابا لتجاوز ضمانات أساسية في القوانين الوطنية وعلى رأسها قانون العمل (الحد الأدنى للأجور، تعويض صرف تعسفي، مهلة إنذار، الإجازات على اختلافها.. الخ).
ومن جهة ثانية، وفي توجه لا يقل خطورة، أعفى القانون أصحاب العمل من تسجيل أجرائهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكتفيّا بتحميلهم مسؤوليّة تأمين تقدماتٍ صحية لهؤلاء ولمن هم على عاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق. ويلحظ هنا أن موجب أصحاب العمل تجاه أجرائهم يقتصر على الجانب الصحيّ، مع ما يستتبع ذلك لجهة حرمانهم من سائر الخدمات الاجتماعية وأبرزها التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة. وحتى فيما يتصل بالجانب الصحيّ، فإن نقل مسؤولية ضمان هذا الحق من الصندوق الى أصحاب العمل يعدّ بالواقع انتقاصا هائلا لحقوقهم وأحد المداخل الرئيسة للنظام النيوليبرالي وفقا لأبرز ناقدي هذا النظام. فإذا كان من أهم شروط النيوليبرالية تعميم المنافسة في أسواق العمل مع ما يفترضه لجهة تعزيز مشاعر الأجراء باللا استقرار واللا أمان، فإنها تبدأ في استبدال النظام القائم على التعاضد والتضامن الاجتماعييْن بتنظيمات خاصّة يتولّى إدارتها أصحاب العمل على نحو يعزز تحكمهم بالأجراء. فبذلك، ينفتح الباب واسعا أمام تحديد الحقوق الاجتماعية للأجراء، ليس على أساس نصوص عامة تنطبق عليهم بتساوٍ، بل على أساس حسن علاقتهم مع أصحاب العمل. فأن يصبح صاحب العمل مسؤولاً عن توزيع الحقوق الاجتماعية، فهذا يجعله حكماً مالكاً بأمره، مع ما يستتبع ذلك من أبواب للتمييز ايجاباً وسلباً بين أجرائه، وتاليا لايجاد تنازع وتضارب مصالح فيما بينهم، كل ذلك في دولة يبقى فيها دور القضاء وفاعليته في حماية الطرف الأضعف محدودا.
ويضاف الى كل ذلك، أن نظام المنطقة الاقتصادية فتح الباب أمام توظيف مستخدمين وأجراء عاملين في المنطقة من غير اللبنانيين وإن اشترط أن يكون 75% من العاملين من الجنسية اللبنانية. ومؤدّى ذلك طبعا هو تعزيز حجم المنافسة في سوق العمل هنالك، مع دمج آلية الكفالة بآلية المنطقة الاقتصادية، على نحو يتيح طبعا تراكم آليات التحكّم بالأجراء وما يستتبعها من هشاشة.
التقييم والمتابعة
لا بدّ من مراقبة وتقييم منتظمين لضمان تحقيق المناطق لأهدافها عبر مؤشرات أداء واضحة (مستويات التوظيف، نموّ الصادرات، حجم الاستثمارات، الإسهام الضريبي…). تُراجع السياسات دورياً بناءً على تقويمات مُحكمة، وتُغلق أو يُعاد توظيف المناطق المتعثّرة. لكن المسودة الحالية تفتقد كلّياً إلى باب للمراقبة والتقييم، ما يحول دون اتّخاذ قرارات مبنيّة على أدلة.