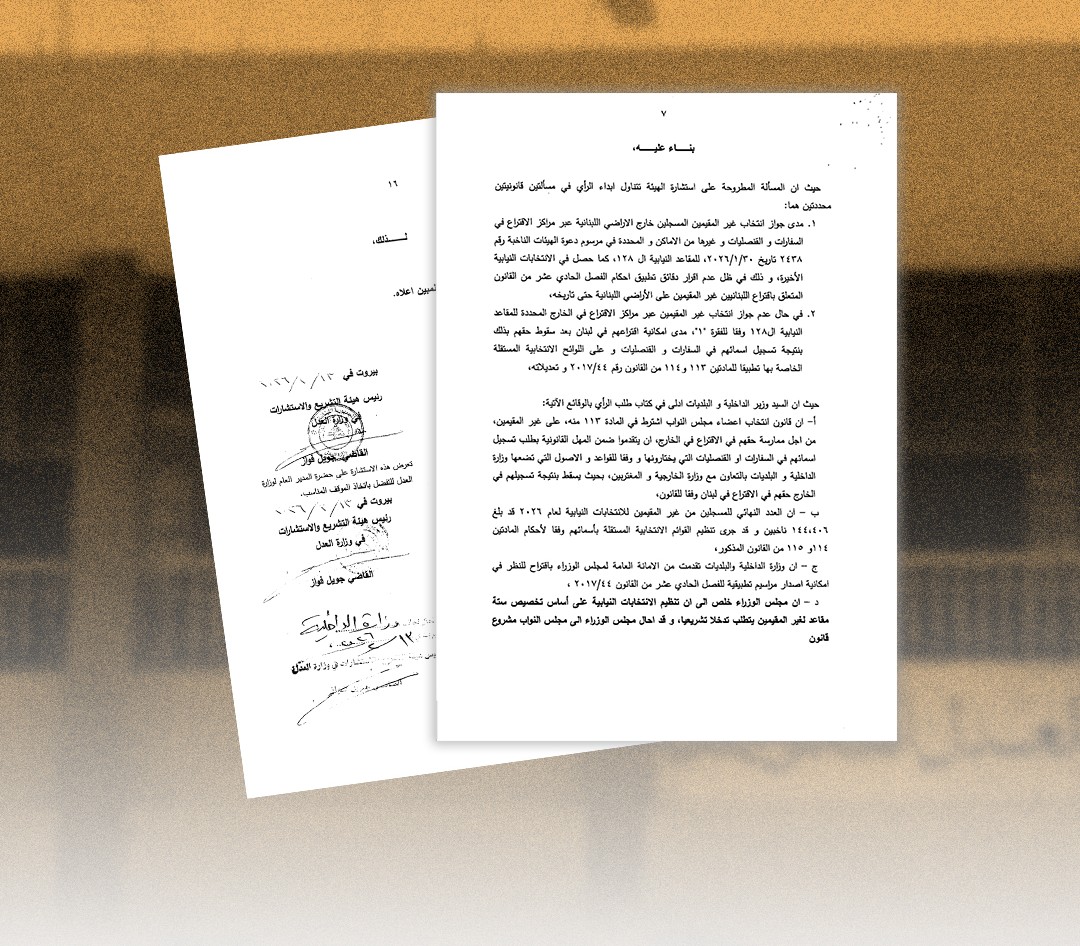تجريم التنمّر في لبنان: وجه آخر من أوجه الاستعراض التشريعي
25/09/2025
تقدّم النائب هاغوب ترزيان في تاريخ 20/08/2025 باقتراح قانون يرمي إلى تجريم التنمّر من خلال إدراجه ضمن الفصل الثاني من قانون العقوبات المتعلّق بالجرائم الواقعة على الحرية والشرف. وبحسب أسبابه الموجبة، يهدف الاقتراح إلى تجريم سلوك التنمّر الذي يشكّل "ظاهرة متنامية تمسّ كرامة الإنسان وأمنه النفسي والاجتماعي"، وبالتالي "حماية الضحايا بشكل فعّال"، وذلك انطلاقاً من التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة، ولا سيّما اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. وأنه يقع على عاتق الدولة "اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية الأفراد، خصوصاً الفئات الهشّة، من جميع أشكال العنف النفسي والجسدي، ومن ضمنها التنمّر".
وفي حين يظهر هذا الاقتراح كاستكمال لمساعي المشرّع اللبناني في معالجة إشكالية التحرّش بمختلف أوجهها، على غرار ما بدأ القيام به سنة 2020 إزاء التحرّش الجنسي (القانون رقم 205)، فيتبعه اليوم بتناول أحد أوجه التحرّش المعنوي (أي التنمّر)، غير أنّ قراءة متأنية لنص الاقتراح تكشف أنّه يقع مجدداً في أخطاء الماضي ويعيد إنتاج سياسة الحلول المجتزأة والاستعراضية بعيداً عن مقاربة شاملة وفعّالة لمعالجة التحرّش عموماً (والتنمّر في الحالة الراهنة) كأزمة اجتماعية مزمنة ومتقاطعة ذات تداعيات اقتصادية وثقافية ونفسية وتربوية. إذ أن الاقتراح يقتصر على ثلاث مواد أساسية فقط (وثلاث أخرى شكلية) تُعرّف التنمّر وتحدّد عقوبته وأسباب تشديدها. وعليه، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
1- تجاهل آليات الحماية في أماكن العمل والمدارس
من اللافت أنّ هذا الاقتراح طُرح بمعزل عن القوانين الأخرى ذات الصلة، ولا سيّما قانون التحرّش الجنسي، وبمعزل عن النقاش العام والدراسات المتعلّقة بالتنمّر تحديداً، لا سيما وسط المؤسسات التربويّة. كما لم يربط الاقتراح نفسه بقانون التحرّش الجنسي، وكأنّه يقارب التنمّر كفعل مستقل عن أفعال العنف والتحرّش عموماً. ورغم الإشارة في الأسباب الموجبة إلى التزامات لبنان الدولية، فإنّ الاقتراح اكتفى بحلّ ظرفي ذي منحى جزائي صرف، متقاعساً عن معالجة الأسباب الجذرية ووضع آليات عملية متكاملة تشمل الوقاية والحماية والمساءلة، وتطوير القوانين القائمة، وفرض مسؤوليات واضحة على أصحاب المؤسسات التربوية أو أماكن العمل أو المنصات الإلكترونية.
فمن ناحية أولى، يتقاعس الاقتراح عن وضع أي موجبات على عاتق أصحاب العمل في شأن مكافحة التنمّر والعنف داخل مكان العمل، مثل تضمين نظام الأجراء الداخلي بنوداً خاصة للوقاية والمعالجة والحماية من أفعال التنمّر (أو العنف المعنوي)، مع ما يستتبع ذلك من مسؤوليات بحقّ الذين يتخلفون عن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية أجرائهم. فضلاً عن ذلك، ورغم إشارة الاقتراح في مادته الرابعة إلى أنّ العقوبة تُضاعف إذا كان للفاعل "سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجني عليه"، فهو لم يحدّد ماهية عقوبة صاحب العمل الذي يُخلّ بموجبه في حماية أجرائه من التنمّر أو العقوبات التأديبية المحتملة على المتنمّر نفسه داخل مكان العمل. وبالعودة إلى القانون المقارن، يتبيّن أنّ المشرّع الفرنسي أوجد موجباً عاماً على صاحب العمل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة بهدف الوقاية من أفعال التحرّش المعنوي (المادة L.1152-4 من قانون العمل الفرنسي). وقد اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أنّ على صاحب العمل موجبَ نتيجة تجاه أجرائه إزاء حماية صحّة وسلامة العاملين في المؤسسة، ولا سيّما في ما يتعلق بالتحرّش المعنوي، وأنّ عدم ثبوت أي خطأ من ناحيته لا يعفيه من المسؤولية (Soc. 21 juin 2006, RDT 2006.245).
ومن المهمّ الإشارة هنا إلى أنّ منظمة العمل الدولية اعتمدت سنة 2019 خلال الدورة المائة والثامنة اتفاقية تحمل الرقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل (C190)، لم ينضم إليها لبنان بعد، رغم إقراره لاحقاً قوانين محليّة بشأن التحرّش قد لا تتوافق وأحكام الاتفاقية المذكورة. وهذه الاتفاقية تعرّف "العنف والتحرّش" في عالم العمل على أنّه مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، والتي تهدف أو تؤدي أو يُحتمل أن تؤدّي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرّش على أساس نوع الجنس. وهي تنطبق على جميع العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل، وفي جميع القطاعات، الخاصة منها أو العامة. وقد تضمّنت الاتفاقية سلسلة من الموجبات على الدول الأعضاء، بما فيها: اعتماد استراتيجية شاملة ترمي إلى تنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرّش ومكافحتهما، ووضع الأدوات، وتوفير الإرشاد والتعليم والتدريب، واستثارة الوعي، وضمان وسائل فعّالة للتفتيش والتحقيق، بما في ذلك من خلال هيئات تفتيش العمل أو غيرها من الهيئات المختصة. وتنص الاتفاقية على مقاربة شاملة ومتكاملة بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة، مع مراعاة قضايا الجنسين ومعالجة الأسباب الكامنة وعوامل الخطر، بما في ذلك الأنماط المتعلقة بالجنسين والأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز وعلاقات القوة غير المتكافئة القائمة على نوع الجنس، باعتبار أنّ هذا الأمر أساسي للقضاء على ظاهرة العنف والتحرّش في عالم العمل. وعليه، كان من الأجدى أن يتوجّه العمل التشريعي نحو المطالبة بانضمام لبنان إلى هذه الاتفاقية أو على الأقل، تطوير القوانين المحلية وتبنّي سياسات تسترشد وتتماشى وأحكامها.
من ناحية أخرى، ورغم ذكر الأسباب الموجبة للاقتراح التزام لبنان باتفاقية حقوق الطفل، فقد تجاهل تماماً فحوى هذه الاتفاقية وتقاعس عن مقاربة إشكالية التنمّر كقضية تطال التلامذة في المؤسسات التربوية تحديداً. فهو لم ينص على أي سياسة وقائية إزاء التنمّر في المدارس، ولم يفرض أي موجبات على المؤسسات التربوية لمكافحة التنمّر والعنف في حرمها. فالمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل تنصّ على أنّ على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية والديه أو الوصي القانوني عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. وقد اعتبرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتّحدة في تعليقها العام رقم 13 الصادر سنة 2011 حول حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف أنّ تعبير "كافة أشكال العنف..." يشمل "تنمّر البالغين أو الأطفال الآخرين على غيرهم وتنكيلهم بهم، بما في ذلك من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مثل الهواتف النقالة والإنترنت (وهو ما يُعرف بـ"التسلط عبر الحواسيب")". كما اعتبرت اللجنة أنّ التدابير التربوية (وهي مسؤولية تمتد الى المؤسسات التربوية) يجب أن تعالج المواقف والعادات والسلوكيات التي تتغاضى عن العنف ضد الأطفال وتحض عليه، وأن تشجع على إجراء مناقشات مفتوحة بشأن العنف، تشمل مشاركة وسائل الإعلام والمجتمع المدني، وأن تدعم المهارات الحياتية للأطفال ومعارفهم ومشاركتهم وتعزّز قدرات مقدمي الرعاية والمهنيين الذين لديهم اتصال بالأطفال. وهو أمر يمكن للدولة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني (مثل المدارس) أن تتخذه، لا سيّما من خلال تمكين الأطفال في مجال اكتساب المهارات الحياتية وتحقيق الحماية الذاتية وفي مجال مخاطر محددة، بما فيها تلك المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وتعزيز علاقات زمالة إيجابية ومكافحة التنمّر بين التلاميذ.
2- الإشكاليات التي تعتري تعريف التنمّر
يعرّف الاقتراح التنمّر على أنّه "كل سلوك عدائي، لفظي أو غير لفظي، يتسم بالتكرار، يصدر عن الجاني من خلال استعراضٍ لقوة أو استغلالٍ لضعف أو لوضع خاص لدى الضحية، يهدف إلى التخويف أو السخرية أو الإقصاء أو الحطّ من الكرامة الإنسانية، أو التسبب بأي أذى نفسي أو اجتماعي، وذلك على أساس الجنس، أو العرق أو الدين، أو الخصائص البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية، أو المستوى الاجتماعي".
إنّ استخدام الاقتراح تعابير فضفاضة مثل "سلوك عدائي" و"استعراض للقوة" و"وضع خاص" في تعريفه لفعل التنمّر الجزائي يخالف مبدأ الدقة في صياغة النصوص العقابية، بما يناقض مبدأي شرعية العقوبات والمساواة أمام القانون. فالقوانين الجزائية هي قوانين الدقة، نظراً لما لها من مفاعيل على الحريّات الأساسية. فما معنى "استعراض القوة"؟ وكيف يمكن لمثل هذا السلوك أن يشكّل ركناً من أركان جرم جزائي تصل عقوبته إلى سنتين حبساً؟ وما هو "الوضع الخاص" المشار إليه في التعريف؟ بل ما معنى وصف سلوك بـ"العدائي"؟ إنّ مطاطية هذه التعابير في النص تفتح مجالاً واسعاً لملاحقة ومعاقبة جملة من السلوكيات التي قد لا ترتقي بالضرورة إلى درجة خطورة تبرّر حرمان فاعلها من حريته الأساسية، أو على العكس، قد تؤدي هذه المطاطية إلى الإفلات من الملاحقة (إذ يجب تفسير القوانين الجزائية تفسيراً ضيقاً لصالح المدعى عليه). وكان من الأجدى إدخال مفهوم "العنف" في التعريف على غرار ما تعتمده الاتفاقيات الدولية ذات الصلة (مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190) أو حتى القوانين اللبنانية (مثل قانون العمل أو قانون العنف الأسري). فما قد يجعل من التنمّر فعلاً يقتضي التصدي له ومحاسبة فاعله هو العنف والضرر الذي يترتب عليه ضدّ الضحية.
من ناحية أخرى، يعدّد الاقتراح الصفات اللصيقة بالضحية التي يتم التنمّر عليها على أساسها تعداداً حصرياً ("الجنس، أو العرق أو الدين، أو الخصائص البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية، أو المستوى الاجتماعي")، وهو بذلك يهمّش جملة من الصفات الأخرى التي قد تُستغل للتنمّر على الأشخاص مثل السنّ أو الجنسية أو الميل الجنسي والهوية الجندرية، وغيرها. وعليه، كان من الأجدى استرشاد المشرّع بالمعايير الدولية ونصوص العهود الدولية التي لا تعتمد التعداد الحصري في مثل هذه الحالات، بل تنهي التعداد بتعبير "أو لأي سبب آخر" لتشمل مروحة أوسع من الصفات التي قد تُستغل للتمييز أو للتنمّر على الأشخاص.
ومن اللافت أيضاً أنّ الاقتراح عرّف التنمّر بمعزل عن روابط السلطة. فهو لا يميّز مثلاً بين أجير وصاحب عمل في حال وقع التنمّر في إطار العمل، ما يطرح تساؤلات حول فعالية النص. فهذا الأمر يفتح باباً واسعاً أمام أصحاب السلطة لاستغلال هذا النص. إذ لم يأخذ الاقتراح في الاعتبار طبيعة بعض العلاقات غير المتكافئة والهرمية، مثل العلاقات في مكان العمل أو في المؤسسات التربوية، وساوى حيث لا يجب، ما قد يؤدي إلى إفراغ الاقتراح من غايته المعلنة، بحيث يمكن أن تُقابل أي شكوى ضد صاحب سلطة بشكوى مضادّة لدحضها أو لدفع الضحية إلى التراجع عن شكواها.
3- هيمنة المنحى العقابي في معالجة إشكالية اجتماعية
يعاقب الاقتراح كل من أقدم على التنمّر بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية تتراوح بين ثلاثة أضعاف وعشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل ضد قاصر أو "إذا كان شخص من ذوي الإعاقة أو على من كان لا يستطيع المدافعة عن نفسه بسبب وضعه الصحي الجسدي أو النفسي أو امرأة بسبب جنسها" (ولعلّ المقصود هنا هو أن إذا ارتكب فعل التنمّر ضدّ هؤلاء، لكن نص الاقتراح لم يحدد هذا الأمر). كما تُضاعف العقوبة "إذا كان له (لعلّ المقصود هو الفاعل وهو أمر لم يذكره نص الاقتراح) سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجني عليه" أو "إذا ارتكب فعل التنمّر شخصان أو أكثر" أو "إذا استُخدمت وسائل إلكترونية أو نُشر المحتوى على الملأ" أو "إذا أدّى التنمّر إلى دفع الضحية إلى الانقطاع عن التعليم أو العمل أو الحياة الاجتماعية".
إنّ تبنّي المشرّع المنحى العقابي حصراً للتصدّي للتنمّر يعكس مقاربة قد لا تتلاءم مع إشكالية اجتماعية مزمنة غالباً ما تنطوي على علاقات هرمية مترابطة. فالاقتراح لا يُعطي أي دور للقضاء المدني أو للمؤسسات التربوية وسلطات الوصاية المعنية أو لمجالس العمل التحكيمية أو للوساطة في قضايا حساسة كهذه. ومن المهم التنويه بأهمية اللجوء إلى وسائل بديلة (وقائية) لحل هذه الإشكالية قبل اللجوء إلى القضاء (ولا سيما الجزائي منه)، نظراً لأهمية المساحة التي تحتلها وجهة نظر الضحية للفعل المقترف من ناحية أولى (فما قد يُعدّ تنمّراً لشخص ما قد لا يُعدّ كذلك لآخر)، ونظراً لأهمية الحفاظ على استقرار العلاقات الاجتماعية، خصوصاً داخل المؤسسات التربوية أو في مكان العمل. فاللجوء إلى القضاء الجزائي مباشرة (مع ما يستتبع ذلك من علنية وتوقيف وعقوبة مقيدة للحرية) قد يغيّب عملياً أي فرضية للمحافظة على بيئة اجتماعية أو بيئة عمل سليمة (أو حتى استمرارية العمل بحد ذاتها). لا بل إنّ توفير طريق جزائية حصرية للتصدّي للتنمّر قد يشكّل رادعاً أمام الضحايا بدلاً من أن يشكل حافزاً لهم وفق ما أسلفته، لا سيّما أنّ الاقتراح لم يحدّد بالمقابل أي آلية لضمان حماية الضحايا والشهود أثناء الملاحقة، خلافاً لما أوجده مثلاً قانون مكافحة الإتجار بالبشر في هذا المجال. فما الذي قد يشجّع الضحايا أو الشهود على التقدّم بدعوى وسط هذا الواقع؟ وما هي حظوظ الحفاظ على بيئة اجتماعية سليمة في ظل نشوء دعوى جزائية بين تلامذة قاصرين داخل مدرسة مثلاً (وهو أمر لم يعره الاقتراح أي اعتبار) أو بين زملاء، أو بين أجير وصاحب عمل؟ إنّ هذا الأمر قد يؤدّي إلى جعل الاقتراح، إن تمّ إقراره، حبراً على ورق يصعب اللجوء إليه للتصدّي للتنمّر، على غرار مصير قانون التحرّش الصادر سنة 2020.
4- إشكالية عبء الإثبات
على غرار ما قام به المشرّع لدى إصداره قانون التحرّش الجنسي سنة 2020، لم يُخفّف الاقتراح الراهن عبء الإثبات عن الضحية، إذ أوجب أيضاً إثبات النية الجرمية لتكوين الجرم. فقد استخدم الاقتراح صيغة النتيجة الحاصلة بدل النتيجة الممكنة أو المتوقعة، مثل: "سلوك […] يهدف إلى التخويف أو السخرية أو الإقصاء..." بدلاً من "قد يؤدّي إلى..." أو "ينجم عنه...". وهذا الأمر يحتّم على الضحية إثبات النية الجرمية، وهو أمر غالباً ما يصعب إثباته في قضايا التحرّش عموماً (الجنسي أو المعنوي، مثل التنمّر). ولهذا السبب خفّف المشرّع في القانون المقارن عبء الإثبات على الضحية معتمداً أحرف التوقع (مثل "قد") في توصيف نتائج الفعل. فهذا ما اعتمده المشرّع الفرنسي مثلاً لدى تعريفه للتحرّش المعنوي في مكان العمل (المادة L.1152-1 وما يليها من قانون العمل الفرنسي)، وهو ما يتماشى مع مقاربة محكمة التمييز الفرنسية التي تعتبر أنّ "التحرّش المعنوي لا يقتضي إثبات أي نيّة للإضرار" (Soc. 10 nov. 2009) وأنّه في قضايا العمل "بمجرّد أن يقدّم الأجير المعني وقائع تسمح بافتراض وجود تحرّش، يقع على عاتق الجهة المدعى عليها، استنادًا إلى هذه المعطيات، إثبات أنّ هذه الأفعال لا تشكّل تحرّشًا وأنّ قرارها مبرَّر بعناصر موضوعية لا علاقة لها بأيّ تحرّش" (Soc. 24 sept. 2008). وعليه، كان من الأجدى أن يتبنّى الاقتراح الراهن الأسلوب نفسه.