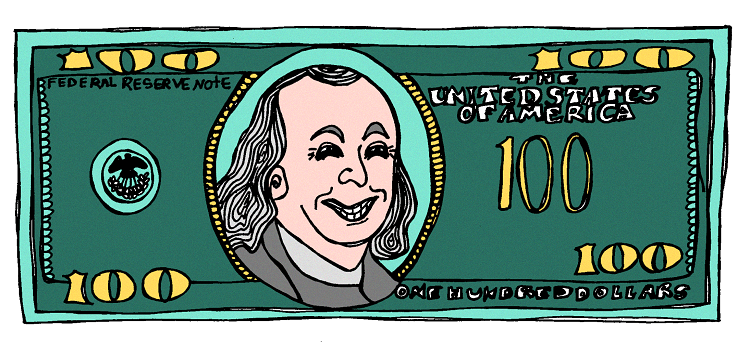
ملاحظات حول مشروع قانون "الفجوة": أبعد من المحاسبة المتعثّرة
08/01/2026
ما أن أقرّت الحكومة في تاريخ 26/12/2025 مشروع قانون تحت عنوان: "مشروع القانون المتعلّق بالانتظام المالي واسترداد الودائع"، حتى انطلقت اعتراضات شديدة ذهبت في اتجاهات متناقضة.
فمن جهة أولى، أعابتْ جمعيّة المصارف والهيئات الاقتصادية وعدد من جمعيات المودعين على القانون المقترح أنه أعفى الدولة من أية مسؤولية رغم ارتباط أزمة الودائع بأزمة العجز في الموازنة والخلل في إدارة مصرف لبنان أو بما درجت جميعة المصارف على تسميته بأزمة نظامية. وقد رأى هؤلاء مجدّدًا أن الحلّ يكمن في بيع الدولة أصولها بما فيها الذهب طالما أن الودائع تعدّ حقوق ملكية غير قابلة للتصرف أو الشطب. وبشكل أعمّ، التقتْ هذه الاعتراضات مع مجمل الطروحات المقدمة سابقًا ومنها طروحات الأحزاب الثلاثة الكبرى (القوات والتيار الوطني الحر وحركة أمل) والتي ذهبت كلها إلى ما أسميناه "تسليع لبنان".
وعلى نقيض هذا الاتّجاه، أعابتْ قوى إصلاحيّة وجمعيّات مودعين آخرى على القانون المقترح أنّه بمثابة عفو عامّ لصالح المصارف وعلى حساب المودعين. وقد رأوا أن مشروع القانون يوازي في خطورته ما انتهت إليه السلطة السياسية في أعقاب حرب 1975-1990 بفعل قانون العفو العام. فكما حصل آنذاك، ثمة عملية نهب كبرى حصلت، وسيتعيّن على المجتمع أن يتجاوز هذه العملية على مضض فيما يحسن المستفيدون منها مواقعهم بفعل الثروات التي حققوها بمنأى عن أيّ حساب. وقد رأى هؤلاء أنّ لا مجال لإعادة الانتظام المالي من دون استعادة ثقة المواطنين وهو أمر يصعب حصوله من دون تفعيل عمل المحاسبة ودولة القانون وأن هذا الأمر إنما يشكل الطريق الأساسي وربما الوحيد لردم الفجوة المالية أو على الأقل الجزء الأكبر منها. وغالبا ما استند هؤلاء إلى النموذج الإيسلندي الذي وصفوه بالنموذج الناجح الذي أعاد الثقة لدولة إيسلندا. وقد ذهب بعض هؤلاء إلى الدعوة إلى إقرار اقتراح قانون يهدف إلى تعيين محقّق ماليّ خاصّ جزائيّ من قبل الحكومة، يناط به صلاحية التحقيق في "الانتهاكات القانونية من أي نوع كانت التي حصلت في القطاع المصرفي بما في ذلك مصرف لبنان والوزارات المعنية والمصارف التجارية وشركات التدقيق المالي"، وإصدار القرارات الظنية أو الاتهامية في هذه القضايا.
وبين هذين الاتجاهين، سجلت اعتراضات كثيرة على قابلية القانون المقترح للتنفيذ أو عدالة التوازن الذي يقوم عليه.
من جهتها، دعت الحكومة بلسان رئيسها نواف سلام المواطنين كافة إلى إجراء قراءة متأنيّة للقانون المقترح "بشفافية كاملة، وبشكل وافٍ، ودون أي وسيط" بما "يبدّد الكثير من سوء الفهم وعدداً من الالتباسات، ويقينا جميعًا من التسرّع وإطلاق الأحكام الجازمة، ومنها ما يكشف عن آراء مسبقة جرى الترويج لها منذ أسابيع".
وبالفعل، فإنّ التدقيق في القانون المقترح وأسبابه الموجبة يعطي بعض الإجابات على كثير من الاعتراضات، ويؤدّي في مطلق الأحوال إلى تنسيبها. فاستباقًا للاتّهام بالمسّ بحقّ الملكية، ارتكز النصّ على القرار الصادر عن المجلس الدستوريّ في تاريخ 3 تشرين الأول 2025 والذي شرّع إمكانيّة تقييد الودائع وإن وضع ضوابط عدّة لتجنّب الإساءة في استخدام هذا الحقّ. وعليه، فإن الاعتراض انطلاقا من قدسيّة حقّ الملكيّة هو اعتراضٌ سبق وأن دحضه المجلس الدستوري في قرار "له قوة القضيّة المقضيّة" بحقّ الجميع erga omnes. وبات من المملّ تكراره مع التعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود. ومن الأسلم تاليّا هنا التحرّي عن مدى التزام مشروع القانون بالضوابط التي نص عليها قرار الدستوري، وتحديدا فيما إذا كان تقييده للودائع تم مع مراعاة مبدأيْ التناسب أو الضرورة بدل التكرار الببغائي لكلام لم يعد يقدّم ولا يؤخّر. إذ من المسلم به أنّ من شأن فتح باب التقييد أن يؤدّي إلى انهيار نظام الحقوق المضمونة برمّته في حال التعسف به وتطبيقه من دون أي ضوابط.
الأمر نفسه يتصل بالاعتراض القائم على أن القانون المقترح إنما يشكل عفوا عاما مقنّعا ويناقض دولة القانون، حيث أنه على العكس من ذلك وضع آليات ومهلا لاستكمال التدقيق الجنائي على مصرف لبنان والمصارف، كما أكد في عدد من مواده أن ما يقرره من تعويضات يجدر بالمستفيدين من الأعمال غير المنتظمة دفعها لا يحول إطلاقا دون ملاحقتهم وإلزامهم بتسديد تعويضات إضافية بقرارات قضائية. بمعنى أنّه إذا صحّ أنّ القانون المُقترح لم يَنبنِ على نتائج التّدقيق والمُحاسبة ولم يعلّق نفاذ أيٍّ من أحكامه عليها كما كان يُفترض أن يحصل مثاليّا، فإنّه بالمُقابل لم يتضمّن أيّ تنازل عن وجوب التدقيق الجنائيّ أو المحاسبة. علاوة على ذلك، فإن الجردة التي تضمّنها بشأن 7 أنواع من العمليات غير النظامية، إنما شكلت إدانة فعلية لممارسات كان لها أثرٌ كبير على الانتظام المالي، أهمها الهندسات المالية وتهريب الودائع قبل وبعد 17 تشرين الأول 2019 وتسديد القروض بالدولار أو تحويل العملة بالليرة إلى الدولار بأسعار صرف غير حقيقيّة. ويستشفّ من كلّ ذلك أنّ ما أراده القانون المُقترح هو المضيّ قدمًا في ضمان أقصى ما يمكن توفيره من حقوق المودعين من دون التريّث إلى حين استكمال عملية التدقيق والمحاسبة على أن يكون للحكومة ومصرف لبنان تخفيف القيود على حقوق المودعين (من دون جواز تعزيزها) على ضوء ما تتوصّل إليه عملية التّدقيق والمحاسبة. فكأنّما الحكومة صمّمت مقترحها ليس على أنّه يحدّد بصورة نهائيّة حقوق المودعين أو وضع المصارف، بل على أنّه محطّة أولى حدّدت فيها الحد الأقصى من القيود المفروضة على المودعين والحدّ الأدنى من المحاسبة، على أن يبقى الانتقال إلى محطّة أخرى تخفّف فيها القيود على المودعين أو تتعزّز فيها نتائج المحاسبة أمرًا محبّذًا ومطلوبًا، بدليل وضعها مهلا لاستكمال التّدقيق الجنائي، وهو انتقال من المفترض حصوله في حال نجحت الدولة ومعها المجتمع في ردم فجوة اللامحاسبة.
بمعنى أن النص ليس وثيقة جامدة إنما وثيقة قابلة للتطور في اتجاه زيادة ضمانات المودعين وتعزيز المحاسبة بصورة دينامية. وفي الواقع، يجد خيار الحكومة هنا ما يفسّره في ممارسات تعطيل القضاء والتدخّل في أعماله والتي حصلت طوال سنوات بدعم كامل من قوى سياسية وازنة ومهيمنة على البرلمان والحكومات السابقة والاستفراد بكل قاضٍ على النحو الذي شهدناه بالعين المجرّدة، وبهدف منع أيّ محاسبة جديّة للمصارف. من هذه الزاوية، بدا خيار الحكومة في المضي قدما قبل تحديد واقع الفجوة المالية بصورة دقيقة وكأنه يتأتى من واقع لا يقلّ صعوبة وقوامه وجود فجوة أكبر في العمل المؤسساتي والقضاء. ففي ظل واقع كهذا، قد يبدو شرط استكمال التدقيق والمحاسبة قبل وضع أصول إعادة الانتظام المالي، على بداهته، بمثابة شرط تعجيزي أو مطلب حقّ يُراد به باطل وهو إجهاض إمكانية هذا الهدف بصورة مطلقة. وليس أدلّ على ذلك من أن بعض الذين يتحدثون اليوم عن وجوب استكمال التدقيق والمحاسبة، هم كانوا في صدارة القوى المعطلة للمحاسبة. ومن هذه الوجهة، وإذ يشكل وضع القانون المقترح قبل إنهاء أعمال المحاسبة إقرارا بحجم الجهود وطول الوقت التي تتطلّبه، فإنه يتميّز عن قانون العفو العام بأنه لم يشكّك أبدًا بمشروعيّتها والأهم لم يتنازل عنها مطلقًا. وهنا، ومع تفهّمنا الكلّي بأن يشكّل القانون المقترح لحظة تأسّف على فشل أعمال المحاسبة وضعف مؤسسات الدولة، فإنّه من الحرّي أن نفصل بين تقييمنا لنظام المحاسبة والذي ورثته الحكومة ويتطلب إصلاحه وتجاوز عوائقه جهدا كبيرا ووقتا طويلا، وتقييمنا لمدى تناسب الإجراءات المتخذة من الحكومة في كيفية تعاملها مع واقع الودائع والمصارف، ليس فقط على ضوء الفجوة المالية بل أيضا على ضوء الفجوة في عمل المؤسسات. وعليه، نرى هنا بدل تحميل القانون المقترح ما لا ينسجم مع أحكامه، قد يكون من المفيد أكثر النظر في تفاصيل التوازنات التي انبنى عليها والأهم مدى احتوائه على أحكام كافية لضمان دينامية النص وقابليته للتطور.
وهذا ما سنحاول مناقشته على طول هذا المقال، في سياق تقييم القانون المقترح. وقبل المضي في ذلك، ثمة ضرورة في التوقف عند المرجعية المبدئية التي انبنى عليها والتي تمثلت في قرار المجلس الدستوري، على نحو سيخوّلنا لاحقًا تقييم مدى انسجامه مع هذه المرجعية والضوابط التي وضعتها.
المرجعيّة المبدئيّة والضوابط
كما سبق بيانه، استبقت الحكومة اتهامها بالمسّ بقدسية الودائع من خلال الاستناد إلى قرار المجلس الدستوري في تاريخ 3 تشرين الأول 2025 في الطّعن المتصل بقانون إصلاح وضع المصارف، والذي أجاز للمشرّع تقييد حقوق المودعين بهدف إعادة الانتظام المالي ضمن ضوابط معيّنة. وعليه، وإذ استبعد القرار مجمل الحجج التي أثارتها الجهة الطاعنة (كتلة لبنان القوي) لجهة قدسيّة الملكيّة الخاصّة وعدم جواز تخفيض أو تحويل الالتزامات تجاه المودعين عملًا بالمادة 15 من الدستور، فإنّه أتى مُنسجمًا مع التوجّه الحديث للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في اتّجاه تمكين المشرّع من الموازنة بين حماية الودائع والحفاظ على النظام العام الماليّ. وقد تمثّل هذا التوجّه بشكل خاص في قضيّة "ماماتاس وآخرون ضد اليونان" (2016) وفي الدليلٍ الذي نشرتْه هذه المحكمة في عام 2022 حيث جاء صراحةً "أنّ تدخّل الدولة عبر فرض تدابير مقيّدة للملكيّة وترمي إلى تخفيض الدين العام، مبرّر طالما أنّها تسعى إلى هدف مشروع قوامه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإعادة هيكلة الدين العام في سياق أزمة اقتصادية خطيرة" (بند 442 من الدليل).
وقد اعتبرت المفكّرة في سياق تعليقها على قرار الدستوري أنّه ينسف ما انتهى إليه قرار مجلس شورى الدولة في تاريخ 6/2/2024 في دعوى جمعية المصارف ضد الدولة، والذي ذهب إلى حدّ التسليم بأن لودائع المصارف لدى مصرف لبنان قدسية الملكية الخاصة أسوة بسائر الودائع وأنّ على الدولة تسديد مجمل هذه الودائع من دون أي انتقاص، وهو القرار الذي كانت جمعية المصارف قد اعتبرته انتصارًا لها وتأكيدا على صحة مطالبها بوجوب بيع أصول الدولة وأملاكها ومؤسساتها من أجل إعادة الودائع. ولم تنسَ المفكرة آنذاك التنديد بباطنيّة خطاب التقديس. فعدا عن أن جمعية المصارف ومصرف لبنان نشطا في عمليات "قصّ الشعر" على أشكالها منذ بدء الأزمة، بلغ سوء استخدام "القدسية" أوجّه حين تبنتها جمعية المصارف في معرض دفاعها عن ودائعها لدى مصرف لبنان، وهي الودائع التي تكوّنت في إطار الهندسات المالية لقاء فوائد خيالية وهي الهندسات التي كان لها الدور الأكبر في الانهيار الشامل. وعليه، فإن كل ما تثيره جمعية المصارف ليس إلا استعادة لهذا الخطاب.
وبالواقع، فإن قرار الدستوري لم يدحض فقط حجج جمعية المصارف وشورى الدولة، إنما أتى نقيضا لتوجّه مهيمن انخرطت فيه الكتل السياسية الكبرى (القوات اللبنانية وحركة أمل ولبنان القوي) قوامه أن الحل الوحيد لمعالجة الأزمة المالية هو بيع أملاك الدولة وقد تترجم هذا الخطاب المهيمن في اقتراحات القانون التي قدمتها تباعا والتي أسمتها المفكرة آنذاك مقترحات "تسليع لبنان".
وعليه أملت المفكرة في سياق تعليقها على قرار الدستوري أن يُعاد تركيز الجهود في اتجاه بدء نقاش حقيقي حول الحلول المنطقية والعادلة لمسألة الودائع وكيفية توزيع الخسائر وذلك في إطار مشروع القانون المنتظر بشأن "الانتظام المالي واسترداد الودائع" بعيدًا عن لغة التّقديس والتشويش.
وقد أحاط المجلس الدستوري بالواقع توجهه بثلاثة ضوابط:
أولًا، أن يحصل تقييد الودائع بهدف الحفاظ على المصلحة العامة. وقد رأى أن المشرّع التزم بهذا الشرط عند وضعه قانون إصلاح المصارف طالما أنه هدف إلى "تعزيز الاستقرار المالي ومعالجة التعثّر وحماية الودائع في عملية التصفيّة والإصلاح والحدّ من استخدام الأموال العامة في عمليّة إصلاح أي مصرف متعثر" كما هدف إلى "الموازنة بين الحفاظ على الانتظام العام الاقتصادي والمالي للدولة من جهة وحماية الودائع من جهة أخرى"،
ثانيا، أن لا يتم تقييد الودائع على نحو يؤدّي إلى إفراغها من جوهرها. وبالطبع، الإفراغ من الجوهر عبارة قابلة للتفسير، لكن يفهم منه أنه لا يقتضي أن ينتهي تقييد الوديعة إلى نكران الحقوق الناشئة عنها بالكامل،
ثالثا، أن يبقى التقييد متناسبًا مع الغاية التي يريد القانون تحقيقها. وقد رأى المجلس الدستوري أن التناسب متحقق في قانون إصلاح المصارف طالما أنه أدرج أصحاب الودائع في أسفل سلمّ تراتبيّة توزيع المسؤوليّات وتحمّل الخسائر.
وعليه، وفيما بدت الحكومة محصّنة بالقرار الدستوري والمبدأ الذي نص عليه، فإنه يبقى أن مشروع القانون الخاص بمعالجة الفجوة يتطلب مزيدًا من التحري، طالما أن الحكومة لم تكتفِ هنا بترتيب الأولوية في تحمل الخسارة، بل ذهبت إلى تحديد القيود على الودائع المختلفة. وهذا الأمر إنما يتطلّب البحث فيما إذا كان تحديد القيود قد أتى مراعيا لمبدأيْ التناسب والضرورة، وفيما إذا لم يكن من الممكن تحقيق الغاية مع فرض قيود أقلّ صرامةً وكلفةً على المودعين. كما يتطلّب البحث فيما إذا كانت الحكومة قد راعتْ جوهر الحقّ المتمثل في الودائع ووزعت الخسائر بصورة مبرّرة.
الفجوة المالية
الشّرط الأول لإثبات الضرورة هو إثبات وجود فجوةٍ كبيرة يصعب ردمُها وفق الآليّات الاعتياديّة. إلا أنه حتى اللحظة، لا يوجد تقييم دقيق للفجوة، بل مجرّد تخمينات تقريبية بفعل عدم استكمال التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان وعدم مباشرة أيّ تدقيق جنائي بحقّ المصارف وخصوصًا الكبرى منها، خلافًا لتوصيات صندوق النقد الدولي. وفيما كان يفترض من الناحية المبدئيّة أن تتريّث الحكومة في وضع تصوّرها النهائي لاستعادة الانتظام العام حتى استكمال عمليات التدقيق الجنائي، فإنّها اعتبرت أن ثمة مؤشرات جدية على حجمها مؤثرة أن يكون تحديدها جزءًا من مسار قانون إعادة الانتظام المالي وليس شرطًا مسبقا لوضعه. وهذا ما نقرأه في المادة 4 منه التي وضعت مهلًا لإنجاز التدقيق الجنائي على مصرف لبنان والمصارف. وبذلك، تكون الحكومة قد تجاوزت الحاجز التقني المتمثل في عدم تحديد الفجوة، لتسارع إلى معالجة غيابه بجعله أحد أهم أهداف القانون المقترح. ويجد هذا الخيار كما سبق بيانه ما يفسّره في وجود مخاوف جدية من استمرار الممانعات القوية إزاء إنجاز التدقيق الجنائي، مما قد يطيل أمد الأزمة من دون تحديد أيّ أفق للخروج منها أو اتخاذ أي إجراءات عملية لتخفيف الضرر الذي يتكبده المودعون. وهذا ما يتلاقى مع ما قلناه في المقدمة لجهة أن الحكومة وضعت قيودا على المودعين في حدّها الأقصى وفرضت محاسبة بالحد الأدنى، في موازاة الإعراب ضمنا عن أملها في أن يولّد قانونها المقترح ديناميّة تُسهم في التخفيف من القيود وفي توسيع دائرة المحاسبة. وهذا ما يتحصّل من المادة 8 من القانون المقترح التي خوّلت مصرف لبنان بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء تقديم الاستحقاقات من دون أن يكون له تأخيرها. ولكنه يجد أيضا ما يفسّره في تضمين القانون أحكامًا من شأنها تقليص الفجوة وتحديدا الأحكام المتصلة بالعمليات غير المنتظمة، مثل إبطال الفوائد المستحقّة منذ 2016 أو أيضا تجميد الودائع المشبوهة أو فرض تسديد تعويضات على تهريب أموال أو على تسديد قروض أو على تحويل ودائع من الليرة إلى الدولار وفق أسعار صرف غير حقيقية أو أيضا تحديد دين مصرف لبنان على الدولة.
ومع تفهّم مضيّ الحكومة في هذا الاتّجاه، يبقى أنّه كان بإمكانها تحصين نصّها من خلال مجموعة من التدابير، تؤكّد التزامها التامّ بحصر أيّ تقييد لحقوق المودعين بحدود الضرورة.
فمن جهة أولى، كان يجدر بالنصّ أن يضيف فقرة عن تبعات تحديد الفجوة بعد استكمال أعمال التدقيق الجنائي وفيما إذا كان من شأنه أن يبرر تخفيفا للقيود المفروضة على المودعين، بمعنى أن يكون تقييم هذه النتيجة إجراءً إلزاميًّا وليس فقط إمكانية متروكة للحكومة ومصرف لبنان.
ومن جهة ثانية، كان يجدر بالنص أن يضع آليّة أكثر فعاليّة في تحديد الودائع المشبوهة، طالما أنه سيكون بإمكان الدولة مصادرة الجزء الأكبر من هذه الودائع مع ما يستتبع ذلك لجهة ردم جزء مهم من الفجوة. ومن هنا، كان يفترض أن تتولى لجنة الرقابة على المصارف المسؤولية الأساسية والمباشرة في إجراء التحقيق في هذه الودائع بعدما تمّ رفع السرية المصرفية عنها، من دون انتظار القوائم التي يفترض بالمصارف أن تزودها بها. إذ من المعلوم أن المصارف توجد في أغلب الحالات في وضع تضارب مصالح، طالما أنها قد تكون اقتبلت هذه الودائع وأدارتها طوال سنوات مع الأشخاص المعنيين بها من دون أن تبلغ عن أيّ شبهات لديها. فما عدا ما بدا؟ وما الذي سيدفع المصارف الآن إلى الكشف عن هذه الودائع التي تستّرت طوال سنوات على مصادرها. هذا مع العلم أن على النص القانوني هنا أن يميز بين الودائع المشبوهة عموما والودائع المشبوهة لمسؤولين سابقين أو حاليين في دول أجنبية. ففيما تقبل الودائع الأولى المصادرة لصالح الخزينة العامة مع ما يستتبع ذلك من نتائج حسابية، فإن الودائع الثانية قد تكون موضع مطالبة دول أخرى ويقتضي توخّي الحذر في التسرّع في حسمها من الفجوة المالية.
ومن جهة ثالثة، يرشح النصّ عن تساهلٍ كبير مع فئات من المودعين الذين استفادُوا من عمليّات ماليّة غير منتظمة، وتحديدا الذين حولوا أموالا إلى الخارج في مختلف فئاتهم أو الذين أوفوا قروضًا تجاوزت 750 ألف د.أ وفق أسعار صرف متدنيّة أو أيضًا المساهمين وكبار موظفي المصارف الذين حوّلوا أنصبة أرباح إلى الخارج بدءًا من العام 2016. ويتحصّل ذلك من تكليفهم بتسديد تعويض قدره 30% فقط من الكسب الذي حققوه، وإن ترك النص للقضاء إمكانية إلزامهم بتسديد المبالغ كاملة. وفيما وضع النص على الفئات الأولى والثانية (السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية إلى الخارج) وجوب تسديد "التعويض" خلال مدة 3 أشهر فإنه بالمقابل سخا أكثر على الفئتين الأخريين مكلفا إياهم بوجوب تسديد التعويض المتوجب عليهم خلال 5 سنوات، من دون وضع تواريخ استحقاق ولو أجزاء منه قبل انتهاء المدة. ولئن نص القانون المقترح على حسم الفوائد المحتسبة، فإنه بالمقابل لم يوجب على الذين تقاضوا هذه الفوائد وحولوها إلى الخارج ردّها كليا أو جزئيا.
ولكن، هنا يجدر من أجل تحصين النص، أن يشار صراحة إلى أنه يتعين تخصيص أيّ تعويض إضافي يحكم به في مواجهة أيّ من المستفيدين من الالتزامات غير القانونية في الحساب المخصّص لتسديد الودائع.
ولا نفهم بالمقابل لماذا تمّ إلغاء جميع الفوائد فيما كان يقتضي الاكتفاء بإلغاء ما يشكّل فائدة فاحشة. ومن المفيد في هذا المجال استعادة ما ورد في اقتراح القانون المقدّم من النائب فراس حمدان في تاريخ 13/2/2023 والذي أعدّته لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، لجهة تعريف الفوائد الفائضة.
من يتحمل مسؤوليّة ردم الفجوة؟
أمرٌ آخر أساسيّ في القانون المذكور وهو كيفيّة توزيع الخسائر بين مختلف الأطراف المعنيّة. وهنا نسجل ملاحظات عدة:
أولا، إن الأسباب الموجبة للقانون المقترح تبقى خالية من سرديّة واضحة للمجريات التي أدّت إلى الأزمة. لا بل أن ما ذهب إليه النصّ يبدو من زوايا عدّة غير منسجم مع مُندرجاته، وبخاصّة لما يتّصل بحجم المسؤولية التي تتحملها المصارف. إذ أن جلّ ما ورد في القانون المقترح "أن السياسات النقدية والمالية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان، وتدهور قيمة العملة الوطنية، أدت مجتمعة إلى تراجع أصول مصرف لبنان من حيث جودتها وقيمتها الاقتصادية. وقد نتج عن ذلك تراجع قدرة مصرف لبنان على تغطية التزاماته -التي تمثل بصورة رئيسية- ودائع المصارف العاملة في لبنان ومستحقاتها". بالمقابل، لم تردْ أيّ كلمة عما كشفه تقرير شركة ألفاريز ومارشال ولا أيّ كلمة عن عجز الموازنة أو الهندسات المالية واشتراك المصارف وعدد من كبار المودعين فيها ودورها في انهيار القطاع برمّته أو عن شلل أعمال التدقيق والمحاسبة.
ثانيا، إنه من البين أن توزيع المسؤوليات عن الخسائر إنما يندرج في سياق مسعى لوضع آلية قانونية بديلة عن الآلية الاعتيادية، تكون أكثر ملاءمة للواقع الشاذّ الذي صنعه مصرف لبنان بالشراكة الكاملة مع المصارف وأدّى إلى إيداع أكثر من 80% من مجموع الودائع لدى مصرف لبنان. ومن المهمّ شرح ذلك تفصيلًا ليكون واضحًا أن تقييد الودائع إنّما يشكّل رغم مفاعليه السلبية، إجراءً مخفّفًا عن ضياعها الذي كان من الممكن أن ينجم عن التطبيق الاعتياديّ لقواعد إفلاس المصارف. وعليه، إن ما قد يبدو من زاوية معيّنة تقييدًا للودائع، إنما يبدو من زاوية أخرى إنقاذًا لها.
ثالثًا، إن المسؤوليّة التي تتحمّلها الدولة هي ذات طبيعة مزدوجة. فإذا كان من الصحيح أنها تتحمّل مسؤوليّة قانونيّة ناجمة عن إخلال مؤسّساتها العامة عن ضمان حقوق المودعين وسلامة القطاع المصرفي، من جراء سوء أداء إحدى مؤسساتها (مصرف لبنان) وضعف الرقابة على المصارف، فإنها تتحمل مسؤولية إضافية تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية ومسؤوليتها في ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها المتصلة بغايات التغطية الصحية أو الخدمات التعليمية. ومن شأن هذه المسؤولية الإضافية أن تبرر تحمل الدولة مسؤولية أكبر في ضمان تسديد جزء من الودائع (حتى 100 ألف د.أ) ولكن أيضا مسؤولية في ضمان تسديد ودائع مخصصة لضمان حقوق أساسية أيّ الودائع "الجدير بالحماية" أكثر من غيرها وفقا لطبيعتها وحتى ولو كانت تتجاوز ال 100 ألف د.أ. (مثلا الودائع العائدة لمؤسسة تعليميّة أو عامة أو بلدية أو نقابة مهنية أو صندوق تعاضد أو ضمان اجتماعي أو جمعية لا تبغي الربح ذو صفة منفعة عامة مهما بلغت قيمتها).
والواقع أنّ القانون لم يوضح أبدًا لا مصدر مسؤوليّة الدولة ولا النسبة التي تتحمّلها من الخسائر. بل أن القانون المقترح ترك الباب مفتوحا أمام تحميلها مزيدًا من المسؤوليّة على أساس أسناد قانونيّة ضعيفة. فهو من جهة أوحى بصورة مستغربة أن دين الدولة تجاه مصرف لبنان ليس محدّدا فيما أنه يفترض أنه كذلك. وأكثر ما نخشاه هنا هو أن يعكس إبقاء هذا الدين مبهمًا نية في أخذ إدعاء سلامة بوجود دين ليس هنالك عليه أي وثيقة في حسابات الدولة على محمل الجدّ. وبما لا يقل خطورة، هو تضمين القانون احتمال تحمل الدولة مسؤولية قانونية إضافية على أساس المادة 113 من قانون النقد والتسليف. والواقع أنّ هذا الموقف يتعارض مع مضمون نصّ المادة نفسها الذي يتحدّث بوضوح ومن دون لبس عن العجز الحاصل في نتائج سنة بعينها، بما يتماشى مع أصول المحاسبة العموميّة، حيث تتقرّر موازنة الدولة سنة فسنة في قانون يصدر عن مجلس النوّاب، بعد التثبّت من الخسارة الحاصلة في حسابات مصرف لبنان. بمعنى أنّه يتعيّن على الدولة وفق هذا النصّ سدّ العجز في موازنة مصرف لبنان سنة فسنة ضمن الموازنة السنوية العامّة. أما أن تستخدم هذه المادة لسد خسائر غير معلنة وبصورة رجعية، فهو أمر يتعارض تمامًا مع أصول المحاسبة العموميّة ويعرض كيان الدولة للخطر. وما يزيد من حدة هذه المخاوف هو أن مجلس شورى الدولة كان اقتبل هذه الحجة في قراره المشار إليه أعلاه، محملا الدولة وجوب سد مجمل خسائر مصرف لبنان (فجوة 60 مليارًا كما جاء في القرار).
أخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه يبقى واجبا على الدولة في سياق تحديد مسؤوليتها في إعادة الانتظام العامّ، أن توفّق بين هذه المسؤولية وسائر مسؤولياتها سواء في ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية أو ضمان حسن إدارة المرافق العامّة أو حماية الوطن وأيضا ضمان حقوق الأجيال القادمة. إذ أن التزام الدولة بتأمين حق الصحة أو التعليم كما التزامها بحماية الإرث الوطني الجامع (وضمنها الأملاك العمومية) لا يقلّ أبدا عن مسؤوليتها في ضمان تسديد الودائع.
رابعًا، إن مسؤولية المصارف تقتصر على تسديد 40% من متوجّبات المرحلة الأولى (تسديد قيمة 100 ألف د.أ) و20% من متوجّبات المرحلة الثانية بالنسبة لأرصدة الودائع التي تتجاوز 100 ألف د.أ. وهذا الأمر يعني أن مسؤوليّتها حدّدت بالحدّ الأدنى خلافًا للمبادئ القانونية المعمول بها والتي تجعلها المسؤولة الأولى تجاه المودعين على أن تكون المسؤوليّات الأخرى استلحاقيّة فقط ومن دون أن يؤخذ دورها في الهندسات الماليّة والتسبّب بالأزمة بصورة أكبر. وما يعزز من قابلية توزيع المسؤوليات على هذا الوجه هو خلو القانون المقترح من تبعات عدم ايفاء المصارف بالمتوجّبات المفروضة عليها.
خامسًا، لئن يؤدي القانون المقترح إلى التفريق بين الودائع لجهة تقييدها وفق قيمتها، فإنه بالمقابل يبرئ أصحاب الودائع من أية مسؤولية في تحمل الخسائر. وهذا الأمر يتعارض مع تعريف الهندسات المالية حيث جاء أنها "عمليات التبادل النقدية والمالية التي تمّت بين المصارف العاملة في لبنان ومصرف لبنان، من جهة، وبين العملاء والمصارف المذكورة من جهة أخرى، والتي نتج عنها أرباح غير اعتيادية وبدون سبب أو مبرّر اقتصادي". ففيما يجعل هذا التعريف فئات من المودعين الكبار، وخصوصًا الذين قدموا رساميل في إطار الهندسات المالية، في حال شراكة فعلية مع المصارف، يجدر أن ينعكس هذا الأمر على مسؤولية هؤلاء في تحمل جزء من الخسارة (فقدان جزء من أصل ودائعهم) من دون الاكتفاء بحسم الفوائد الناتجة عنها. فمن الطبيعي أن تنتهي هذه الشراكة الاستثمارية في عملية غير منتظمة إلى تحميل هؤلاء جزءًا من الخسارة، لا أن يتم التعامل معهم وكأنهم يتمتعون بنفس الحمايات الممنوحة لسائر المودعين. وفي الواقع، من المنطقي أن يتحمل عمومًا كبار المودعين جزءًا من الخسارة، انطلاقا من الطابع الاستثماريّ لودائعِهم، بما يميزها عن الودائع المتوسطة أو الصغرى.
تقييد الودائع
أخيرًا، ذهب القانون إلى تقييد استعادة مجمل الودائع، وإن ميّز فيما بينها لجهة تواريخ استحقاقها وفق قيمتها (وتحديدا فيما إذا كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو كبيرة جدا). وهنا، يثور ثلاثة أسئلة لمعرفة إذا كانت القيود مبرّرة قانونا: (1) هل التمييز بين الودائع وفق قيمتها يجد ما يبرره في النظام القانوني؟ و(2) هل يؤدي التقييد الحاصل إلى المس بجوهر الحق. و(3) هل ثمة طرق أخرى لإعادة الانتظام المالي من دون تقييد الودائع؟
وبالإجابة على السؤال الأول، كانت المفكرة قد أشارت في سياق تعليقها على قرار المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه إلى أنه قد أقرّ إمكانية تراتبية بين الودائع على وفق مسؤوليتها في تحمل الخسائر، وهو الأمر الذي تجلّى في قبوله التمييز بين "ودائع كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة…" و"الودائع الائتمانيّة من مؤسسات مالية" من جهة وسائر الودائع المحمية وغير المحمية من جهة أخرى، معتبرا أنها تتناسب مع الغاية منه والتي هي وفق ما جاء في القرار "الموازنة بين الحفاظ على الانتظام العام الاقتصادي والمالي للدولة من جهة وحماية الودائع من جهة أخرى". إلا أن ما يذهب إليه القانون المقترح هنا يبدو مختلفا: فالتمييز هنا لا يتصل بالتمييز بين الودائع على أساس تراتبية مفترضة في تحمّل أصحابها المسؤولية عن الخسائر طالما أن التمييز يحصل بين ودائع تعود لأشخاص لا صلة لهم لا بإدارة المصارف ولا بملكيتها، إنما بالتمييز على أساس تراتبية في الجدارة في حماية القانون. فلئن حدد استحقاق الودائع الصغيرة ب 4 سنوات، حدد استحقاق الودائع المتوسطة ب 10 سنوات ليحدّد من ثم استحقاق الودائع الكبيرة والكبيرة جدا تباعا ب 15 و20 سنة. وفيما يسوغ تبرير هذا التمييز باعتبارات العدالة الاجتماعية، فإن الإشكال هنا يتأتى أن معيار التمييز الوحيد المعتمد يقوم على قيمة الوديعة، من دون أي اعتبار للغاية منها. وهذا ما كانت المفكرة القانونية دعت مرارًا إليه مبرزة أهمية النظر ليس فقط في كيفية إجراء توزيع عادل للخسائر، بل أيضا في مدى جدارة الودائع بالحماية، بما يمهّد لمنح الوضعية الفضلى للودائع الأكثر جدارة بالحماية، ومنها الودائع المخصصة لضمان حقوق أساسية كصناديق الضمان الصحي.
أما الإجابة على السؤال الثاني، لجهة فيما إذا مسّ النص من جوهر الودائع، فإن الجواب الذي قد يبدو بديهيا هو النفي، طالما أن القانون المقترح ذهب إلى ضمان تسديد أصل الوديعة بالكامل، بما يتجاوز ما يتطلبه عمليّا هذا المعيار.
أخيرا، نصل إلى السؤال الثالث ومفاده هل ثمة طرق أخرى أقل كلفة لإعادة الانتظام المالي؟ وهو سؤال يطرح علينا بالواقع مجددا نفس الأسئلة التي كنا طرحناها في مستهل هذا المقال، بشأن أهمية استكمال التدقيق والمحاسبة من أجل استعادة الأموال المنهوبة وتاليا ردم جزء من الفجوة. وفيما تفهّمنا في بداية المقال أن تكون الحكومة قد اختارت عدم التريّث إلى حين تجاوز كل العقبات التي شلت عملية التدقيق والمحاسبة حتى اليوم، فإن هذا التوجه يفقد الكثير من مشروعيته في حال لم يترافق مع ديناميّات وآليّات تعلن من خلالها الحكومة ليس فقط عدم تنازلها عن التدقيق والمحاسبة أو أملها في تعزيزهما، بل عن إصرارها على إحراز تقدّمٍ في شأنهما مع اتخاذها إجراءات عمليّة لاستيلاد دينامية حقيقية في هذا المجال، سواء في متن النص نفسه أو في إجراءات ومقترحات تتبناها بالتزامن معه. وقد يكون من بينها اتخاذ خيارات فعليّة مستلهمة من التجربة الإيسلنديّة كما سبق بيانه. يبقى أنّ تحصين القانون المقترح لجهة التزامه بشرطيْ التناسب والضرورة يتطلب فضلا عن ذلك التوسع في الأسباب المُوجبة للقانون وإعادة النظر في الأحكام المتصلة بردم الفجوة أو توزيع المسؤوليات على النحو الذي فصّلناه على طول هذا المقال.


