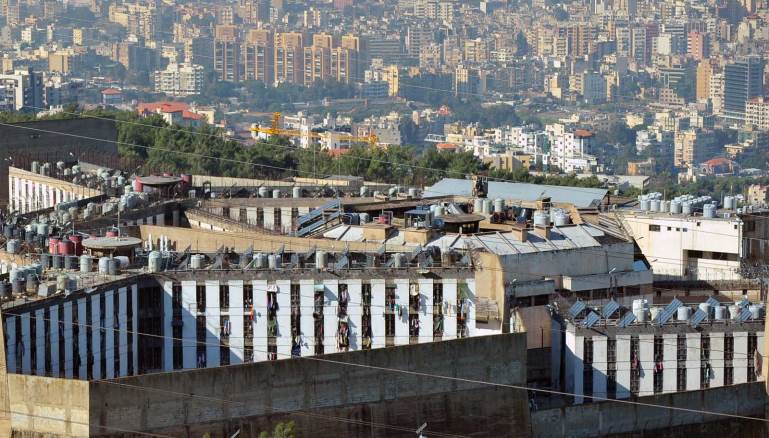كتلة الاعتدال تقدم اقتراحًا معدلًا للعفو العام: اختزال العدالة الانتقالية بتفريغ السجون
03/01/2025
تبعًا لمُلاحظات "المفكرة القانونية" على المسودة الأولى لاقتراح العفو العام وتخفيض العقوبات، عاد بعض نوّاب كتلة الاعتدال الوطنيّ ليقدّموا مع نوّاب آخرين نسخة منقّحة عنه. وفيما استجاب التنقيح لبعض ملاحظات المفكّرة، فإنّ هذه الاستجابة حصلتْ بشكل خاصّ على صعيد صياغة الأسباب الموجبة من دون أن تؤدّي إلى أيّ تعديلٍ جوهريّ في المضمون. فلئن أعابتْ المفكّرة على كتلة الاعتدال أنّها لم تضمّن اقتراحها أيّ تبريرٍ واضح لمنح العفو العامّ بما يخالف مبدأ المساواة أمام القانون، استحضرت الكتلة "مفهوم العدالة الانتقاليّة" لتبرير اقتراحها الجديد. والمفاجئ أن مجمل سرديّة الاقتراح للدعوة إلى العدالة الانتقالية تمحورت حول اكتظاظ السجون وطول أمد التوقيف الاحتياطيّ ومعاناة السجناء التي "يعجز اللسان عن وصفها"، وبخاصة تبعًا للأزمة الاقتصادية. وعليه، تابعت الأسباب الموجبة أنّ أوضاع السّجون الكارثيّة أدّت إلى زيادة الحقد بين السّجناء وأهاليهم على الدّولة نتيجة ظلمها وتقصيرها، مما يُوجب رفع الظّلم عنهم والتّخفيف من مشاعر الحقد بما يمهّد لاستعادة ثقتهم بمؤسّسات الدولة.
ومن دون التّقليل من خطورة أوضاع السّجون أو من الخلل في أعمال المحاكم، يبقى أنّ ثمّة بونًا شاسعًا بين هذه المسبّبات والأحكام التي انتهى إليها الاقتراح والتي تمثّلت في منح عفو شبه شامل. هذا فضلا عن أنّ الاقتراح انتهى إلى تشويه مفهوم العدالة الانتقالية. فعدا عن أنّه حصرهُ في مسألة اكتظاظ السّجون والإخلال في عمل المحاكم، فإنه اختزله بآلية العفو العامّ، من دون أن يترافق مع أيٍّ من الآليّات المُلازمة له سواء لجهة إثبات الحقائق وتحقيق مُصالحات فعليّة وإنصاف الضّحايا أو أيضًا إصلاح مؤسّسات الدولة. وعليه، يبقى الاقتراح كما هو بحاجة إلى إنضاج كي يتواءم مضمونه مع أهدافه، بما يجعله شفّافا ومبرّرا، فضلا عن وجوب التخلّي عن اجتزاء مفهوم العدالة الانتقالية واختزاله وربما عن استخدامه في حال كانت وضعية لبنان لا تسمح حاليا إجراء أيّ عدالة انتقالية جدّية.
وقبل المضيّ في درس الاقتراح، تجدر الإشارة إلى أنه تمّ تقديمه من قبل نوّاب الاعتدال محمد سليمان ووليد البعريني وعبد العزيز الصمد وأحمد الخير، وقد انضم إليهم النواب بلال الحشيمي ونبيل بدر وعماد الحوت وعبد الرحمن البزري.
في تفصيل ما تضمّنه الاقتراح المعدّل
سنعمد أولًا إلى تفصيل مضمون الاقتراح. وفيما يجدر بداية توضيح ما هي الجرائم التي استفادت من العفو العام أم تمّ استثناؤها منه، يجدر التنبيه إلى أن أغلب فقراته اتّصلت كما مسودة الاقتراح السابق بتنظيم أوضاع الذين تمّ استثناؤهم من العفو العامّ، سواء لجهة تخفيض العقوبات التي حُكم عليهم بها أو لجهة تخفيض مدّة مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها أو لجهة وضع حدّ أقصى لمدة التوقيف الاحتياطي. وفيما بدا أن هذه الأحكام تهدف إلى التخفيف من استثناء جرائم من منحة العفو العام من خلال منحها ما أمكن تسميّته عفوًا عامًّا مخفّفا، فإن التدقيق فيها يظهر أن بعضها هو في الواقع مرادفٌ للعفو العامّ الكامل أكثر مما هو عفو عامّ مخفّف. بمعنى أن الاقتراح يعطي باليسرى ما يرفض منحه باليمنى.
هذا ما سنحاول تفصيله في هذا المكان.
العفو العام الكامل
أول ما نلحظُه هنا هو أنّ الاقتراح عاد ليكرّس مبدئيّة العفو العامّ عن الحق العامّ، بمعنى أنّ الجريمة تعدّ مُعفاة كما ورد في فقرته الأولى إلا إذا استثناها الاقتراح صراحة من منحة العفو العامّ. ومؤدّى هذا التوجّه هو منح العفو العامّ لأيّ جريمة لم ترد ضمن قائمة الاستثناءات (وعددها 9)، حتى ولو لم يرد في الاقتراح أو أسبابه الموجبة أي سبب أو مبرّر لذلك. وما يفاقم من ذلك هو أنّ العديد من بنود الاستثناءات تضمّنت مفاهيم عامة تقبل المنازعة بشأن ما تشمله أو لا تشمله كما نبيّن أدناه عند النظر في كلّ منها على حدة، علما أن الشكّ يفسر في هذه الحالة لصالح إسقاط الملاحقة.
وقبل المضي في التدقيق في قائمة الاستثناءات، لا بدّ من ملاحظة تمهيدية قوامها أنّ العفو العامّ يشمل وفق ما جاء في المسوّدة مجمل الجرائم الحاصلة قبل "نفاذ القانون" وضمنًا الجرائم التي لم تحصل بعد أو ستحصل في الفترة الفاصلة بين إقرار الاقتراح في مجلس النوّاب ونشره في الجريدة الرسمية (وهي فترة قد تصل إلى أسابيع). وفي حين لفتت المفكرة نظر كتلة الاعتدال إلى خطورة هذا البند الذي يؤدي عمليا إلى تشجيع ارتكاب جرائم حاصلة مسبقا على براءة ذمّة، فإنّ الكتلة أبقتْه ممّا يؤشّر إلى إصرارٍ منها على منح براءة ذمّة مسبقة، وهي براءة ذمّة يصعب طبعًا ربطها بأوضاع السّجون أو المظالم فيها بل لا مبرر لها إلا التساهل مع إرادة جرميّة ما.
ولكن ما هي الجرائم المُستثناة من العفو العامّ والتي وصفها أحد مقدّمي الطّعن على أنّها الجرائم التي لا يمكن التساهل معها؟
هي الآتية:
- القتل العمد أو القصد بحقّ المدنيين أو العسكريين، سواء صدرت فيها أحكامٌ أو لم تصدر بعد. ومن البيّن أنّ هذا الاستثناء يتأتّى ليس فقط من خطورة هذه الجريمة، ولكن أيضًا وربّما بالأخصّ من ضرورة مراعاة حساسيّة الجيش إزاء منح العفو العامّ للجرائم المرتكبة ضد عناصره، مما قد يؤدي إلى إسقاط حرمته والتشجيع على تكرار جرائم من هذا النوع. يبقى أن استثناء جرائم القتل هنا لا يشمل محاولات القتل، والتي لا تقلّ خطورة عنها.
- الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي. ويتأتّى هذا الأمر من أهمية وخطورة الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، بدءًا بجرائم الاغتيال السياسي وانتهاء بتفجير المسجديْن في طرابلس والمرفأ، مرورًا باختطاف موسى الصدر ورفاقه. ومع فهم ضرورة مراعاة الحساسيّات التي تثيرها هذه القضايا، إلا أنّه يبقى أن الأسباب الموجبة لم تشِر قط إلى أن المجلس العدلي معطّل منذ قرابة سنة بعد فقدان أحد أعضاء هيئته وفشل محاولة تعيين بديل عنه.
- جنايات المخدّرات في حال وجود أكثر من ملاحقتيْن قضائيتيْن، أو أكثر من حكميْن قضائييْن، وفي حال تعدد الملاحقات بحقّ الشخص نفسه، يُستثنى من منحة العفو في حال صدر بحقّه أكثر من حكميْن مبرميْن بجنايات المخدرات. والواقع أنّ البند يتميّز بغموضه. فماذا إذا كان هنالك ملاحقة وحكمان؟ أو ملاحقتان وحكم واحد؟ أو ملاحقتان وحكمان؟ فهل يستفيد الشخص المعني إذاك من العفو أم لا؟ وما يزيد من قابلية هذا الاستثناء للانتقاد هو اعتماد هذا المعيار (تعدّد الملاحقات أو الأحكام) لتصنيف الفعل من دون أي اعتبار لخطورة الأفعال موضوع الملاحقة، كأن يكون المدعى عليه قائد عصابة مسلحة مثلا.
- جرائم التعدّي على الأملاك العمومية والمال العام. وهنا نلحظ أن الاقتراح اختلف هنا عمّا كان ورد من قبل في المسودة الأولى والتي بدت أوسع وأشمل وأقلّ قابلية للتأويل. فقد كانت المسودة قد نصّت على استثناء "جرائم التعدي على الأموال والأملاك العمومية أو الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو البلديات، بما فيها العقارات المتروكة المرفقة والعقارات المملوكة ملكية جماعية (المشاعات)، وأموال المؤسسات العامة وأملاكها وسائر المرافق العامة لا سيما المشمولة في المادة 32 من قانون موازنة عام 2020". فإلام يشير انحسار الفقرة على هذا النحو؟ وهل يشمل تعبير المال العام الأملاك الخصوصية للدولة؟ وهل يشمل أملاك وأموال المؤسسات العامة وفي مقدمتها مصرف لبنان والبلديات والمرافق العامة؟ وأخيرا، من الواضح نية إخراج التعدي على المشاعات أو العقارات المتروكة المرفقة من قائمة الاستثناءات. وكلها أسئلة فتح تعديل العبارة مجالا للتأويل بشأنها.
- قانون مكافحة الفساد في القطاع العام رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020. وهنا نصل إلى قمة الضبابية لجهة الجرائم التي يشملها هذا الاستثناء. ولئن تؤدي مراجعة تعريف الفساد وفق هذا القانون إلى توسيع دائرة الأفعال المستثناة (الأفعال التي تعدّ فسادا وفق الاتفاقيات التي وقع عليها لبنان)، يهمّ هنا التنبيه إلى أنّ الإشكال الأساسي يتأتّى من حدود موضوع هذا القانون وهي حدود القطاع العام. وعليه، وإذ يحتمل أن تبقى أفعال استغلال السلطة ضمن الجرائم المستثناة، بالمقابل يفسّر هذا النص على أنه يستثني من الاستثناء مجمل أفعال الفساد في القطاع الخاص، مثل عمليات تبييض الأموال أو التهرب الضريبي أو الإفلاس الاحتيالي أو تهريب الأموال من الدائنين أو الاحتكار أو مخالفة موجب تسليم القضاء معلومات مصرفية… إلخ. وعليه، ستستفيد المصارف من مروحة واسعة من العفو، من دون أن يكون لاكتظاظ السّجون أيّ صلة بذلك، طالما أن أيّا من مدراء المصارف لم يعرف طعمها. كما قد يتمكن رياض سلامة من الاستفادة من العفو في حال الأخذ بدفاعه والذي ما فتئ يروج له والمتمثل بأن العمولات التي تقاضاها من خلال شركتي أوبتيموم وفوري، إنما تقاضاها من القطاع الخاص وليس من القطاع العام. وإذ يسجّل إيجابا أن الاقتراح استثنى قانون الإثراء غير المشروع، فإنه يبقى مهما ذكر الجرائم الأبرز التي تستثنى من العفو العام منعا لأي تأويل أو التباس.
- قوانين الغابات والثروة الحرجية وحماية الغابات والمحميات والصيد البرّي والصيد البحري وكل الجرائم الواقعة على البيئة. وهنا أيضا نعجب من الصياغة المعتمدة والتي تذكر الاعتداء على الغابات وجرائم الصيد لتعود وترمي "كل الجرائم الواقعة على البيئة" في عبارة واحدة من دون أن تخص بالذكر أيّا منها. فكأنما مقدّمي الاقتراح ليس لهم أي دراية لا بالقوانين البيئية ولا بالجرائم التي تنهش البيئة، والتي تتراوح من تلويث الماء والهواء لتصل إلى تفجير الجبال كما يحصل في المقالع. وهنا أيضا تفتح الصياغة الباب للتأويل. فهل يعدّ استثمار مقلع من دون الحصول على ترخيص وفق القانون جريمة مستثناة أم لا؟ وهل يعدّ التخلف عن وضع دراسة أثر بيئي قبل الشروع في تنفيذ مشروع جريمة مستثناة أم لا؟ وما إلى ذلك من أسئلة تطول. ولكان من الأفضل تقليصا للجدل أن يعتمد مفهوم الجرائم المنصوص عليها في أيّ من القوانين البيئية،
- الجرائم التي يتّخذ فيها المتضرر صفة الادعاء الشخصي ما لم يتمّ الاستحصال على إسقاط الحقّ الشخصيّ بموجبها أو بسقوط الحق الشخصي للأسباب المحددة قانونا أو بأداء قيمة التعويضات الشخصيّة المحكوم بها أو المطالب بها فتُمنح عندها منحة العفو العامّ عن هذه الجرائم. ولئن يشكّل ربط العفو العام بالادّعاء الشخصي في الظاهر ضمانة لإنصاف الضحايا والأشخاص المتضررين، فإنه بالمقابل خيار محفوف بالمخاطر طالما أنه ينقل في الكثير من الأحيان سلطة العفو العام من الدولة إلى المدّعين الشخصيين. ومن شأن ذلك أن يستتبع مخاطر عدة سواء لجهة التمييز بين المدعى عليهم والمحكوم عليهم في الجرم نفسه وفق إرادة المدّعين الشخصيّين أو قدرتهم على الاستجابة لمطالبهم. كما من شأنه أن يتحوّل إلى أداة ضغط على المدّعين لإرغامهم على التنازل عن حقوقهم بعدما أعلنت الدولة تنازلها مسبقا عن الحقّ العامّ وإن علقته على إسقاط الحق الشخصي. وليس أدلّ من ذلك من انتهاج المصارف تدابير قمعية بحق أي عميل لديها تجرأ على مداعاتها. هذا فضلا عن أنه يبقى للمحكوم عليه إمكانية إطفاء الدعوى العامة ضدّه من خلال إيفاء التعويضات المحكوم بها لصالح المدعي الشخصي، مما يؤدي إلى إبراء ذمته. هذا فضلا عن أن هذا الأمر سيفتح جدلا واسعا أمام المحاكم بشأن قبول صفة الادّعاء الشخصي، حيث يصبح قبول هذه الصفة حائلا دون العفو العام فيما يشكّل رفضها بابا له. وكدلالةٍ على أهميّة ذلك، من المهمّ هنا التّذكير برفض قاضي التّحقيق في بيروت قبول صفة الدولة في مداعاة رياض سلامة في قضية عمولات أوبتيموم.
يضاف إلى ذلك بصورة إيجابية استثناء القوانين المتعلقة بالآثار.
إلا إنه وبالإضافة إلى الإشكالات التي أبديْناها أعلاه بشأن قائمة الجرائم المستثناة من العفو العام، فإن الإشكال الأكبر يتصل بكمّ من الجرائم التي يصعب إيجاد أي مبرّر لاستثنائها من هذه القائمة. فكيف نفسّر مثلا عدم استثناء جرائم الحرب (تدمير المنازل والقرى، التهجير القسري…) أو الإرهاب وجرائم التعذيب والإتجار بالبشر والإخفاء القسري فضلا عن كل جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال والإفلاس الاحتيالي المشار إليها أعلاه؟ ويشار في هذا الخصوص أن الاقتراح حذف استثناء كان ورد في المسودة وشمل أجد جرائم الإرهاب والذي يتمثل في استخدام أو صنع أو اقتناء أو حيازة أو نقل موادّ متفجرة أو ملتهبة داخل الأراضي اللبنانية أو منتجات سامة أو محرقة أو أجزاء تستعمل في تركيبها أو صنعها أو تفجيرها بهدف القيام بأعمال إرهابية. ومن شأن حذف هذا الاستثناء أن يؤدي عمليا إلى إسقاط الملاحقة ضدّ المسؤول الاستخباراتي السوري السابق علي مملوك على خلفية التآمر في قضية سماحة.
كما يلحظ أن الاقتراح آثر لزوم الصمت إزاء العمالة لإسرائيل في اتجاه يستشفّ منه إرادة في العفو عنهم مواربة من دون الإعلان عن ذلك.
ومجرد استذكار هذه الجرائم التي لم ترد ضمن الاستثناءات إنما يؤكّد سوء التوجه التشريعي الذي يقوم على مبدئية العفو العام. وتتأكد خطورة هذا التوجه بالنظر إلى أصول التفسير المعتمدة في الإجراءات الجزائية والتي تفرض تفسير الاستثناءات بصورة ضيقة واعتماد التفسير الأكثر مراعاة لحقوق المدعى عليه عند الشك في استفادته أو عدم استفادته من العفو العام.
العفو العام المخّفف أو الموازي؟
لم يكتفِ مقدّمو الاقتراح بالعفو العام والذي ورد بالصورة الشاملة. بل أضافوا إلى العفو العام منحا بإمكان المدعى عليهم أو المحكوم عليهم في الجرائم المستثناة الاستفادة منها. ولئن بدت هذه الإضافات بمثابة تخفيف للعفو العامّ، فإن التدقيق فيها يظهر أنها وضعت في أغلب الأحيان على قياس أشخاص بعينهم، بهدف الحصول على نتائج مماثلة للعفو العام من دون البوح بذلك. وهذا ما دفعنا إلى عنونة هذا المقطع "العفو العام المخفّف أو الموازي". وقبل المضي في تفصيل هذه الإضافات، يلحظ أنها سعت لتعميم الاستفادة من القانون على جميع الفئات التي صدرت بحقها أحكام وجاهية أو غيابية أو ما تزال موضع محاكمة. ولم تنسَ الإضافات معالجة أوضاع المحكوم عليهم بأحكام عدة.
وأهمّ هذه الإضافات هي الآتية:
- تخفيض العقوبات المحكوم بها: هذه الإضافة تعني بشكل خاصّ المحكومين وجاهيّا. ورغم ورود سبعة اقتراحات لتخفيض العقوبات المحكوم بها منذ 2020، فإن ما تميّز به الاقتراح هو أنه نصّ على أكبر تخفيض لعقوبات المؤبّد والإعدام، حيث خفضها إلى 15 سنة سجنية (أي ما يعادل 11 سنة وثلاثة أشهر فقط). فمن قبل، بقيت التخفيضات عموما بحدود 20 سنة سجنيّة بالنسبة إلى المؤبد وبحدود 25 سنة سجنيّة بالنسبة إلى الإعدام.
كما عمد اقتراح القانون إلى تخفيض سائر العقوبات بحدود ثلثها، ومؤدّى ذلك عمليا هو اعتبار الحكم بسنة حبس مرادفا للحكم بستة أشهر فقط، وهو التوجه الذي يلتقي مع عدد الاقتراحات المقدمة حديثا بشأن تخفيض السنة السجنية، أحدثها عهدا الاقتراح المقدّم في 19/11/2024 من نواب تكتل الاعتدال والاقتراح المقدم من النائب إيهاب مطر في تاريخ 29/05/2023.
ومن شأن ذلك أن يؤدي عمليا إلى اعتبار خدمة العقوبة تامة بالنسبة إلى العدد الأكبر من الإسلاميين بما فيهم المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام، والذين بدأ احتجازهم قبل آخر أيلول 2013. وهذا ما سيفيد بشكل خاصّ المعتقلين تبعا لمعركة نهر البارد (2007) وعبرا (حزيران 2013).
- تخفيض مدة مرور الزمن على العقوبات: هذه الإضافة تعني بشكل خاص المحكومين غيابيا (أو الذين يعتبرون بحكم الفارين من العدالة) وقوامها تخفيض مدة مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها من عشرين سنة فعلية (وهي المدة المنصوص عليها في القانون الحالي) إلى 15 سنة سجنية بالنسبة إلى عقوبة الإعدام (أي فقط 11 سنة وثلاثة أشهر) و10 سنوات سجنية بالنسبة إلى عقوبة المؤبد (أي فقط 7 سنوات ونصف) و5 سنوات سجنية بالنسبة إلى العقوبات الجنائية الأخرى (أي فقط ثلاث سنوات و9 أشهر). وعليه، سيكون بإمكان الفارين من العدالة المحكوم عليهم غيابيا أن يبرئوا ذممهم في حال انقضاء هذه المدّات القصيرة نسبيا. ويسجل هنا أن الاقتراح يشكل سابقة في استخدام تخفيض مرور الزمن على العقوبات حيث لا نجد اثرًا لها في مجمل الاقتراحات المقدمة سابقا والتي ذهبت إلى منح عفو عام كامل أو مخفف. ومن أبرز الذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من هذه الإضافة الفارون من العدالة في قضيتي نهر البارد وعبرا.
- وضع حدّ أقصى للتوقيف الاحتياطي: هذه الإضافة تعني بشكل خاص الأشخاص الذين يستمر توقيفهم ولمّا تكتمل محاكمتهم بعد، وبخاصة الأشخاص المتهمين في جنايات مستثناة من سقف التوقيف الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما هي حال الأشخاص المتهمين بجرائم الإرهاب أو القتل أو المحالين إلى المجلس العدلي إلخ... وتنصّ هذه الإضافة على اعتماد قاعدة استثنائيّة قوامها وجوب إخلاء سبيل المدعى عليه حكمًا، في كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا القانون والتي لم تصدر أحكام فيها، وفي حال تجاوزت مدة التوقيف 12 سنة سجنية (أي عمليا 9 سنوات فعلية). ويبدو أن المحفّز لوضع هذه المادة هو ضمان إطلاق سراح الشيخ أحمد الأسير الذي تم احتجازه في آب 2015، ولما يزال يحاكم في قضيتين بينما يتم إطفاء العقوبة المحكوم عليه بها في قضية بحنين بفعل إضافة تخفيض العقوبات. ورغم أن استمرار مدة التوقيف الاحتياطيّ 9 سنوات هو أمر يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة، فإنه من المستغرب أن تتمّ معالجة هذه الوضعية من خلال قاعدة استثنائيّة تطبّق فقط على الذين ارتكبوا جرائم سابقة لنفاذ القانون من دون أن تطبّق على الذين قد يرتكبون جرائم مستقبلا. فكأنما يهدف الاقتراح إلى وضع حدّ لمظالم تعرض لها موقوفون حاليون من دون أن يعير أي اهتمام لضرورة عدم تكرار هذه المظلمة مع أي موقوف مستقبلًا. وهنا يشار إلى أن النائب بلال عبدالله تقدم باقتراح قانون في تاريخ 16/12/2024 هدف إلى تعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على نحو يجعل مدة التوقيف القصوى سبع سنوات. وهو اقتراح أكثر تناسبا لأنه يضع قاعدة عامة دائمة فضلا عن أنه ينص على مدّة أكثر تواؤما مع مبادئ المحاكمة العادلة.
- إدغام العقوبات: هذه الإضافة تستهدف بشكل خاص الأشخاص الذين ما يزالون موضع محاكمة في قضية أو أكثر وسبق لهم أن حكم عليهم في قضايا سابقة، سواء كانت محاكمتهم تجري وجاهيا أو غيابيا. وقوامها تكريس إلزامية إدغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بالنسبة إلى كل الملفات العالقة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ورغم أن هذا البند ذكر صراحة جرائم الإرهاب والمخدّرات كأمثلة على انطباقه، فإنه خلق التباسا عند تخصيص تطبيقه على الملفات العالقة أمام المحكمة العسكرية، علما أن الغالبية الكبرى لجرائم المخدرات تحاكم أمام المحاكم العدلية. ومن شأن هذه المادة أن تفيد عمليا بشكل خاص الأشخاص الذين ما يزالون موضع ملاحقة في جرائم مستثناة من قانون العفو، وأن تعالج في حال شطب حصرها في القضايا العالقة أمام المحكمة العسكرية أوضاع الأشخاص الذين بوشرت بحقّهم أكثر من ملاحقة في قضايا المخدّرات وكان تمّ استثناؤهم من العفو العام. ومؤدى هذه الإضافة هي ضمان أن لا يتعرض أي من الأشخاص الذين تتم ملاحقتهم على أساس جريمة ارتكبوها قبل نفاذ القانون، مهما بلغ عدد القضايا التي يلاحق بها ومهما بلغت خطورة الجرائم المرتكبة منه، لأي عقوبة تتجاوز 11 سنة وثلاثة أشهر فعلية. ويلحظ أن هذه المدة تتساوى تماما مع المدّة القصوى التي مكث خلالها سمير جعجع في السجن قبل انتزاعه العفو العام في إطار مقايضة مع العفو العام عن مجموعات أخرى من الإسلاميين كان تم توقيفهم في أحداث الضنية والبقاع. إذ كان جعجع تم توقيفه في تاريخ 21 نيسان 1994 وتم الإفراج عنه في تاريخ 26 تموز 2005 في أعقاب صدور قانون العفو العام في 19 تموز من السنة نفسها. وليس بإمكاننا الجزم فيما إذا كان انطباق المدة هنا مصادفة أم منطلقا من اتخاذ فترة توقيف جعجع كمعيار للمدة القصوى للعقوبة.
وثائق الاتصالات ومذكرات الإخضاع
أخيرًا، تضمن الاقتراح مادة بالغة الأهمية أسقطت فيها جميع وثائق الاتصال والاستقصاء والإخضاع والمعلومات المعممة والتي صدرت خلافا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وسائر القوانين المرعية الإجراء والصادرة من دون إشارة قضائيّة. وتشكل هذه المادة توثيقا للممارسات المعتمدة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لاتخاذ إجراءات أمنية بحق مئات الأشخاص بمعزل عن أي ملاحقة قضائية. والواقع أن هذه المادة تشكل تذكيرا بالقانون وتاليا إخبارًا للنيابات العامّة بشأن استغلال الأجهزة الأمنية نفوذها أكثر مما تشكل تعديلا لنص قانوني.
انتصار لنظام اللامحاسبة تحت غطاء "مفهوم العدالة الانتقالية"
انطلاقًا مما تقدّم، يظهر أن مُقدّمي الاقتراح قد فشلوا في تبرير منح العفو العام عن جرائم شديدة الخطورة مثل جرائم التعذيب والإرهاب وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي وتهريب الرساميل والإتجار بالبشر والعمالة والتعدّي على المشاعات وجرائم الحرب من دون أيّ مبرر. وفيما حاول مقدّمو الاقتراح تبرير العفو العامّ شبه الشامل باكتظاظ السجون وطول أمد التوقيف وما يرشح عنهما من مظلومية، فإنهم لم يبيّنوا إطلاقًا العلاقة بين هذه المظلومية ومنح العفو العامّ بصورة شبه شاملة لفئات لم تتعرّض يوما للمحاسبة أو المساءلة رغم خطورتها الاجتماعية أو هي في موقع فرار من العدالة. حتى بدا وكأنّ مظلومية فئة أو عدد من الموقوفين ومعاناة أهاليهم تحوّلت إلى مجرّد ذريعة تستغلّ لتعميم المظلومية ومعها العفو على حالات لا تمّت بصلة إليها. وقد بلغ هذا التوجّه مستوًى سرياليّا مع شمل منحة العفو العام جرائم لم ترتكب بعد، بما يشكل تشجيعا على ارتكاب جرائم، وكلّ ذلك تحت غطاء المظلوميّة التي تُعاني منها فئةٌ أو فئاتٌ من الموقوفين لآماد طويلة.
وما زاد من هجانة الاقتراح هو استحضار مفهوم العدالة الانتقاليّة بعد حصر مداه هو أيضا بمظلومية السجون والمحاكم بمعزل عن سائر المظلوميات والأهم بعد اختزاله بآلية العفو العام مع إسقاط مجمل الآليات الأخرى الملازمة له وأهمها تثبيت الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة والإصلاح الاجتماعي واتخاذ إجراءات لمنع التكرار.
إكرامية العفو العامّ خلسة ومن دون مبرّر؟
كما سبق بيانُه، يقبل الاقتراح الانتقاد لجهة منح العفو العام الكامل أو المخفّف مع ما يستتبع ذلك من تعليق أو تخفيف للمسؤوليات الجزائية، بخلاف مبدأيْ الشفافية والمساواة أمام القانون. فلئن كان المشرّع مخوّلا التدخل لمنح العفو العام، إلّا أنّه يلزم أن يبرّر تدخّله بصورة شفافة بالنظر إلى مفاعيل العفو العام على حقوق الضحايا والحقّ العامّ والأهم على صعيد مبدأ المساواة أمام القانون. كما يلزم أن يبقى هذا التدخل استثنائيّا كي لا تفقد القوانين الجزائية قوتها الردعية بفعل قوة احتمال الحصول لاحقا على عفو عام.
والواقع أن الاقتراح يجافي هذه القواعد من زوايا عدة.
وهذا ما يتحصّل بشكل واضح من اعتماد مبدئيّة العفو أي اعتبار الجرائم مشمولة بالعفو ما لم تكن مستثناة صراحة منه. ومؤدّى ذلك وفق ما بيناه أعلاه أن العفو يشمل ليس فقط الجرائم التي أعلن المشرع رغبته في منحها إياه، إنما أيضا الجرائم التي لم يشملها أيّ إعلان من هذا النوع أو ربما فقط لم يتنبّه إلى وجوب استثنائها من العفو العام. وفي الحالة الأولى، يكون الاقتراح محاولة خبيثة لفرض عفو غير مستحقّ أو بصورة مستترة خشية إثارة تحفظات لدى الرأي العام. وفي الحالة الثانية، نكون أمام خطأ تشريعي فادح قوامه إبراء ذمة أشخاص قد يكون ثبت تورطهم في جرائم خطيرة جدا من دون أي مبرّر حقيقي. ومن شأن التدقيق في الاستثناءات كلا على حدة كما فعلنا أعلاه أن يؤكد على خطورة هذا التوجه.
فمع التسليم بتعرّض الإسلامييّن للتعسّف وأحيانا للتعذيب في القضايا المحالة أمام المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية، لا نفهم لماذا تمّ منح جرائم التعذيب التي هي أصل مظلوميتهم، العفو العامّ. فإذا كان انتهاج التعذيب مبررا للعفو عن ضحايا التعذيب، فإنه لا يشكّل بأيّة حال مبرّرا لذاته. ولا يردّ على ذلك أن القانون يستثني الجرائم التي يتم فيها اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي، طالما أنه يفترض أن هذا الجرم خطير إلى درجة لا يصح ترك إمكانية ملاحقتها لقرار الضحية، التي ستكون معرضة لضغوط مضاعفة للتنازل عن حقّها، وهي ضغوط تمارس اليوم في أغلب الحالات تحت طائلة إجراءات قمعية وينتظر أن تتزايد في حال إقرار الاقتراح الحاضر.
ثم، وبنتيجة تعرّض المجتمع اللبناني لإحدى أكبر عمليات النهب في التاريخ، ما معنى تدخّل المشرع للإعفاء عن جرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتهريب الأموال و الإفلاس الاحتيالي أو عن سرقة المشاعات، وكلها جرائم تبقى بعيدة جدا عن الملاحقة وتكاد تخلو السجون من أي موقوف على خلفية ارتكابها؟ وهل يكون التدخّل هنا بمثابة تصحيح لمظلومية أم تأبيد للظلم وتكريس له؟
وأكثر فأكثر، لا نفهم أسباب منح العفو لجرائم الحرب التي شهدها لبنان خلال الأسابيع الماضية والإتجار بالبشر.
هذا فضلا عن أن العديد من مواده بدت مبنيّة في صياغتها على وضعيّات خاصة مثلما يظهر أعلاه بشأن تخفيض العقوبات أو وضع سقف للتوقيف الاحتياطي. بمعنى أنّه تمّ تطريز هذه المواد ليس انطلاقا من معايير مبرّرة حقوقيّا ومنطقيّا، إنما قبل كل شيء انطلاقا من إرادة ضمان استفادة بعض المحكومين أو المتهمين من أحكام القانون، سواء لإبراء ذمتهم بصورة تامة أو لضمان الإفراج الفوري عنهم.
أخيرا، يظهر الاقتراح منحى مخادعا قوامه منح العفو العامّ من دون البوح بذلك. وهذا ما نستشفّه من إعلان الاقتراح استثناء جرائم معنيّة معتبرًا إيّاها جرائم لا تغتفر ليسارع إلى تبرئة ذمم المحكومين بها بما أسميناه عفوا عاما موازيا. وهذا التوجه يظهر العفو العام ليس على أنه خيار اجتماعي بل على أنه نتيجة مهارة أو شطارة قوامها خداع الرأي العامّ حول حقيقة مضمونه.
انتصار منطق اللامحاسبة تحت غطاء العدالة الانتقالية
النقطة الثانية التي يجدر التوقّف عندها هي استحضار مفهوم العدالة الانتقالية في الأسباب الموجبة كما سبق بيانه. وما يستوقفنا هنا بشكل خاصّ أمور ثلاثة:
الأول، إنّها المرة الأولى التي يتم فيها استحضار هذا المفهوم في لبنان رغم تعرّض هذا البلد لحروب متعددة بدءا من الحرب الأهلية 1975-1990 وانقسامات عدة أخذت طابع التحارب، فضلا عن تعرّضه للعديد من جرائم النظام الشاملة كجريمة سلب ثروات اللبنانيين من خلال المصارف. وقد انتهت أغلب هذه الأحداث إلى إفلات تامّ من العقاب، من دون إيلاء إنصاف الضحايا وفي مقدمتهم ذوي المفقودين ولا حقهم بالمعرفة أي اهتمام؟ وعليه، ومن دون التقليل أبدًا من مظلومية فئاتٍ من السجناء، فكيف نشرح إذا أن تستحضر العدالة الانتقالية فقط لمعالجة معاناتهم وأهلهم من "ظلم الدّولة"، وكأنّهم الفئة الوحيدة التي تعاني من المظلوميّة فيما المجتمع اللبناني يكاد يتحوّل برمّته إلى شعبٍ من الضّحايا؟
أما الأمر الثاني الذي يجدر التوقّف عنده فهو تشويه مضمون هذا المفهوم وصولا إلى استخدامه بصورة مجتزأة تفقده أي معنى. فلئن يهدف مفهوم العدالة الانتقالية إلى اعتماد آليات مختلفة للمساءلة في ظروف معينة تفترض تغليب إنصاف الضحايا والمصارحة والمصالحة في مقاربة الجرائم المرتكبة والتعهد بعدم تكرار الجرائم على المنطق العقابي، فإن الاقتراح انتهى على غرار ما فعله المشرّع في أعقاب حرب 1975-1990 إلى تكريس مبدأ العفو العام من دون إيلاء أيّ اهتمام لضحايا الجرائم التي سقطت بالعفو الكامل أو العفو المخفّف ومن دون أي مساءلة أو مصارحة أو حتى مصالحة أو التزام. وما يشدُه هنا هو ذهاب واضعي الاقتراح إلى تحميل الدولة (أي كل الناس) وحدها مسؤولية الظلم، بما يتماهى مع الخطاب الذي حمّل ويحمّل "الدولة" (أي كل الناس) مسؤولية الخسائر المصرفية.
أما الأمر الثالث - وهو ربما الأخطر- أن مقدّمي الاقتراح لم يجدُوا حرجًا في تعميم منحة العفو العامّ على النحو الذي تقدّم من دون أيّ مبرّر، وذلك على أمل الحصول على تأييد الغالبية النيابية له. وبذلك، بدا هؤلاء على أتمّ الاستعداد لمقايضة العفو العام عن فئة الإسلاميين (وهم المعنيين عموما بمعاناة السجون وطول أمد التوقيف) بالعفو العام عن المصرفيين والعملاء ومافيات المخدرات.
وبذلك، وبخلاف لما ادّعاه الاقتراح، فإنّ مؤداه ليس تحقيق العدالة الانتقالية، بل على العكس من ذلك تكريس انتصار اللامحاسبة واللاعدالة على أي اعتبار آخر، وكل ذلك من دون التهيئة لأي تغيير أو انتقال إلى مستقبل أفضل.
معالجة المظلوميّة من دون منابعها
أخيرا، نشدد مجدّدا على خلو الاقتراح من أيّ رؤية إصلاحية للمستقبل. ففيما ترافق اقتراح قانون العفو العام مع سواد خطاب يركز على ضرورة معالجة أوضاع غير عادلة، منها رواج التدخّل السياسي في القضاء أو الإخلال في مبادئ المحاكمة العادلة أو وجود تشريعات ظالمة، فإن الاقتراح يخلو مثل الاقتراحات السابقة من أيّ توجه إصلاحي منعا من تكرار الظلم مستقبلا.
فلا نجد في الأسباب الموجبة أي التزام بالعمل لإصلاح المحكمة العسكرية أو القضاء الاستثنائي أو تعديل شروط التوقيف الاحتياطي بصورة دائمة أو حتى التزام بتنمية مناطق تعاني من نسب عالية من الفقر إلخ. كما لا نجد فيها أي التزام بمعالجة أسباب تعطيل القضاء وبخاصة في ظل التطبيق العبثي للمادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية أو تعطيل المجلس العدلي منذ قرابة السنة بفعل فقدان أحد أعضاء هيئته الحاكمة؟ جلّ ما ورد في الأسباب الموجبة، تمنيات أن يستفيد وزير العدل من تخفيف الاكتظاظ في السجون لإعادة تنظيمها (!!!).
وبذلك، وعلى فرض أن الاقتراح يؤدّي في حال إقراره إلى تصحيح أوضاع أشخاص يعانون من مظلومية معينة، فإنه يتعايش مع استمرار منابع الظلم على حالها من دون أيّ تعديل. ومن هذه الزاوية، يصعب في الواقع فهم دوافع معدّي الاقتراح الذين لئن راعتْهم المظلوميّة التي تعرض لها مواطنون في الماضي يبقون غير مبالين إزاء احتمال تعرض مواطنين آخرين للمظلومية نفسها في المستقبل. فهل تنبع مبادرتهم من هوية الأشخاص المراد منحهم العفو العام أو انتماءاتهم بمعزل عن أيّ اعتبار يتصل بالعدالة أو المصلحة العامة؟ أم أنّ توجههم يعكس مقاربة لحكم القانون على أنه حكم هشّ يمكن التدخّل لإسقاط مفاعيله كلما لزم الأمر تصحيحًا للأوضاع الظالمة التي قد تكون نشأت عنه؟ ومن هذه الزاوية، يكون قانون العفو العام في حال إقراره مجرد مقدّمة لاقتراحات عفو عامّ مستقبلية دائما بمعزل عن أيّ إصلاح تشريعيّ أو مؤسساتيّ. وهذه المقاربة تشكّل بحدّ ذاتها منسفا للضوابط القانونية ومعها الحقوق والأمان الاجتماعي وارتهانًا لحكم القوة، بما يرفد منابع الظلم بقوة مضاعفة.
وما يزيد من قابلية الاقتراح للانتقاد هو أنه انتهى في بعض ما تضمنه ليس فقط إلى تجاهل منابع المظلومية، بل أيضا إلى تكريسها وترسيخها وتعزيزها. وليس أدلّ على ذلك من منح العفو العامّ لجرائم التعذيب، أو تكريس أهميّة المجلس العدليّ (وكلاهما قضاء استثنائي) من خلال استثناء جميع الجرائم المحالة إليه من العفو العام.
اقتراح قانون يغلب فيه منطق القوة على منطق الحقوق
كخلاصة، جاز القول أن اقتراح العفو العام ينبني في صياغته وأهدافه على منطلقات عصبيّة. ويتأكد هذا الأمر من انتماءات النواب المبادرين وخلفياتهم والأهم من انخراط هيئة العلماء المسلمين ودار الإفتاء فيه وسط خطابٍ لا يخلو من التشنّج الطائفي. كما يتأكد من مضمون الاقتراح: فعدا عن أن معدّيه عمدوا إلى تطريز عدد من مواده على قياس أشخاص بعينهم، فإنهم لم يكلّفوا أنفسهم عناء تبريرها بمقتضيات العدالة أو المصلحة العامة. ومؤدّى ذلك هو تحويل "العفو العام" إلى ساحة للمكابشة والمساومات الطائفية والسياسية وربما لإعلان ارتقاء قوى جديدة في موازين القوى، مع ما قد ينتج عنه من فيتوات متبادلة أو محاصصة، وهنا ايضا على نحو يحجب أبعادها الحقوقية الأكيدة المشار إليها أعلاه. فلئن شكّل التحرّر من سلطان القضاء والقانون دليلا على امتلاك القوة، فإنّ الحصول على العفو العامّ يشكل بالطريقة التي يحصل فيها دليلا على اكتسابها، وكل ذلك على حساب دولة الحق والقانون.