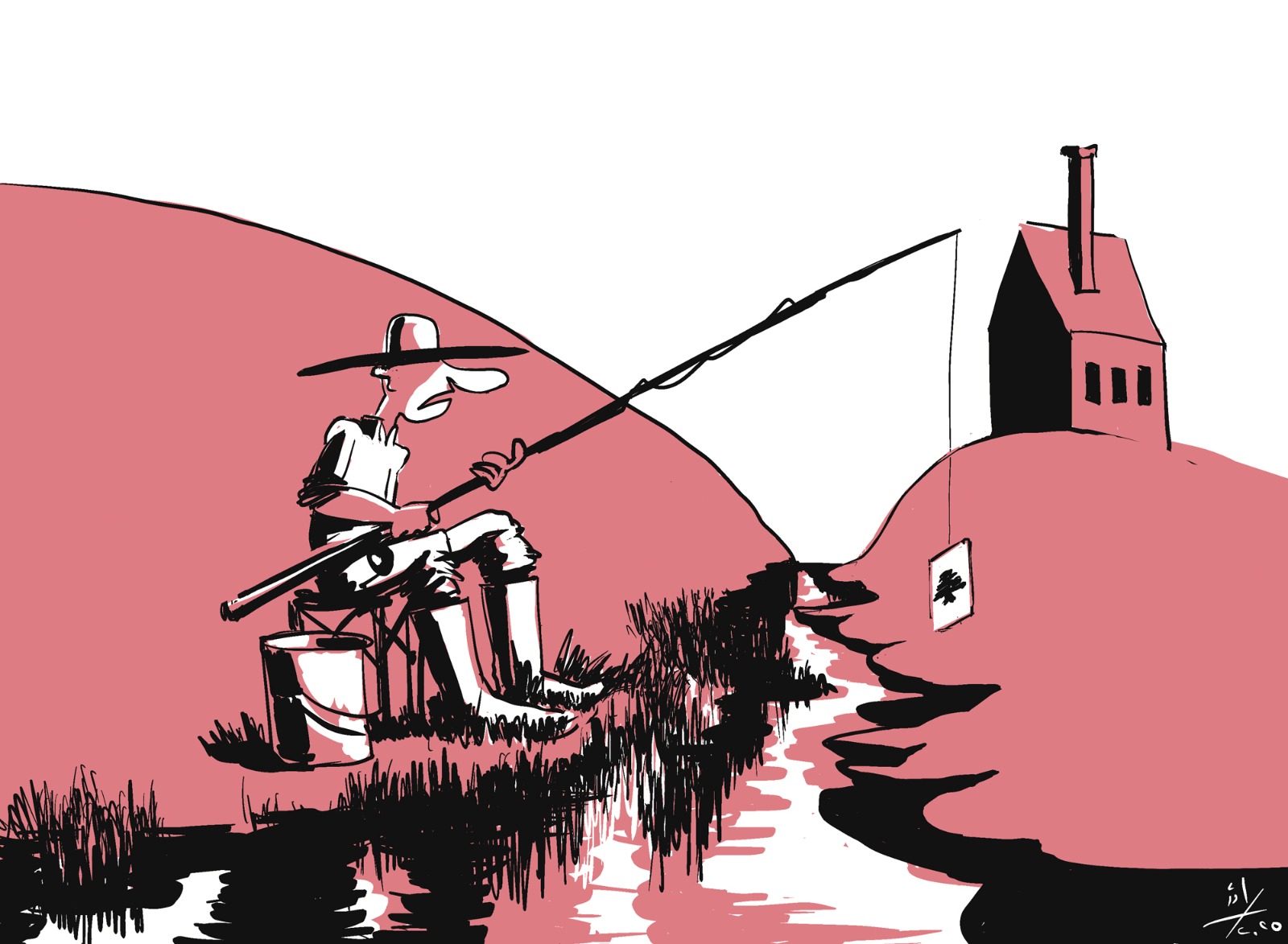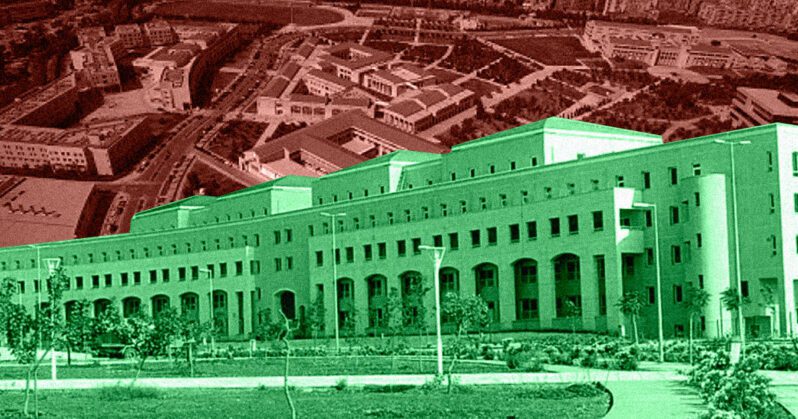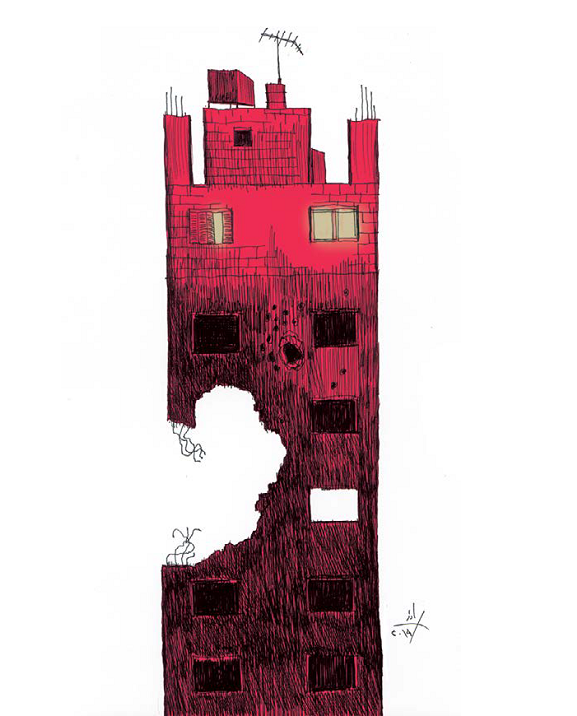المجلس الدستوريّ يبطل تمديد السيطرة على رأس الهرم القضائي: درسٌ للبرلمان في أصول التشريع
07/01/2025
أصدر المجلس الدستوري اليوم بالإجماع قرارًا بإبطال القانون 327/2024، وهو القانون الذي كان أعاد إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية مدّتها فضلًا عن تمديده سنّ تقاعد القاضييْن علي إبراهيم وجمال الحجّار وذلك على أساس قواعد تمييزية. وكانت المفكرة القانونية أعدّت بالشراكة مع نادي قضاة لبنان طعنًا على دستورية هذا القانون، هدف وفق ما أعلنتْ عنه إلى “تصويب الأداء البرلماني وتعزيز المؤسسات التشريعية والقضائية على حدّ سواء، كحجر أساسي في بناء الدولة التي نحن أحوج ما نكون إليها بعد سنوات أزمات وتدمير”. وقد قدّم الطعن النواب حليمة القعقور، ووقّعه عشرة نواب آخرين هم على التوالي نبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد.
كما يلحظ أن 3 مجموعات عادتْ لتقدّم طعونًا لاحقة وهي مجموعة من النواب التغييريّين أبرزهم بولا يعقوبيان وملحم خلف وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان وياسين ياسين ونجاة عون صليبا بالإضافة إلى كلًا من كتلتيْ القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ.
ولئن يتبدّى لدى مراجعة قرار الدستوري، أنّ مجمل المطالب الواردة في الطعن تمّ قبولها، يلحظ إنّه قد تضمن أحكاما بالغة الأهمية على صعيد أصول التشريع كما على صعيد مبادئ استقلالية القضاء وفصل السلطات وفق ما نبينه أدناه.
وقبل المضي في ذلك، من المهم التشديد على تحوّل كبير في منهجية عمل المجلس الدستوري يؤمل منها أن تؤدّي إلى تطوير رقابته على العمل التشريعي برمّته قوامها الاستماع على التسجيلات الصوتية لمناقشات مجلس النواب من دون الاكتفاء بالمحضر الخطي الذي تضعه إدارة هذا المجلس.
كيف طوّر المجلس رقابته على أصول التشريع؟
في هذا الصدد، ارتكز الطعن في أول أسبابه إلى المادة 36 من الدستور التي ورد فيها أنه “فيما يختص بالقوانين عموماً .. فإن الآراء تُعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ”. وعليه، وإذ ركّز الطعن على أن الدستور كرّس المناداة عند إقرار القوانين وذلك بصورة إلزامية من دون أي استثناء، فإنه ربط هذه القاعدة بضمان احترام مبدأ علنية جلسات مجلس النواب المكرس صراحة في المادة /35/ من الدستور، طالما أن عدم التمكن من معرفة تصويت كل نائب بمفرده سيؤدي إلى منع تكوين الأكثرية الدستورية المطلوبة لإقرار القوانين، كما إلى حرمان الناخبين من الاطلاع على مواقف ممثليهم ومراقبتهم من أجل محاسبتهم في الانتخابات النيابية المقبلة. وهذا ما أكد عليه المجلس الدستوري مضيفًا إن قاعدة التصويت من خلال المناداة “لا تقبل الاستثناء لورود تعبير دائما في النص الدستوري” ولكونها “تشكل شرطا ضروريا للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية” مما يؤدي إلى “اعتبار التصويت باطلا” في حال إهمال هذه القاعدة ومخالفتها.
إلا أنّه لحسم مدى صحة التصويت، وجد المجلس الدستوري أنه لا يكفي إثبات إلزامية المادة 36، بل يقتضي أيضا إثبات أن التصويت جرى خلافا لهذه القاعدة. وما أوجب عليه ذلك هو أن إدارة المجلس كانت أكدت في المحضر الخطي المنظم منها وحرفيا أن التصويت حصل بالمناداة. ولهذه الغاية، استجاب المجلس الدستوري لطلب الجهة الطاعنة بطلب الحصول على التسجيلات الصوتية لمناقشات الجلسة والاستماع إليها تمهيدا للتدقيق في صحة المحضر. ومن المهم بمكان هنا أن نسجّل مجدّدا أن استجابة المجلس الدستوري لهذا الطلب إنّما هي الأولى من نوعها (كان أهمل هذا الطلب مثلا عند النظر في دستورية موازنة 2022) وهي تؤدي فعليا إلى توسيع رقابته على العمل البرلماني وكيفية حصوله واقعيا بمعزل عن الصورة التي تريد إدارة المجلس نقلها عنه.
وليس أدلّ على أهمية الاستماع إلى التسجيلات الصوتية من قراءة المقاطع التي دونها المجلس نقلا عنها. فقد جاء فيها حرفيّا أن المناداة التي لجأ إليها رئيس المجلس بطلب من عدد من النواب إنما “اقتصرت على تلاوة أسماء نواب لا يتعدّى عددهم 12 من دون انتظار إبداء موافقتهم أو رفضهم”، قبلما يسمع “صوت رئيس المجلس يقول: صُدّق”. وهنا يتابع المجلس الدستوري أن اعتراضات عدة “تلت ذلك وقد سُمعت أصوات تسأل عن مصير القانون وتطالب بنتيجة التصويت بالمناداة كما طلب بعض النواب تدوين اعتراضهم في المحضر دون إضافة طلبهم. وقد تبين تدوين اعتراض النائب جميل السيد”.
وبذلك، يكون المجلس الدستوري وبفعل توسيع رقابته على هذا الوجه قد تمكّن للمرة الأولى منذ إنشائه من وضع الأصبع على الفوضى العارمة في إدارة الجلسات وما يستتبعُها من تحويرٍ ممنهج للإرادة العامّة للمجلس. وهو بذلك إنما يوسّع نطاق رقابته الدستورية وبخاصة لجهة ضمان احترام أصول التشريع مستقبلا تحت طائلة إبطال أي قانون يتم التصويت عليه بصورة ملتبسة (أو كما درجت العادة). وكنتيجة ملازمة للتثبت من عدم حصول التصويت أصولا، استخلص المجلس أنه لا يتبين من التسجيلات أن القانون نال أكثرية الأصوات، بما يوجب إبطاله لهذا السبب أيضا على أساس المادتين 18 و34 من الدستور، فضلا عن “المبادئ والقواعد التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي البرلماني لا سيما تلك المنصوص عليها في الفقرتين “ج” و”د” من مقدّمة الدستور ولمبدأ وضوح المناقشات البرلمانية في القيمة الدستورية النابع عن مبدأ السيادة الشعبية والذي يعتبر أحد تجليات مبدأ الديمقراطية السائد في لبنان”.
بالإضافة إلى ما تقدّم، استند المجلس الدستوري على التّسجيل الصوتيّ للمناقشات من أجل التثبّت من مخالفة أخرى يستشف عنها أيضا فوضى عارمة، وهي أن صيغة الاقتراح التي تمت مناقشتها تختلف عن الصيغة النهائية التي تمّ نشرها في الجريدة الرسمية. وهذا أيضا ما كان أثبته المرصد البرلماني بصورة واضحة وما كان أمكن إثباته رسميا لولا استجابة المجلس الدستوري لطلب الاستماع إلى التسجيلات الصوتيّة.
أخيرًا، أدلى المجلس الدستوريّ بسببٍ آخر لإبطال الفقرة الثالثة للقانون المتّصلة بتمديد سنّ التقاعد لبعض القضاة بعدما تثبت من كونها “تتسم بعدم الوضوح لجهة كيفية الاستفادة من تمديد سن التقاعد وعدد المرات التي يمكن الاستفادة فيها منه إذ أنها تقبل تفسيرين مختلفين”. وعليه، انتهى إلى إبطالها على خلفية تعارضها مع مبدأ فقه القانون ووضوحه، بعدما اعتبر أن هذا المبدأ يتفرع عن مبدأ المساواة المكرس في المادة 7 من الدستور والفقرة من مقدمته.
كيف عزّز القرار الدستوري مبادئ استقلالية القضاء؟
في هذا الصدد، قبل القرار الدستوري أسبابا عدة للطعن الذي أعدّته المفكرة القانونية بالتعاون مع نادي قضاة لبنان. ومن أهم هذه الأسباب، الآتية:
- تكريس مبدأ المساواة بين القضاة كأحد العناصر الأساسية لاستقلالية القضاء: لا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين
أول ما نلحظه هنا هو أن المجلس الدستوري لم يكتفِ بإبطال القانون لجهة إعادة تجديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى أو تمديد سن تقاعد بعض القضاة على أساس قواعد تمييزية على خلفية كونه مفصلا على قياس أشخاص محددين بل ذهب أبعد من ذلك في اتجاه دسترة مبدأ جديد وهو مبدأ المساواة بين القضاة المتواجدين في الوضعية نفسها. ومن شأن هذا المبدأ أن يشكل ضابطا ضدّ أي ممارسات تمييزية أو تفاضلية بين القضاة نظرا لتأثير هذه الممارسات مباشرة على مبدأ استقلالية القضاة. وبذلك، يكون المجلس الدستوري يكون كرس دورا فقهيا في إعلان المبادئ بعد دسترتها من دون الاكتفاء بتطبيقها.
وقد توصل المجلس إلى اعتبار القانون تمييزيا بين القضاة في كل من فقراته الثلاث على النحو الآتي:
أولا، حين اعتبر أن إعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء المنتهية مدتها لا ترسي قاعدة عامة تطبق للمستقبل تفاديا لأي شغور أو تعطيل قد يهدد استمرارية عمل القضاء, مما يجعلها بمثابة تشريع مفصل على قياس أشخاص بعينهم وهم الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم،
وثانيا، حين اعتبر جعل النائب العام التمييزي بالتكليف عضوا حكميا في مجلس القضاء الأعلى مجافيا لمبدأ المساواة، حيث أن القانون لم يرتب النتيجة نفسها على رئيس هيئة التفتيش بالتكليف، فيما أن كلا من النائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش بالأصالة عضوان حكميان في مجلس القضاء الأعلى،
الثالث، إنه اعتبر أن حصر تمديد سن التقاعد بالقضاة الذين يبلغون سن التقاعد في الفترة الممتدة من 15/3/2025 إلى 15/5/2026 والذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوماً يتخذ في مجلس الوزراء، يؤدّي عمليّا “إلى إفادة قضاة محدّدين وإقصاء آخرين … علما أن هذا التمييز بين القضاة لا يستند إلى أي مبرر تقتضيه المصلحة العامة أو استمرارية المرفق القضائي لا سيما وأنه يمكن تفادي الفراغ عند تقاعد أي من القضاة المعينين بالقانون المطعون فيه بحلول القاضي الأعلى درجة في المحكمة أو النيابة العامة محله في إشغال المركز الشاغر إلى حين تعيين بديل عنه”.
- التأكيد على أهمية ضمان استقلالية أعضاء مجلس القضاء الأعلى:
فضلًا عما تقدّم، عدّ القرار الدستوري القانون المطعون فيه مخالفا لمبادئ استقلالية القضاء على خلفيّة تعرّضه لضمانات استقلالية أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
ومن أبرز ما يجدر التوقف عنده في هذا الخصوص هو أنه أعاب على القانون التدخل في تجديد تعيين قاضٍ يفترض أن يكون منتخبا من بين أقرانه، مذكرا أن “انتخاب أعضاء المجلس من أقرانهم يعتبر بحسب المعايير الدولية إحدى ضمانات استقلالية القضاء الأعلى وهو أحد أوجه الإصلاح القضائي الذي لحظته وثيقة الوفاق الوطني عام 1989″. وهو بذلك أعطى لمبدأ انتخاب القضاة من بين أقرانهم قوة دستورية ستسهم حكما في تدعيم التوجه التشريعي إلى رفع عدد القضاة المنتخبين من بين أقرانهم في مجالس القضاء المختلفة، وهو التوجه الغالب في اقتراحات قوانين استقلالية القضاء العدلي أو الإداري. وقد دعّم المجلس هذا الاتجاه في تأكيده أن كيفية تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى لا تتم من قبل مجلس الوزراء على أساس المادة 65 من الدستور وفق القواعد المحددة في تعيينات الموظفين العامين إنما وفق أصول مختلفة عملا بمعايير استقلالية القضاء على أساس المادة 20 من الدستور. ومن شأن هذه الحيثية أن تدعّم أكثر فأكثر التوجه إلى زيادة عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس القضاء الأعلى بعدما استبعد مجلس القضاء الأعلى أي عوائق دستورية أمام ذلك.
من جهة أخرى، أعاب القرار الدستوري على القانون المطعون فيه أنه جعل النائب العام التمييزي بالتكليف عضوا حكميا في مجلس القضاء الأعلى ونائبا لرئيسه، على نحو يخالف مبدأ ثبات تشكيل مجلس القضاء الأعلى واستقلالية أعضائه ووجوب تحصين هؤلاء إزاء المؤثرات والضغوطات حفظا لهذه الاستقلالية. وقد توصل المجلس الدستوري إلى هذه النتيجة بعدما ذكر أنه بإمكان رئيس محكمة التمييز (الذي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى) أن يزيل عنه هذا التكليف بقرار أحادي وأن يتحكم تاليا بتشكيل المجلس من دون أية ضوابط أو قيود.
- في كون استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بشأن المسائل المتصلة بالقضاء العدلي معاملة جوهرية ذات قوة دستورية
هنا وبعدما تثبّت المجلس الدستوريّ من عدم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى بشأن القانون المطعون فيه، اعتبر أن واجب استطلاع الرأي هو بالواقع تكريسٌ للضمانة القضائيّة المكتوبة في المادة 20 من الدستور وأيضا لمبدأ الفصل بين السلطات. وهو بذلك أكد على قراره السابق رقم 23/2019 الصادر في تاريخ 12/9/2019.
خلاصة
بالنتيجة، أمكن القول أنّ قرار المجلس الدستوريّ يكتسي أهميّة مُضاعفة: فعدا عن أهميته المباشرة في إبطال قانون كان يهدف إلى تمديد السيطرة السياسية على رأس الهرم القضائي، فإنه يشرّع بابًا واسعًا لتوسيع رقابة المجلس الدستوري على العمل التشريعي من خلال تفعيل آلية الاستماع إلى التسجيلات الصوتية للمناقشات النيابية من دون الاكتفاء بالمحاضر الخطية التي تعدها إدارة المجلس. كما إنه علاوة على ذلك، يرشح عن دسترة عددٍ من ضمانات استقلالية القضاء، أهمها مبدأ المساواة بين القضاة ومبدأ انتخاب أعضاء مجالس القضاء من قبل أقرانهم، وكلها ضمانات يؤمل أن تسهم في حسم وتسريع النقاشات بشأن اقتراحات قوانين استقلالية القضاء العدلي والإداري… وقريبًا المالي.